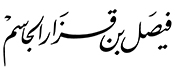الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد
فإن دين الله تعالى الذي يقوم على أمرين اثنين: أن يُعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وأن يُعبد بما شرع لا بالأهواء والبدع. قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ)، وقال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» متفق عليه، وقال أيضاً: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» متفق عليه.
قال ابن القيم رحمه الله: (فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل، وتوحيد متابعة الرسول) ا.هـ [مدارج السالكين 2/387]
وكل من هذين التوحيدين مبني على ركنين: إثباتٌ ونفيٌ.
فتوحيد العبادة مبني على نفي الألوهية عما سوى الله تعالى وإثباتها لله وحده، وهذا هو معنى «لا إله إلا الله»، فـ «لا إله» نفي للألوهية عما سوى الله، وهو ما سماه الله تعالى: الكفر بالطاغوت كما في قوله تعالى (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا)، وفي قوله (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ). والطاغوت يشمل كلَّ ما عُبد من دون الله تعالى وهو راضٍ، وكلَّ عبادةٍ لغير الله. والكفر بالطاغوت يعني: البراءة من الشرك، واعتقاد بطلانه، والبراءة من أهله وبغضهم وإظهار عداوتهم. قال الله تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه السلام قيامه بهذا الأمر وآمراً بالاقتداء والتأسي به في ذلك: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ). فذكر الله تعالى براءة إبراهيم عليه السلام من أمرين: الأول: العابد لغير الله في قوله (إِنَّا بُرءَاء مِنكُمْ)، وهم المشركون. الثاني: المعبودين في قوله (وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ) والبراءة من المعبودين تشمل البراءة من عبادتهم والبراءة منهم إن كانوا راضين بذلك. كما بيَّن تعالى أن هذا الكفر يستلزم العداوة الظاهرة المعلنة فقال: (وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء).وقول «إلا الله»، إثبات الألوهية لله وحده.
فلا يتم توحيد عبد إلا بتحقيق هذين الأمرين، فمن لم يكفر بالطاغوت ويعتقد بطلان الشرك ولو وحّد الله فليس بمسلم.
ويدخل في الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك: عداوة أهله وبغضهم.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: (إن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام، ولو وحّد الله وترك الشرك، إلا بعداوة المشركين، والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى: (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) ا.هـ [الدرر السنية 8/113]
وتوحيد الاتباع كذلك مبني على ركنين: الأول: مجانبة البدع والبراءة منها ومن أهلها ومجانبتهم وبغضهم بقدر بدعتهم، والثاني: اتباع السنّة والتزامها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
والتحذير من المحدثات يستلزم اجتنابها واجتناب أهلها.
وقالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية (هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ)) إلى قوله (أُوْلُواْ الألْبَابِ)، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» متفق عليه.
فمن اتبع السنّة وعمل بها، إلا أنه لم يتبرأ من البدعة ومن أهلها ولم يبغضهم فليس من أهل السنّة. كمن يختار السلفية مذهباً وينتسب إليها ويزعم أنه على مذهب أهل السنّة ويراه المذهب الصواب، لكنه لا يجد غضاضة من اتباع غيره لمذاهب المتكلمين وأهل البدع من الأشاعرة والمرجئة وغيرهم، بل قد يراه أمراً واسعاً، أو أن الاختلاف فيه كالاختلاف في المسائل الفقهية. فهذا في حقيقة أمره ليس من أهل السنّة بل من أهل البدعة، لأن السنّة تستلزم بغض ما خالفها ومجانبته واعتقاد بطلانه.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله» رواه الطبراني وغيره.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (أحِبَّ في الله، وأبغِض في الله، ووالِ في الله، وعادِ في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي عن أهله). ثم قرأ ابن عباس هاتين الآيتين: (لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)، وقرأ (الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ). [الإيمان لأبي عمر العدني ص128].
ولذلك اشتد نكير أهل السنّة والجماعة على أهل البدع تحقيقاً لهذا الركن، فحذَّروا منهم ومن بدعهم، واشتدت عليهم كلمتهم، حتى صار ذلك أصلاً عظيماً من أصول السنّة، حتى لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب السنّة، فضلاً عما أفرد فيه خاصة، ككتاب «البدع» لابن وضاح، و«ذم الكلام وأهله» لأبي إسماعيل الأنصاري وغيرهما كثير.
والردّ على أهل البدع والإنكار عليهم والتحذير منهم من أعظم ما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: (إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وأهله وليّا من أوليائه يذبّ عنها، وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن، وتوكلوا على الله). [البدع لابن وضاح ص5].
وعن عاصم الأحول قال: قال قتادة: (يا أحول: إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تُذكر حى تُحذر). [اللالكائي 1/137].
والإنكار على البدعة يستلزم التحذير من أصحابها ومن دعاتها، وهو داخل في البراءة منها وفي الأمر بمجانبتها، كما في الحديث «فاحذروهم».
قال الحسن: (ليس لصاحب البدعة غيبة). [اللالكائي 1/140].
وقال الأوزاعي: (كان بعض أهل العلم يقول لا يقبل الله من ذي بدعة صلاةً ولا صياماً ولا صدقةً ولا جهاداً ولا حجاً ولا عمرةً ولا صرفاً ولا عدلاً؛ وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم، وتشمئز منهم قلوبهم ويحذِّرون الناس بدعتهم.
قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم ستراً، ولا يُظهر منهم عورةً، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها،فأما إذا جهروا بها، وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها، فنشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مُصرٍّ مُلحد). [البدع لابن وضاح ص7].
وكتب أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات رسالة عظيمة يقول فيها: (اعلم أي أخي: إنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السُنَّة، وعيبِك لأهل البدعة، وكثرة ذكرك لهم، وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشدَّ بك ظهر أهل السُنة، وقوّاك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بذلك، وصاروا ببدعتهم مستترين، فأبشِرْ أي أخي بثواب ذلك، واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وأحياء سُنّة رسوله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أحيا شيئاً من سنّتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين إصبعيه» وقال: «أيما داعٍ دعا إلى هذا، فاتُّبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة». فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله.
وذكر أيضاً أن لله عند كل بدعه كيد بها الإسلام ولياً لله يذبُّ عنها، وينطق بعلاماتها، فاغتنم يا أخي هذا الفضل، وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال: «لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من كذا وكذا». وأعظِم القول فيه، فاغتنم ذلك، ادعُ إلى السُنّة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر ..) [البدع لابن وضاح ص8].
وأهل البدع منهم الداعي إلى بدعته المظهر لها، ومنهم المستسر، فأما المستسر فلا تعرّض له، لعدم إظهاره لبدعته، والأصل معاملة الناس بحسب ما يُظهرون، فكلام العلماء في وجوب التحذير والتشهير بأهل البدع محمول على من أظهر بدعته ودعا إليها.
وقد ذكرنا عن الأوزاعي آنفاً قوله: (ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم ستراً، ولا يُظهر منهم عورةً، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها).
والأصل في المبتدع الهجر، وذلك بترك مجالسته والسلام عليه ونحو ذلك، والهجر هجران: هجر عقوبة ٍله، وهجرٌ هو من باب هجر السيئات، وقد يُترك هذا الأصل إذا لم يترتب عليه المقصود منه بردع هؤلاء عن بدعتهم، ويبقى مشروعاً من باب مجانبة السيئات، فإن أمنت السيئات بعدم إظهار المبتدع وذكره لشبهاته وتحقق بمخالطته مصلحة من دون مفسدة فحينئذ قد تتوجه مخالطته، وهذا أمر يُقدّر بقدره بحسب البدعة والمبتدع وبحسب الحال والمقام، ويبقى الأصل بهجره محفوظاً.
وأما هجر البدعة والبراءة منها والتحذير منها فهو واجب على كل حال ما لم يخش الإنسان ضرراً، فلا بد من التفريق بين هجر البدعة وبين هجر المبتدع.
وقد تلبّس بعض أفاضل أهل العلم من السابقين ببعض البدع الاعتقادية أو الفعلية، ومع ذلك احتملهم الأئمة والعلماء مع بيان خطأهم والتحذير منه، من غير أن يُحذّروا منهم أو يُشهِّروا بهم، بل قد أوصوا بالاستفادة منهم وقراءة كتبهم مع التنبيه على أخطائهم والتحذير من زلاتهم. ومن أمثال هؤلاء: أبو سليمان الخطابي وابن حبان والبيهقي والنووي والحافظ ابن حجر العسقلاني والقرطبي وغيرهم من أهل العلم.
وهذا الأمر قد أشكل على بعض الناس حتى توقف عن التحذير من أهل البدع المعاصرين والتشهير بهم لما لهم من جوانب أخرى حسنة، وأراد هؤلاء أن يحملوا كلام أهل العلم فيمن ذكرنا من العلماء على أمثال هؤلاء المعاصرين ممن لا يُعرفون بالسنّة وتعظيمها واتباعها، بل من قد عُرفوا بتركها والتماس التأويلات لها فضلاً عما تلبسوا به من بدعة الأشعرية والإرجاء وغير ذلك من الاعتقادات الباطلة، وإن كانت لهم جهود أخرى في خدمة الإسلام.
ولا ريب أن الدعوة إلى معاملة هؤلاء المعاصرين معاملة أولئك العلماء الأفذاذ تؤول في حقيقة أمرها إلى التهوين من السنّة والترويج للبدعة والمساهمة في نشرها وإحيائها، شاء أصحابها أم أبوا.
والذي يظهر أن سبب هذا الخلل هو عدم فطنة أصحاب هذا الفهم إلى الفروق الكبيرة والكثيرة بين أولئك العلماء المتلبسين ببعض البدع وبين هؤلاء المعاصرين، وأنا أذكر بعضها على عجالة:
أولاً: أن السابقين من العلماء قد توفاهم الله وأفضوا إلى ربهم، فانقطع بذلك كلامهم وانقطعت دعوتهم، وعُرف ما لهم وما عليهم فلا يُزاد فيه ولا يُنقص، بخلاف المعاصرين فإنهم لا يزالون أحياء يدعون إلى ما هم عليه من البدعة، وليس لبدعهم حد تنتهي إليه طالما أنهم لا يزالون أحياء، فالسكوت عنهم مع وجودهم ودعوتهم، وترك التحذير منهم، وعدم اجتنابهم يساهم في نشرها، بينما الأولون يمكن إحصاء ما عليهم وبيانه وتوضيحه فلا يُخشى منهم ما يُخشى من الدعاة الأحياء.
ثانياً: أن السابقين لهم من الفضائل والخير الكثير ما تنغمس بدعهم في بحر فضائلهم وسابقتهم في العلم، هذا مع وجوب التنبيه عليها، فانظر مثلاً إلى الخطابي وابن حبان والبيهقي والنووي وابن حجر والقرطبي، كم نفع الله بكتبهم ومؤلفاتهم وعلومهم بما لا غنى لطالب العلم عنها، فإن كتبهم ومؤلفاتهم تُعدّ من المراجع المهمة في العلم، ومن الموسوعات العظيمة في فنونه ومسائله. فأين مبتدعة المعاصرين من هؤلاء؟
هؤلاء المبتدعة المعاصرون الذين يُراد السكوت عنهم لم يبلغوا في العلم وفنونه وفي خدمة السنّة والذبّ عنها عشر معشار الأولين. فأين الثرى من الثريا؟، شتان بين الفريقين.
فالدعوة إلى معاملة بعض مبتدعة المعاصرين معاملة الخطابي أو الحافظ ابن حجر أو النووي أو غيرهم وليس لهم من السابقة والتقدم في العلم وخدمته ما لأولئك أمرٌ لا يقضى منه العجب!
فالأولون إنما احتملهم العلماء لكثرة خيرهم ونفعهم، وعظم علومهم.
ومن المعلوم أن إنزال الناس منازلهم أمر مطلوب شرعاً، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم». ولا ريب أن الدعوة إلى ترك الاستفادة من علوم أولئك السابقين وكتبهم بالتحذير منها ونبذها يُفوّت خيراً عظيماً وعلماً كثيراً وفنوناً متنوعة يعجز عنها أكثر المتأخرين.
أما هؤلاء المعاصرون فإن مجانبتهم وترك الأخذ عنهم لا يترتب عليه ضرر ولا يفوت به علمٌ كثير، بل هو نافع لما فيه من اجتناب زللهم، بينما السكوت عنهم والدعوة إلى الاستفادة منهم يضر ولا ينفع. وما يُنسب لهم من العلم إن وُجد فقد حصل الاستغناء عنه بغيرهم من علماء أهل السنّة والجماعة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما ذكر بعض أعيان المتقدمين من الأشاعرة كالبيهقي وأبي ذر الهروي وأبي بكر بن العربي وأبي الوليد الباجي: (ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساعٍ مشكورة، وحسنات مبرورة، وله في الردّ على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنّة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك: منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمّهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل، وخيار الأمور أوساطها.
وهذا ليس مخصوصاً بهؤلاء، بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين، والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات، ويتجاوز لهم عن السيئات، (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ).
ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه تحقيقاً للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا).
إلى أن قال: فقلَّ من يَسلَمُ من مثل ذلك من المتأخرين لكثرة الاشتباه والاضطراب وبُعدِ الناس عن نور النبوة وشمس الرسالة الذي به يحصل الهدى والصواب، ويزول به عن القلوب الشك والاتياب). [درء التعارض 2/102].
ثالثاً: أن من سبق ذكرهم من السابقين كالخطابي والبيهقي وابن حجر والنووي وغيرهم، فإن جادتهم العامة اتباع السنّة وتعظيمها، وهذا ظاهر في تقريراتهم وأحكامهم واختياراتهم، إلا أنه قد التبست عليهم بعض الأمور ظنوها حقاً، ومنهم من لا يجزم بشيء في مسائل الأسماء والصفات ونحو ذلك كالنووي، ومنهم من يوافق أهل السنّة في كثير من أصولهم ويخالف في بعض.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيّناً أحوال بعض نفاة الصفات والمتأولة: (هؤلاء أنواع:
نوع ليس لهم خبرة بالعقليات، بل هم يأخذون ما قاله النفاة عن الحكم والدليل ويعتقدونها براهين قطعية، وليس لهم قوة على الاستقلال بها، بل هم في الحقيقة مقلدون فيها، وقد اعتقد أقوال أولئك، فجميع ما يسمعونه من القرآن والحديث وأقوال السلف لا يحملونه على ما يخالف ذلك؛ بل إما أن يظنوه موافقاً لهم، وإما أن يُعرضوا عنه مفوّضين لمعناه.
وهذه حال مثل أبي حاتم البستي –أي ابن حبان- وأبي سعد السمان المعتزلي، ومثل أبي ذر الهروي وأبي بكر البيهقي والقاضي عياض وأبي الفرج ابن الجوزي وأبي الحسن علي بن المفضل المقدسي وأمثالهم.
والثاني: من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيها كما غلط غيره، فيشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة، مع أنه لا يكون له من الخبرة بكلام السلف والأئمة في هذا الباب ما كان لأئمة السنّة، وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما.
وهذه حال أبي محمد بن حزم وأبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي وأمثالهم .
ومن هذا النوع بشر المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي وأمثالهما.
ونوع ثالث: سمعوا الأحاديث والآثار، وعظموا مذهب السلف، وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية، ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنّة والحديث، لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها، ولا من جهة الفهم لمعانيها، وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية، ورأوا ما بينهما من التعارض.
وهذا حال أبي بكر بن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأمثالهم). [درء التعارض 7/32].
وهل يشك أحد يقرأ للخطابي مثلاً أو للبيهقي أو النووي أو ابن حجر أو ابن حزم في أنهم معظّمون للسنّة عموماً مقدّمون لها مؤثرون لها على غيرها، لا يمتري منصف في ذلك، ولذلك لم يُنقم على هؤلاء شيء من التعصب المذهبي، ما خلا أحرفاً يسيرة، وأما المعاصرون فأكثرهم ليس لهم من اتباع السنّة ما للسابقين، بل لهم من التأويلات وليّ الأدلة وتحريفها بحجة التيسير والبحث عن السهل أمر كثير. ولذلك قلما ترى في كلامهم تقرير الأدلة والتجرد للحق، بل ترى في كلام كثير منهم التناقض في الأقوال، والتباين في المواقف، ذلك لكونهم لا يسيرون على جادة سوية وهي تعظيم السنّة وتقديمها وإيثارها على آراء الرجال. فكيف يستوي هؤلاء المعاصرون بأولئك السابقين.
رابعاً: أن الجهل بمذاهب السلف والبعد عن نور النبوة ومشكاة الرسالة في مسائل الأسماء والصفات ونحوها انتشر وعمّ في القرون المتأخرة بدءاً من أواخر القرن الخامس وامتداداً إلى القرن الثاني عشر، حتى صار من يدعو إلى السنّة ويعرف مذاهب السلف غريباً، ولا يخفى على طالب العلم ومن له أدنى اطلاع في التاريخ ما عانى منه أئمة السنّة وأعلامها كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن أتى بعدهم.
وقد ذكر المقريزي أسباب انتشار المذهب الأشعري في القرون المتأخرة فذكر أنه بدأ من نحو سنة ثمانين وثلاثمائة، وعزا أسبابه إلى تبني الناصر صلاح الدين الأيوبي له ونشره في البلدان وتزامن ذلك مع دعوة ابن تومرت في المغرب وقيام دولة المرابطين الذين حكموا المغرب الإسلامي والأندلس، ثم قال: (فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعريّ وانتشاره في أمصار الإسلام، بحيث نُسي غيره من المذاهب، وجُهل حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه، إلاّ أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل رضي اللّه عنه، فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف، لا يرون تأويل ما ورد من الصفات، إلى أن كان بعد السبعمائة من سني الهجرة، اشتهر بدمشق وأعمالها تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحكم بن عبد السلام بن تيمية الحرّانيّ، فتصدّى للانتصار لمذهب السلف وبالغ في الردّ على مذهب الأشاعرة، وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة، وعلى الصوفية ..). [خطط المقريزي 4/192].
فلا غرابة أن يوافق كثير من العلماء الذين عاشوا في هذه الحقبة والقرون المتأخرة ما وجدوا عليه مشائخهم وعلماءهم، لا سيما إذا علمنا بأن كثيراً منهم لم يطّلع على مذاهب السلف ولم يفطن له، بل منهم من لم تطرق سمعه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية.
وهذه الغربة العظيمة قد أزاح الله كثيراً منها بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فكشف الله بحمد الله بدعوته غمة عظيمة عن أكثر المسلمين، وانتشر بدعوته كثير من الحق الغائب في عامة البلدان، ولا يكاد يوجد أحد ينتسب إلى علم في بلد من البلاد العربية أو الأعجمية إلا وقد بلغته دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة، وكتبه ومؤلفاته قد انتشرت، ودعاته المتأثرين بدعوته قد كثروا حتى لا يكاد يخلو منهم بلد من البلاد، قلوا أو أو كثروا، إذ العبرة هو انتشار الحق وذيوعه وإن قلّ متبعوه. وذلك لأن دعوته تزامنت مع قيام دولة عظيمة من دول التوحيد والسنّة.
فإذا كان الأمر كذلك فالجهل بمذاهب السلف وأصول السنّة في هذه الأعصار ليس كالجهل به في العصور السابقة، فالمبتدعة المعاصرون اليوم لم يَخْفَ عليهم الحق كما خفي على كثير من السابقين في عصور انتشار مذاهب المتكلمين في عامة البلاد الإسلامية، بل هؤلاء المعاصرون من المبتدعة قد سمعوا جزماً بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وسمعوا بكلام أتباعه من السلفيين الذين يلقبونهم زوراً بالوهابيين، أضف إلى ذلك تنوع وسائل الإعلام الذي تعددت بسببه أسباب انتشار العلم وبلوغ الحجة بما لم يكن قبل ذلك.
وعليه، فكيف يمكن أن يُعامل من بلغته الحجة بانتشار الدعوة وذيوعها فلم ينقد لها، أو تمكَّن من معرفة الحق فأعرض عنه، هذا مع ضعف تبحره في العلم، وقلة خدمته للإسلام والسنّة تصنيفاً وتعليماً ونصرةً وذباًّ، كيف يُعامل من هذا حاله معاملة من لم يبلغه العلم بشكل واضح بيّن من أفذاذ العلماء بسبب قلة دعاة الحق وغربة أهله، مع عِظم تبحره في العلم وخدمته للإسلام والسنّة تصنيفاً وتعليماً وإن أخطأ في مواضع.
لا شك أن التسوية بين هاتين الطائفتين أمر مجانب للصواب.
هذا ما أردت ذكره على سبيل الإيجاز، وإلا فإن الموضوع يحتاج إلى بسط أكثر لا تحتمله مقالة الأصل فيها الاختصار والإيجاز. فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان.
والله أعلم وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.