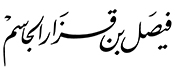لتحميل على ملف pdf يرجى الضغط على الرابط أدناه
منهج أهل السنَّة والجماعة في الرد على المخالفين وصيانته من التشويه والتحريف.(تفريغ)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
فمن المعلوم أنَّ الصراع بين الحق والباطل باقٍ ما بقي الليل والنهار، وأنَّ من سنَّة الله تعالى في عباده أن يبتلي مؤمنَهم بكافرهم، ومطيعَهم بعاصيهم، وسنِّيَهم بمبتدعِهم.
قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ}.
وبقدر الاتباع يكون الابتلاء بالخصوم والأعداء، وفي الحديث: «أشدُّ الناس بلاءً الأنبياءُ ثم الأمثلُ فالأمثل».
ومن هنا كان جهادُ الباطل ومقاومتُه وصدُّه وإبطالُه، بالحجة والبيان، وبالسيف والسنان، من أخصِّ وظائف الرسل، وبقدر نصيب العبد منه تكون متابعتُه للرسل وإمامتُه.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ}.
وكما أنَّ الله تعالى يبتلي المؤمنين بالكافرين، فكذلك يبتلي المؤمنين بالمؤمنين، فيبتلي المتَّبع بالمبتدع، بل يبتلي المتّبع بالمتّبع، وذلك بأن يزيغ المتبعُ، فتكون زيغتُه فتنةً توجب الاجتناب والردَّ.
وفي ذلك قول معاذ بن جبل رضي الله عنه فيما رواه يزيد بن عميرة: (وأحذركم زيغةَ الحكيمِ؛ فإنِّ الشيطانَ قد يقول كلمة الضلالةِ على لسانِ الحكيمِ، وقد يقول المنافقُ كلمةَ الحقِّ. قال: قلت لمعاذٍ: ما يدريني – رحمك اللهُ – أن الحكيمَ قد يقول كلمةَ الضلالةِ، وأنَّ المنافقَ قد يقول كلمةَ الحقِّ؟ قال: بلى! اجتنبْ من كلام الحكيمِ المشتهراتِ، التي يقال: ما هذه؟! ولا يثنينَّك ذلك عنه؛ فإنه لعله أن يراجع، وتلقَّ الحقَّ إذا سمعتَه، فإنَّ على الحق نورًا).
فالمخالفون للحقِّ درجات، فمنهم الكافر، ومنهم المنافق، ومنهم المبتدع، ومنهم العاصي، كما أنَّ منهم المجتهد الذي يقصد الحق لكن يزيغ عنه.
وعلى هذا فحديثنا عن منهج الردِّ على المخالفين: يعمُّ جميع هؤلاء.
وقد كتب العلماء في المنهج الصحيح في الردِّ على المخالفين، وكانت لي مشاركةٌ في هذا الباب بدراسةِ منهج الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الردِّ على المخالفين، لكونه إمامَ هدى، فكتبتُ فيه رسالةً، عرضتُها على أهل العلم؛ منهم الشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد العزيز السدحان، حفظهما الله، فكتبا تقريظًا للبحث مشكورَيْن، وهو البحث الذي تقدمت به لرسالة الماجستير.
وإني أنصح وبشدّة بقراءة مقدمة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله لكتابه العظيم «الردُّ على المخالف من أصول الإسلام»، فقد بيَّن الشيخ رحمه الله بما لا مزيد عليه منزلة الردِّ على المخالفين من الدين، ورَّغب فيه، وذكر أهميته وعاقبته.
لا بد لنا أولاً أن نعرِّف المخالفة قبل أن نتكلم عن المنهج الصحيح في الردِّ على أصحابها:
المخالفةُ: هي كلُّ ما خالف الكتاب والسنّة وهديَ سلف الأمة، وهو المنكرُ في الشرع المذكور في النصوص كقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر}، وفي قوله في الحديث: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» الحديث.
قال ابن تيمية: (فإذا كان القول يخالف سنَّة أو إجماعًا قديمًا وجب إنكاره وفاقًا، وإن لم يكن كذلك فإنَّه يُنكر بمعنى بيان ضعفه… وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضًا بحسب درجات الإنكار…
إلى أن قال: وإذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغٌ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً).
وقال الشيخ ابن باز: (والخطأ ما خالف الدليلَ الشرعي، وهو ما قاله الله ورسوله، فلا يُؤخذ أحدٌ من الناس إلا بخطأ يخالف الدليل).
فالقول أو الفعل إذا خالف: نصًّا من الكتاب أو السنَّة، أو خالف إجماعًا، أو خالف عملًا للسلف، فهو مخالفة شرعية، ومنكرٌ يوجب الإنكار، حتى لو قال بعض عالمٌ أو إمام معتبر، فإنَّ العبرة بمخالفة النص والإجماع وعمل السلف، لا بمنزلة ومكانة قائله أو فاعله.
منزلة الردِّ على المخالف في الدين
الناس منقسمون في الردِّ على المخالفين:
منهم من يمنع من الردّ مطلقًا زعمًا أنه يفرق الصف ويمزق الكلمة
ومنهم من يرى الردّ في كل شيء ولو على أمور لا تستحق الردّ، أو على أمور تختلف فيها الآراء
ومنهم قسمٌ وسط يرى الردّ على المخالفين من الدين، بل من أصوله الكبار وقواعده العظام التي يُحفظ بها الدين ويُصان من التحريف، وأنَّ هذا من أخص وظائف العالم والداعية.
ومن هنا سمَّى الشيخ بكر أبو زيد كتابه في هذا باسم «الردُّ على المخالف من أصول الإسلام».
أنواع الردّ على المخالف
قسّم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله الردّ على المخالف إلى ثلاثة أقسام، فقال:
(الأول: الردّ المحمود:
واجب، أو مستحب، وهو الذي يُحق الحقَّ، ويُبطل الباطلَ، ويهدف إلى الرشد. وهذا يختلف باختلاف الأحوال، والأشخاص، والبواعث، والمقامات، والنفوذ إلى ديار الإسلام…
النوع الثاني: ردٌّ مذموم:
محرم أو مكروه، وهو ما يكون لدفع الحق، أو تحقيق العناد. وعلى هذا النوع: «الردّ المذموم» تُتنزّل ردود المخالفين –كأهل البدع والأهواء- على أهل السنّة والجماعة، ومجادلتُهم، وإيذائُهم، وهدمُ ما هم عليه من الحق والهدى…
النوع الثالث: الردّ الجائز:
ويقال: السائغ، مثل ما يحصل من الردّود في محيط الخلاف السائغ في الفروعيات، التي تتجاذبها الأدلة، وتكافأت في نظر المجتهد).
فالردُّ على المخالف من وسائل صيانة الدين وحمايته، وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي خُصّت به هذه الأمة، وهو من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله
قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}.
وقال تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}.
وقال تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}.
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».
والقرآن مليء بالردِّ والإنكار على المخالفين، ففيه الردُّ على المشركين والمنافقين، والرد ُّعلى اليهود والنصارى، وعلى كلِّ من خالف الدليل من المسلمين، كالردِّ على من والى اليهود والنصارى، أو آذى الرسول، أو رفع صوته، أو عصى أمره، وغيرِ ذلك، وهو كثير في القرآن.
قال تعالى: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا}.
قال الطبري: (ولا يأتيك يا محمد هؤلاء المشركون بمثل يضربونه إلا جئناك من الحق، بما نبطل به ما جاءوا به، وأحسن منه تفسيرًا).
وقال البغوي: (فسمَّى ما يوردون من الشبه مثلًا، وسمَّى ما يدفع به الشبه حقًّا).
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ}.
وقال تعالى: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ}.
قال ابن تيمية: (فالرادُّ على أهل البدع مجاهدٌ، حتى كان يحيى بن يحيى، يقول: الذبُّ عن السنَّة أفضل من الجهاد).
والردُّ على المخالفين من أخصِّ أوصاف علماء الملة، وأئمة الدين.
قال الإمام أحمد في مقدمة كتابه في الردِّ على الجهمية في وصف أهل العلم: (ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين).
وقد جاء هذا المعنى في حديثٌ مرويٌّ عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحمل هذا العلم من خَلَفٍ عدولُه، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين».
وبهذا نعرف خطأ، بل ضلال، من يهون من باب الردِّ على المخالف، وخطورةَ هذا المسلك الذي ينفتح بابُ الشرِّ والبدعِ وتحريفِ الدين.
من سديد القول في هذا المقام ما ذكره الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه «الردّ على المخالف من أصول الإسلام»، فقد خصص المبحث الخامس في ذكر مضار السكوت عن المخالف، والسادس لذكر ثمرات القيام بهذه الوظيفة الشرعية، فذكر من مضار السكوت:
(1- نزولُ درجة أهل السنة درجاتٍ بتعطيل عنصر مهم من حياتهم الوظيفية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومجاهدةِ المبطلين.
- ارتفاعُ أهل الأهواء على أهل السنة.
- مدُّ المخالفة، وانتشارُها: في الاعتقاد، والأقوال، والأعمال.
- فُشُوُّ الشبهة، ومداخلتُها للاعتقاد الحق، وتلعُّبها بالعقول كتلعّب الأفعال بالأسماء.
- تحريكُ العقيدة الحقة عن مكانتها بعد ثباتها، فيضعفُ الاعتقادُ السليم، ويضعفُ سلطانُه.
- إسقاطُ العقوبات الشرعية لأهل الأهواء، وأهلِ الشهوات.
- إيالةُ المسلمين إلى أمة مستسلمة، منهزمة.
- كسرُ الحاجز النفسي بين السنّة والبدعة، والمعروفِ والمنكر، فيستمرئُ الناسُ الباطل.
- في السكوت عن المخالف تأثيمُ ذوي القدرة بترك واجب الردِّ، والتفريطُ في حراسة الدين.
- تحجُّجُ العامة بالسكوت على نسبة الأهواء، والشهوات، إلى الدين.).
وذَكَر أيضاً من ثمرات الردّ على المخالف:
(١- اتقاء المضارِّ الناجمة عن السكوت.
٢- نشر السنّة، وإحياءُ ما تآكل منها.
٣- من أهم المهمات: نصحُ المخالف، ونصحُ جميع المسلمين.
٤- تنقيةُ الساحة من المنكودين بالتعريف عليهم بما خالفوا به أَمْرَ السنّة والكتاب.
٥- إن الدفع في صدور المخالفات المذمومة كفٌّ لبأسها عن المسلمين.
٦- دفعُ الإثم عن المسلمين بالقيام بهذا الفرض الكفائي.
٧- نيلُ شرف الرتبة بالقيام بهذه الحسبة للذبّ عن الشريعة وحملتها).
ومن هنا اعتنى أهلُ العلم وأئمة السنّة وحرّاسُ الشريعة بالردّ على المخالفين، وتنوعت في ذلك مصنفاتُهم، ولم تكن ردودُهم مقصورةً على المعتقد، بل عمَّت أبواب الدين.
وعَنْوَنَةُ الكتب عند الأئمة بـ«الردّ» أشهر من أن يُذكر، من ذلك كتاب «الردّ على سير الأوزاعي» للقاضي أبي يوسف، وكتابُ «الردّ على الجهمية والزنادقة فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» للإمام أحمد، و«الردُّ على الجهمية» لابن أبي حاتم، والدارمي، وابن مندة، وغيرهم، و«الردُّ على بشر المريسي» للدارمي، و«الردُّ على من أنكر الحرف والصوت» لأبي نصر السجزي، وكتاب «الإمامة والردِّ على الرافضة» لأبي نعيم، و«الانتصارُ في الردِّ على المعتزلة القدرية الأشرار» للعمراني، و«الردُّ على الخليلي» لأبي عمر السمرقندي، و«الردُّ على من يقول القرآن مخلوق» للنجاد، وكتب «الردُّ على الأخنائي» و«الردُّ على البكري»، و«الردُّ على الفلكيين» لابن تيمية، و«الصارمُ المكي في الردّ على السبكي» لابن عبد الهادي، و«الردُّ على ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام» للذهبي، وكتاب «الردُّ الوافر» لابن ناصر الدمشقي، و«الإتحافُ في الردِّ على الصحاف» لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، و«غايةُ الأماني في الردّ على النبهاني» للألوسي، وغيرها كثير.
والردُّ على المخالفين من فروض الكفايات، لا من واجبات الأعيان، متى قام به من يكفي سقط الوجوب عن الآخرين.
قال ابن تيمية: (الأمرُ بالمعروف والنهسُ عن المنكر فرضٌ على الكفاية).
وقد وُجد من العلماء من ليس له نشاط في الردِّ اكتفاءًا بغيره لا تركًا لواجب.
وقد غلا في هذا الباب أناسٌ وجفا آخرون:
فأما أهلُ الجفاء فقد تركوا باب الردِّ على المخالفين، فمنهم من تركه كسلًا، وتقاعسًا وتخاذلًا، ومنهم من تركه منهجًا ومسلكًا، حيث عدَّ الردَّ من أسباب تفريق الأمة بزعمه وتمزيقها، وهذا حال الجماعات والأحزاب الدعوية اليوم.
كما غلا فيه آخرون، حتى جعلوا هذا البابَ أصل الأصول، وعدُّوه أبرزَ علامات السلفي، وزهدوا فيمن لم يشتغل به، بل ربما اتهموه في دينه ومنهجه، وهذا ما دفع بعضَ أنصافِ المتعلمين والمبتدئين في طلب العلم يُدلون فيه بدلوهم إثباتًا لسلفيتهم، فأساءوا وجهلوا وأفسدوا حتى صاروا شيعًا وأحزابًا.
المخالفات الموجبة للردِّ تختلف من عدة اعتبارات
والمخالفات الموجبة للردّ والإنكار تختلف من عدة اعتبارات:
باعتبار بعدها عن الدليل:
فكلما كان القول أبعدَ عن الدليل كان أوجب في الردِّ والإنكار، كمسائل التوحيد والعقيدة فإنها أوجبُ في الردِّ من مسائل الفقه والأخلاق.
وباعتبار فاعلها وقائلها:
فالمخالفة التي تصدر من الشخص المتَّبع المعظّم كالعالم المُتَّبَع أو الداعية المشهور ونحوهما أوجب في الإنكار من مخالفة غيرِه، لأنَّ دواعي انتشار المخالفة وذيوعِها والعمل بها أعظمُ لما لقائلها من مكانة والحظوة عند الناس.
وباعتبار الزمان والمكان:
فالمخالفة إذا وقعت في بلدٍ تُعظَّم فيه السنّة فإنها أعظمُ خطرًا وأوجب في الإنكار من وقوعها في بلدٍ تكثر فيه المخالفات والبدع، وهكذا يُقال في المخالفة في زمان السنّة.
وقد أعظم السلف النكير على أمور لو حدثت في غير عهدهم في أزمنة ضعف السنَّة وأهلها لم تلق مثل هذا الإنكار والتغليظ، ولك أن تقارن بين مواقف الإمام أحمد مع مخالفي زمانه، ومواقف ابن تيمية على جنس أولئك المخالفين.
كل من خالف النصوص والإجماع وجب الردُّ عليه
لعموم الأدلة الموجبة لإنكار المنكر والردِّ على من خالف الكتاب والسنّة، وفارق إجماع الأمة.
فقوله: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» الحديث، يعمُ كلَّ منكر، وكلَّ صاحبِ منكر.
فلا يُستثنى من ذلك أميرٌ ولا مأمور، ولا حاكمٌ ولا محكوم، ولا عالمٌ ولا جاهل، ولا شريفٌ ولا وضيع.
لكن تختلف طريقةُ وأسلوبُ الردِّ والإنكار باختلاف الأشخاص والأحوال.
فليس في الإسلام قداسةٌ لأحد، كما هو حال الجماعات والأحزاب حيث يمنعون من الردّ على أخطاء رؤسائهم ومعظّميهم، لأنهم يرونه مُضعفًا لحزبهم ومفرقًا لجماعتهم.
ومثلهم من يزعم محاربةَ الحزبية وهو غارقٌ في وحلها، فتراه يمنع من الردِّ على خطأ مُعظَّم أو شيخٍ معيِّن، بحجة انتصابه للردِّ على المبتدعة، فتراهم يتعللون بأننا لا نريد أن يتقوى المبتدعة عليه بردِّنا، فيُقدِّمون مصلحة الشخص على مصلحة الإسلام والمسلمين، وهذا هو فعل الأحزاب سواء.
بل الواجب الردُّ على هذا الشيخ والمعظَّم وبيان خطئه نصحًا للأمة، لكن بأسلوب لا يُنفِّر عنه، ولا يُزهِّد فيه إن كان من أهل السنّة على ما سيأتي التفصيل فيه.
قال الشيخ ابن باز فيما لو أخطأ أحد دعاة السنّة: (فالواجب أن يُنبَّه على أخطاءه بالأسلوب الحسن، ولكن ما يُنفِّر منه وهو من أهل السنَّة، بل يُوجَّه إلى الخير، ويُعلَّم الخير، ويُنصح بالرفق في دعوته إلى الله عز وجل، ويُنبَّه على خطئه، ويُدعى الناس إلى أن يطلبوا منه العلم، ويتفقهوا ما دام من أهل السنَّة والجماعة، فالخطأ لا يوجب التنفير منه، ولكن يُنبَّه على الخطأ الذي وقع منه).
الرد على المخالف من أسبابِ توحيدِ الأمة واجتماعِها، لأنَّ اتحاد الدين والعقيدة والمنهج هو سبيل اتحادِ الأبدان والقلوب
وقد بيَّنت نصوص الكتاب والسنَّة أنَّ السكوت عن الأخطاء من أسباب الفتنة ومن عوامل انتشار الشر والفساد، كما أنه من أسباب التفرق والبلاء.
قال تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ. كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ}.
وقال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}.
ففي الآية أن الاعتصام بالكتاب والسنَّة والاجتماع على ذلك من أسباب الوحدة والاجتماع والقوة.
وقال تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}
وفيها أنَّ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والردِّ على المخطئين من أسباب التفرق والاختلاف والعذاب.
وقال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}.
وقال تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ}.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مثلُ القائمِ على حدود الله والواقعِ فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضُهم أعلاها، وبعضُهم أسفلَها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرُّوا على من فوقهم، فقالوا: لو أنَّا خَرَقْنا في نصيبنا خرقاً ولم نُؤذِ مَنْ فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً».
ولم تزل سنّة العلماء الردَّ على المخطئين، وقد صنَّف كثير منهم في ذلك.
قال الشيخ ابن باز: (ليس من أهل العلم السلفيين من يكفِّر هؤلاء الذين ذكرتَهم، وإنما يوضحون أخطاءهم في تأويل الكثير من الصفات، ويوضحون أن ذلك خلافُ مذهب سلف الأمة، وليس ذلك تكفيراً لهم، ولا تمزيقاً لشمل الأمة، ولا تفريقاً لصفهم، وإنما في ذلك النصحُ لله ولعباده، وبيانُ الحق والردُّ على من خالفه بالأدلة النقلية والعقلية، والقيامُ بما أوجب الله سبحانه على العلماء من بيان الحق وعدمِ كتمانه، والقيامُ بالدعوة إلى الله والإرشاد إلى سبيله، ولو سكت أهلُ الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم، وقلدهم غيرُهم في ذلك، وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعدهم الله عليه في قوله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ}).
ضوابط وقواعد في الرد على المخالف
الأمر الأول: لا بد من التحقق من اعتبار الفعل أو القول المردود عليه مخالفٌ للشرع
والمخالف للشرع هو ما خالف النصَّ أو الإجماع، أو عملَ السلف.
وذلك أنَّ بعض الناس قد ينكر ما ليس منكرًا في الشرع، بل قد يُنكر ما هو معروفٌ جهلًا منه، وجرأةً.
ومنهم من يُنكر ما خالف رأيه واجتهاده، وهذا كثير جدًا عند من تأمل بعض الردود التي تكون بين بعض طلبة العلم، حيث تجده دائرًا على الرأي لا على الدليل على ما سيأتي بيانه.
قال العثيمين: (فمن شروط الأمر بالمعروف والنهي: أن يكون الإنسان عالماً بأن هذا منكر، يعني أنه قد أنكره الشرع، فلا يجوز أن يحكم بالذوقِ أو بالعاطفة أو ما أشبه ذلك؛ لأن المرجع في هذا إلى الشرع، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}… إذاً لابد أن نعلم أن هذا الذي ننكره منكرٌ، ولابد أيضاً أن يكون الذي ننكر عليه يرى أنه منكرٌ، فإن كان لا يرى أنه منكر، وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد فإنه لا يلزمنا أن ننهى عنه؛ لأنَّ الدين يسر، والصحابة رضي الله عنهم وهم أجل منا قدراً وأحبُّ للائتلاف والاجتماع منا، لا ينكرُ بعضهم على بعض في مسائل الاجتهاد).
الأمر الثاني: التثبت من وجود القول أو الفعل قبل الشروع في الردّ على قائله أو فاعله
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}.
وقد روى الإمام أحمد وغيره في سبب نزولها قصة الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق، فخاف منهم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأنهم منعوا الزكاة وهمُّوا بقتله، ولم يكن شيءٌ من ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم، فأتى سيدُهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بحقيقة الأمر، وأنَّ عامله لم يأتهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية.
الأمر الثالث: الإخلاص في الردِّ بقصد النصيحة للمردود وللمسلمين، وعدمُ الانسياق لداعي النفس واتباعِ الهوى بقصد الانتصار للنفس والانتقام، وهذا الأصل يتبعه التزام ما بعده من الضوابط
فإنَّ الإخلاص أصلُ كل عمل، وهو شرطٌ في قبول الأعمال كلها
قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ}.
وفي الحديث: «إنما الأعمال بالنيات».
الأمر الرابع: حصر الردّ في محل النزاع، وعدمُ الخوض في أمور خارجة عن محل النزاع
لا بد من تحرير موضعِ المخالفة الشرعية من كلام أو فعل المردود عليه، وتحديدِ موضع النزاع.
قال الشيخ بكر أبو زيد: (إحكام الإدراك لمأخذ المخالفة ومَدْرَكِها، أساسٌ في ترتيب النقض، فالزمه).
كأن يقول: قال فلان كذا وكذا، وما قاله مخالف للنصوص بدلالة كذا وكذا.
وبعض الناس في ردوده يخرج عن محل النزاع إلى أمور أخرى لا تعلّق لها بموضع المخالفة والخطأ.
كالكلام على جنسية المردود عليه، أو بلده، أو لونه، أو نسبه، أو شهادته، أو مشايخه، أو أصحابه، أو يذكر موقفًا شخصيًّا جرى له مع المردود عليه، أو مخالفةً رجع عنها، أو ذنبًا تاب منه، ونحو ذلك.
وهذا ينم إما عن جهلٍ بأصول وقواعد الردّ، أو عن فسادِ نية وسوءِ قصد، بحيث يقصد الرادُّ بذلك: تحقيرَ وتصغيرَ وتسفيهَ المردود عليه وإسقاطَه، ويزداد هذا الأمر قبحًا إن كان المردود عليه من أهل السنّة والجماعة، وقد يكون أعلمَ من الرادّ وأفقه، وأتقى لله وأورع، وقد يكون أعلى منزلة وأرفع قدرًا، وقد يكون من ذوي الوجاهات والهيئات، أو من أهل الحل والعقد، أو من أهل الفتيا.
وهذا للأسف يقع كثيرًا ممن ينتسب إلى أهل السنّة والجماعة ممن لم يتخلّقوا بأخلاق السلف، يريد بعضهم بمثل هذه الأمور الخارجة عن محل النزاع العلوَّ في الأرض، والارتفاعَ على الناس، أو ليصرف وجوهَ الصغار والأغمار إليه حتى يكون مرجعًا لهم وميزانًا تُعرض عليه مناهجُ الدعاة فيحكم فيها بما يريد.
وهذا مما ابتُلي به أصحابُ منهج الغلوِّ في التبديع، وردودُهم مليئة بهذه السيئة، يدركها كلُّ من رأى ردودهم وجرأَتهم فيها، ومحاولتَهم إسقاطَ كلِّ من خالفهم، ولم يُذعن لأهوائهم.
وقد يكون الخروج عن محل النزاع إلى ما ذكرنا من الأمور سببه ضعفُ حجة الرادّ، وقوةُ حجة المردود عليه، فترى الرادَّ لا يحرر محل النزاع ولا يُبيّن موضع الانتقاد من مقال المردود عليه، أو كتابته، أو تغريدته، فترى الرادَّ لضعف حجّته يذكر أمورًا ليست موضع نزاع مع المردود عليه ولا تعلق لها بموضع المخالفة المزعومة، محاولًا بذلك تشتيتَ ذهن القارئ والسامع وصرفَه عن محل النزاع إلى غيره.
كما أنه قد يُفعل ذلك أيضًا بقصد إيهام السامع والقارئ أنَّ المردود عليه أخطأ في مسألة معينة، مع أنَّ المردود عليه لم يخطأ فيها، لكن الرادَّ يحاول تقويل المردود عليه ما لم يقل، وتحميلَ كلامه ما لا يحتمل، ليحصل مقصودُه بتخطئته والتشنيعِ عليه.
وقد قال تعالى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}.
وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنه الله في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال».
الأمر الخامس: العناية بذكر المخالفة وبيان صورة ما وقع منها والتدليل على كونها مخالفة شرعية تستوجب الردّ
قد سبق أن ذكرنا أن الردَّ يُشرع عند وجود ما يخالف الشرع من الأفعال والمقالات، وهو المنكر الذي أمرنا بإنكاره.
ومن هنا فإنَّ الرادَّ لا بد أن يُبيّن وجه المخالفة الشرعية، وأن يُقيم الدلائل السمعية على أن المردود عليه قد وقع منه ما يخالف الشرع، ولا يكون ردُّ كلامًا خليًّا عن البرهان.
قال الشيخ بكر: (الإقناع يكون بالحجة والبرهان، لا بمجرد الكلام، فإنَّ الردَّ من غير دليل بمنزلة هدم العلم بالشكِّ المجرد).
فلا إنكار في مسائل اجتهادية، لا تخالف نصًّا ولا إجماعًا، قد تنازع فيها العلماء.
كما لا إنكار في مسائل حادثة تختلف فيها أنظار العلماء، لا تخالف نصًّا ولا إجماعًا، ولا هديًا للسلف، بل مردُّها إلى تقدير العالم أو طالبِ العلم من جهة المصالح والمفاسد، فما يراه شخصٌ مفسدة، قد يراه غيره مصلحةً.
المهم أنَّ الردَّ والإنكار إنما يكون على ما خالف النصوص والآثار، لا ما خالف الاجتهادات والأنظار.
فمن الناس اليوم من ينكر ما يخالفُ رأيه، لا ما يخالف الشرع والدليل، فهو في حقيقته داعٍ إلى رأيه واجتهاد ه أو إلى هواه، لا إلى الله وإلى شرعه.
فتراه يردَّ ردًّا مكتوبًا أو مصوَّرًا على شخص لم يقع منه ما يخالف النصوص، بل غايته أنه فعل أو قال ما يخالف تقدير ورأي الرادِّ.
مثال ذلك: كأن ينكر على شيخ وداعية خروجَه في قناة معينة، أو كتابتَه في صحيفة معينة، أو إلقاءَه محاضرة في موضع معين، أو زيارةَ شخص معين، أو عيادةَ شخص معين، أو ترحمَّه على شخص معين، وهكذا، فتراه يرتّب على مثل هذه الأمور ما يُرتَّب على من خالف النصوص أو الإجماع.
ولا تخلو مثل هذه المسائل أن تكون راجعة إلى تقدير طالب العلم نفسه، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص.
وكثيرًا ما يُورد على من يستنكر مثل هذه الاجتهادات ويشتغل بالردّ فيها، وقوعَ مثلها من بعض أكابر العلماء في وقائع كثيرة، فهو إذًا بين تخطئة الأكابر أو التناقض.
ومثل هذه الأمور لا مانع من التناصح فيها، بالتواصل مع من وقعت منه والتباحثِ معه، وإبداءِ الرأي وبيانِ ما يراه الإنسان من مفسدة فيها بحسب اجتهاده وتقديره، لكن لا تستلزم ولا تُجيز الردَّ المكتوب أو المصوَّر بحال.
الأمر السادس: البعدُ عن الحشو بترك كلِّ ما لا علاقة له بالردِّ، وحصرُ البحث حول الدلائل السمعية والنظرية وهو الذي فيه الفائدة والمنفعة
قد جرت عادة العلماء في ردودهم حصرُ الردّ في ذكر الدلائل النقلية والنظرية، والتركيزُ على بحثِ المسائل وتصويرِها، وبيانِ حكمها، وذكرِ آثارها، وذلك ببيان موضعِ الخطأ من كلام المخالف والتدليلِ على ذلك، وبيانِ الصوابِ مع التدليل والتعليل، وهي طريقة القرآن.
ولذلك فإنَّ كتب الردود تُعدُّ من أنفس الكتب تحريرًا للمسائل، وأحسنِها تنقيحًا لمناطات الأحكام، وأكثرِها توسعًا في الدلائل النقلية والنظرية، وأدقِّها في بيان عبر التاريخ الوقائع.
فانظر إلى: كتابَيْ «الردّ على الجهمية» و«الرد على المريسي» للدارمي، وما حواه من الدلائل السمعية والعقلية، وما تضمنه من إبطال مقالات الجهمية بحجج باهرة.
وانظر إلى كتابِ «الرد على البكري» لابن تيمية وما اشتمل عليه من تحقيق مسائل التوحيد والشرك بما لا يوجد في غيره من كتبه.
وانظر إلى كتب «بيانِ تلبيس الجهمية» و«الردِّ على المنطقيين» و«جوابِ الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية» و«منهاجِ السنة في الرد على الشيعة» وما تضمنته من دقائق العلم ونفائسِ المباحث بما لا يوجد في غيرها.
وانظر إلى كتابي «مصباح الظلام في الرد على ابن منصور» و«منهاجِ التأسيس في الرد على ابن جرجيس» لعبد اللطيف آل الشيخ، وكتاب «صيانةِ الإنسان عن وسوسة زيني دحلان» للسهسواني وما حوته هذه الكتب من المباحث والدلائل في إبطال شبهات المشركين بما لا يوجد في غيرها.
وهذا ليس خاصًا في كتب الردود في مسائل العقيدة، بل حتى في الردود الفقهية والأصولية والحديثية.
فانظر في ردِّ الشافعي على محمد بن الحسن المضمَّنِ في «الأم» وغيرِها من كتبه، وانظر إلى «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر وما حواه من الدرر والمباحث، وما حوته كتب الردود الفقهية كذلك.
وهذا يؤكد أهميةَ التركيز في الردود على المخالفين على تقرير المسائل، وحشدِ الدلائل في تقرير الحق الذي يُراد بيانه، وتوضيحِ المخالفة التي يُراد إنكارُها والزجرُ عنها.
والواقع اليوم يشهد بعدًا كبيرًا عن هذه الطريقة السلفية في كثير من الردود، فترى الواحد منهم يحشو ردَّه بما لا طائل من ورائه، ولا فائدةَ تعود منه على القارئ والسامع.
فتراه يخوض في ذكر القصص والحكايات والمواقفِ الشخصية، قال وقلت، وحَدَث وحُدّثت، ومر بي ومررتُ به، ونحوِ ذلك، على أسلوب القصاص والحكواتية.
وآخرُ يُكثر من الكلام الإنشائي، ويُطوِّل الردَّ بكلام مرتجل وتكرارٍ ممل.
قال الشيخ بكر: (فاحذر من تكثير العبارة بالتطويل، والكلام المكرور، المشتمل على الغثِّ والسمين، فهو مخلٌّ مملٌّ، بما يجلبه من وهاء وفتور).
وآخر يحاول إلزامَ المخالف بلوازم لا تلزمه، بطريقة التهويل والتضخيم غيرِ الواقعي والبعيدِ عن المنطق والعقل، فضلًا عن الشرع.
الأمر السابع: الاعتماد في الردِّ على المحكم والمعلوم والإعراض عن المشتبه والموهوم والمظنون
الأصل في الردّ على المخالف أن يكون على المحكم من أقواله وأفعاله المخالفة للنصوص، فيذكر الرادُّ نصَّ المردودِ عليه المخالفَ للنصوص، مثل أن يذكر نصَّه في أنَّ العمل شرط كمال، أو في نجاةِ تارك العمل بالكليّة، ونحوِ ذلك من النصوص المحكمة، أو يذكرَ فعله المخالف المحكمَ الثابت عنه، كحضوره الاحتفال بالمولد ومشاركتِه لأهله، أو خروجِه في الثورات ونحو ذلك من الأفعال الثابتة التي يُعلم مخالفتها للشرع.
وعلى هذا جرت ردود العلماء، فإنها كانت ردودًا على مخالفات ثابتة لا مظنونة ولا موهومة ولا محتملة.
قال الشيخ بكر أبو زيد: (فيتعين طرحُ العبارات المرهَقَة بالمعاني المحتملة بسبب العموم، والإطلاق، ولْيحمل كلام الخصم على أحسن المحامل ما أمكن ذلك).
والمخالفون في هذا الأمر من المشتغلين بالردود أنواع:
منهم من يخوض في لوازم الأقوال والأفعال، فيجعل لازمَ القول قولًا للمخالف ولازمَ الفعل فعلًا له، فهو لا يردُّ على مخالفةٍ محكمة، بل على إلزام المخالف بما لم يلتزمه حتى يجعله صريحَ قولِه وفعله.
فتراه إذا رأى أحدًا شارك في قناة معينة، ألزمه بالإقرار والرضى عن منهجها وسياستها.
وإذا رآه جالس مبتدعًا لأمر معين ألزمه بالرضا به وببدعته.
وإذا لم يشهدْه يحضر مجلسًا معينًا، أو يشاركْ في نشاط معين، أو يحاضرْ ويجالسْ مجموعةً معينة، ألحقه بخصومهم.
وقد ذكر الشيخ العثيمين هذه المسألة وجعلها على ثلاثة أحوال: الحال الأولى: أن يُذكر للقائل لازم قوله أو فعله فليتزمه، والثاني: أن يُذكر له ويمنعُ التلازمَ بينه وبين قوله أو فعله، ثم قال الشيخ: (وحكم هاتين الحالين ظاهر)، ثم قال: (الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتًا عنه، فلا يُذكر بالتزام ولا منع، فحكمُه في هذه الحال أنْ لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتملُ لو ذُكر له أن يلتزمَ به، أو يمنعَ التلازم، ويحتملُ لو ذُكر له فتبين له لازمُه وبطلانُه أن يرجع عن قوله، لأنَّ فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكمُ بأنَّ لازم القولِ قولٌ. فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازمًا مِن قوله، لزم أن يكون قولًا له، لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم. قلنا: هذا مدفوعٌ بأنَّ الإنسان بشرٌ وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهولَ عن اللازم، فقد يغفلُ أو يسهو، أو ينغلقُ فكره، أو يقولُ القول في مضايق المناظرات من غير تفكيرٍ في لوازمه ونحو ذلك).
بل الواقع يشهد بأنَّ بعض الناس يُلزمُ القائل بلوازم قد صرَّح القائل بعدم التزامها، فضلًا عن إلزامه بما سكت عنه من اللوازم.
نعم اللوازم الباطلة لا شكَّ أنها تدلُّ على بطلان الملزوم، لكن لا تُعامل اللوازم معاملةَ الصريح من الأقوال.
ومنهم أيضًا: من يخوض في الأمور المشتبهة أو المحتملة، ويُصيِّرُها أموراً محكمة ثابتة، فيشرِّقُ ويُغرِّبُ على أمر مشتبهٍ محتمل، لا على أمرٍ محكمٍ ثابت.
وكثيرًا منهم يَعمَوْن عن منهج المردود عليه المحكمِ الثابتِ في مؤلفاته ودروسه ومحاضراته، ويقفون على ما احتمل من كلامه وفعاله.
ومنهم من يأخذ مقطعًا مُجتزءًا من سياقه وموضوعه، بقصد التشنيع على قائله، ولا يرجعون إلى محكمِ كلامه، وصريحِ عبارته، هذه هي طريقةُ أهل البدع كلِّهم، يجتزءون النصوصَ، ويخرجونها عن سياقِها وموضوعِها بما يخدم بدعتهم، كما فعله أوائلهم الخوارجُ مع آيات الحكم.
وفي ذلك ما رواه البخاري أنَّ رَجُلًا حَجَّ البَيْتَ، فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا، فَقالَ: مَن هَؤُلَاءِ القُعُودُ؟ قالوا: هَؤُلَاءِ قُرَيْشٌ. قالَ: مَنِ الشَّيْخُ؟ قالوا ابنُ عُمَرَ، فأتَاهُ فَقالَ: إنِّي سَائِلُكَ عن شيءٍ أتُحَدِّثُنِي؟ قالَ: أنْشُدُكَ بحُرْمَةِ هذا البَيْتِ، أتَعْلَمُ أنَّ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ فَرَّ يَومَ أُحُدٍ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَتَعْلَمُهُ تَغَيَّبَ عن بَدْرٍ، فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَتَعْلَمُ أنَّه تَخَلَّفَ عن بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فَكَبَّرَ، قالَ ابنُ عُمَرَ: تَعَالَ لِأُخْبِرَكَ ولِأُبَيِّنَ لكَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عنْه، أمَّا فِرَارُهُ يَومَ أُحُدٍ فأشْهَدُ أنَّ اللَّهَ عَفَا عنْه، وأَمَّا تَغَيُّبُهُ عن بَدْرٍ، فإنَّه كانَ تَحْتَهُ بنْتُ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقالَ له النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ لكَ أجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وسَهْمَهُ وأَمَّا تَغَيُّبُهُ عن بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، فإنَّه لو كانَ أحَدٌ أعَزَّ ببَطْنِ مَكَّةَ مِن عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ، فَبَعَثَ عُثْمَانَ، وكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَما ذَهَبَ عُثْمَانُ إلى مَكَّةَ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيَدِهِ اليُمْنَى: هذِه يَدُ عُثْمَانَ – فَضَرَبَ بهَا علَى يَدِهِ، فَقالَ – هذِه لِعُثْمَانَ، اذْهَبْ بهذا الآنَ معكَ.
بل إنَّ بعضهم قعَّد لهذه الضلالة، وزعم أنَّ قاعدة حملِ المجمل على المفصَّلِ والمبيّن، والمتشابِه على المحكمِ، خاصَّةٌ بكلام الله وكلام رسوله فقط، أما عموم الناس والعلماء والدعاة فيُمكن الحكمُ عليهم بالمشتبه من كلامهم وبالمجمل منه، والإعراض عن المحكم والمبيَّن والمفصَّل من مقالهم وفعالهم ودعوتهم ومنهجهم.
قال ابن تيمية: (وأخذُ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهُم يجرُّ إلى مذاهب قبيحة).
وقال ابن القيم: (والكلمةُ الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدُهما أعظمَ الباطل ويريدَ بها الآخر محضَ الحق، والاعتبار بطريقة القائلِ وسيرتِه ومذهبِه وما يدعو إليه ويناظرُ عليه).
وقد أجاب الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى- على سؤال:
هل يُحمل المجملُ على المفصل في كلام الناس؟ أم هو خاصٌ بالكتاب والسنة؟ نرجو التوضيح ـ حفظكم الله ـ؟ فأجاب الشيخ: (الأصل إن يُحمل المجمل على المفصل، الأصلُ في نصوص الشرع من الكتاب والسنة، لكن مع هذا؛ نحملُ كلام العلماء، مجملَه على مفصَّلَه، ولا يُقَوَّلُ العلماءُ قولًا مجملاً، حتى يُرْجَعَ إلى التفصيل من كلامهم، إذا كان لهم قولٌ مجملٌ، وقولٌ مفصّل، نرجع إلى المفصَّل، ولا نأخذ المجملَ).
الأمر الثامن: العدل والإنصاف مع المخالف
العدلُ قوام الصلاح والاستقامة والتجرِّد لله والإخلاصِ له والصدقِ معه.
وإنما يظهر إخلاصُ الرادّ وصدقُه ومحبَّتُه للخير ونصحُه بعدله مع المخالف، وتجرُّدِه في ذلك.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}.
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون}.
قال حاتم الأصم: (معي ثلاثُ خصال أظهرُ بها على خصمي، قالوا: وما هي؟ قال: أفرحُ إذا أصاب خصمي، وأحزنُ إذا أخطأ، وأحفظُ نفسي لا تتجاهل عليه)، فبلغ ذلك الإمامَ أحمد، فقال: (سبحان الله! ما أعقلَه مِن رجل).
وكان الشافعي يقول: (ما ناظرتُ أحدًا على الغلبة، وما ناظرت أحدًا إلا وددت أن يكون الحقُّ معه).
وقال الآجري في آداب المناظرة: (فذاكره مذاكرةَ من يطلب الفائدةَ، وأعلمْهُ أنَّ مناظرتي إياك مناظرةَ من يطلبُ الحقَّ، وليست مناظرةَ مغالبٍ، ثم ألزمَ نفسه الإنصافَ له في مناظرته، وذلك أنه واجبٌ عليه أن يحبَّ صوابَ مناظرِه، ويكرهُ خطأه، كما يحبُّ ذلك لنفسه، ويكرهُ له ما يكره لنفسه، ويُعلمُه أيضًا: إنْ كان مرادُك في مناظرتي أنْ أخطئ الحقَّ، وتكونَ أنتَ المصيبُ، ويكونَ أنا مرادي أنْ تخطئ الحقَّ وأكونَ أنا المصيبُ، فإنَّ هذا حرام علينا فعلُه، لأنَّ هذا خلقٌ لا يرضاه الله منا، وواجبٌ علينا أن نتوبَ من هذا…).
وعلى هذا فلا يُحمَّل كلامُ المخالفِ ما لا يحتمل، ولا يُنسبُ إليه ما لم يقلْ، ولا يُبالغُ في توصيف خطأه ومخالفتِه بأكثر مما تستلزم بالشرع.
فمن الظلم أن يُنسبَ المخالفُ إلى بدعة بخطأٍ لا يبلغ ذلك، لا سيما إن كان مشهورًا بالدعوة إلى السنَّة.
أو أنْ يُدَّعى على المردود عليه دعاوى أكبرُ من مخالفته، كما يفعله بعضُ الناس اليوم مع بعض دعاة السنَّة، فتراهم يُعظِّمون بعضَ مخالفاته ويُطلقون عليه دعاوى عريضةً، بل شنيعةً، كأن يدعوا عليه أنه: يدعوا إلى الثورات، أو يسبُّ الأنبياء، أو يطعنُ في الصحابة، أو لا يرى السمع والطاعة، ونحوُ ذلك من أنواع الظلم والتجنّي مستدلين بما لا دليل فيه على ما يدّعون، وهذا كثير وللأسف.
ومن ذلك: الخوضُ في الاتهامات المجردة بلا بينة ولا برهان، وهذا يقع كثيرًا، ترى الواحد منهم ينبري للردِّ على مخالفٍ بحسب زعمه، وهذا المخالفُ له كتبٌ ومؤلفاتٌ ومقالاتٌ ومحاضراتٌ ودروسٌ مرئية ومسموعة، وإذا هو يترك هذا كلَّه، ولا ينقلُ من مؤلفاته ولا مقالاته ولا من محاضراته ولا من دروسه حرفًا واحدًا مخالفًا، لكنه يفزع إلى الاتهامات جزافًا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا عدل ولا علم ولا خلق ولا أدب.
لا بد من التنبيه على أنّه ليس من العدل الواجب ذكرُ ما للمخالف من حسنات، كما يدّعيه بعضهم، وذلك أنَّ باب الردِّ والتحذير والإنكار يختلف عن باب الترجمةِ والتقييم.
فقد جرت عادة العلماء في ردودهم على بيان الخطأ والمخالفة، دون ذكرِ حسنات المردود عليه، لا سيما إن كان المخالفُ له أخطاءٌ أخرى في العقيدة والمنهج، فهذا لا تُذكرُ حسناتٌه ولا كرامة.
ومواقف العلماء في هذا كثيرة، فانظر إلى موقف الإمام أحمد من داود الظاهري والحارث المحاسبي وحسين الكرابيسي، وإنكارُه عليهم وتغليظه، مع حسناتهم الكثيرة وجهودِهم الكبيرة في أبواب كثيرة من الدين.
وكلُّ من تأمل كتب الردود علم هذا.
لكن لا مانع من ذكر حسنات المردود عليه إذا كان من باب تذكيره بأعماله الطيبة ترغيبًا له في التوبة، أو تأليفًا لقلبه وقلبِ أتباعه، لكن بشرط ألا يفسدَ ذكر حسناته المقصودَ الأصلي من الردّ، وهو بيان الخطأ والتحذيرُ منه.
قال الشيخ ابن باز: (الواجب على أهل العلم إنكارُ البدع والمعاصي الظاهرة بالأدلة الشرعية، وبالترغيبِ والترهيب، والأسلوبِ الحسن، ولا يلزم عند ذلك ذكرُ حسنات المبتدع، ولكن متى ذَكَرها الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر، لمن وقعت البدعة أو المنكر منه تذكيراً له بأعماله الطيبة، وترغيباً له في التوبة فذلك حسنٌ، ومِن أسباب قبول الدعوة والرجوع إلى التوبة. وفق الله الجميع).
الأمر التاسع: التماسُ الرفق واللين وإظهارُ محبة الخير للمنصوح والحرصُ على هدايتِه ورجوعهِ إلى الحق
أهلُ السنَّة أعلمُ الناس بالحق وأرحمُهم بالخلق.
قال ابن تيمية: (وأهل السنَّة يتَّبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول، ولا يُكفِّرون من خالفهم فيه، بل هم أعلمُ بالحق وأرحمُ بالخلق، كما وصف الله به المسلمين بقوله: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}. قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس).
ومن رحمتهم بالخلق أنهم يلتمسون أقربَ الطرقِ وأمثلَها لقبول الحق الذي معهم، فيستعملون الأساليبَ الحسنة، ويتأدبّون في ردودهم، ويستخدمون العباراتِ التي تدعو إلى الاستجابة، والدعاءُ للمخالف بالهداية، وتركُ الكلام السيء والتعنيفِ في العبارة.
مبتعدين عن التجريح والتسفيه والتحقير، ومحاولةِ إسقاط المخالف والتقليلِ من شأنه، ليس هذا سبيلهم، بل هو سبيل أهل البدعة والفرقة.
قال ابن باز: (إنَّ الواجب على الدعاة إلى الله سبحانه، والناصحين لعباده، أن يتخيروا الأساليب المفيدة، والعباراتِ التي ليس فيها عنفٌ، ولا تنفيرَ من الحق، والتي يُرجى من ورائها انصياعُ من خالف الحقَّ إلى قبوله، والرضى به، وإيثارِه، والرجوعِ عما هو عليه من الباطل، وأن لا يسلكَ في دعوته المسالكَ التي تُنفِّرُ من الحقّ، ويدعو إلى ردِّه، وعدمِ قبوله).
وليس هذا خاصًّا بأخطاء أهل السنَّة دون غيرهم، أو فيما دون البدع والشركيات من المخالفات، بل هذا الأمر يعمُّ كلَّ خطأ، لأنَّ المقصد الوصولُ إلى الحق، وهدايةُ المخالف.
قال تعالى: {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}.
وقال تعالى: {اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى}.
قال ابن باز: (فالواجب على علماء الإسلام أن ينشروا دين الله بين الناس، وأن يُوضِّحوا لأهل البدع والتصوف والخرافات والانحراف بطلانَ ما هم عليه من البدع، ويوضحوا لهم السنَّة الغراء، والطريقةَ السمحة الواضحة، وأن يُبيِّنوا لهم أدلَّتها من الكتاب والسنَّة، وأن يُنبهوهم إلى أخطائهم بالأسلوب الحسن، والدليلِ الواضح، والبرهانِ القوي، والحجةِ الدامغة، والعباراتِ البيَّنة، من غير عنفٍ، ولا شدة، بل بالعبارة الواضحة، والجدال بالتي هي أحسن).
ويدخل في هذا الأصل: إنزالُ الناس منازلهم، واعتبارُ الوجاهات والمناصب:
وقد ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمَرَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُنزل الناس منازلَهم».
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: (مبحث: في تعظيم من كان رأساً في طائفته وكبيراً عند أهل نحلته). ثم ساق الحديث السابق.
وشواهد ذلك كثيرة، ومن ذلك: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وفيه: «من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ….».
وذكر الحافظ ابن حجر عند قوله «عظيم الروم» أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُخلِه من إكرامٍ لمصلحة التألف.
وهذا ظاهرٌ في مراسلات العلماء ومناصحاتُهم وردودُهم، فانظروا إلى رسائل الشيخ ابن باز للأمراء والعلماء والمفتين وأصحاب الوجاهات، مع كون بعضهم مبتدعة.
واليوم يُلاحظ على بعض طلبة العلم في ردودهم سلوكُ غير هذا السبيل، فتراهم يستعملون في مخاطبة المخالفين من العبارات والألقاب ما فيها تحقيرٌ للمخاطبين وتهوينٌ من شأنهم واستخفافٌ بهم.
فبعضهم يخاطب غيره بقوله: المدعو فلان، وآخر: يتعالى حتى عن إطلاق لفظ شيخ على طلبة العلم والدعاة، فتراه يسميه باسمه المجرد، وإذا تلطف، قال: الأخ فلان، وبعضهم يتعمد ترك اللقب الرسمي للمردود عليه، مثل الدكتور، أو المفتي ونحو ذلك، فتراه يسقط هذا اللقب من اسمه عمدًا.
ومنهم من يستدلُّ على قسوتِه في الردود، وشدتِه على الخصوم، واستعمالِه الألفاظ الفجة والمستبشعة، بفعل بعض أهل العلم غير المعصومين، فتراه يقول: الشيخ الفلاني فعل كذا في ردِّه على فلان، أو قال كذا في حقِّ فلان، وقد يكون المردود عليه من أهل السنة!
فنقول: من الجهل أن يُستدل بأفعال آحاد العلماء على خلافِ الدليل وخلافِ عملِ السلف.
وهذا من مواضع الزلل وهي أن تُجعل أفعالُ آحاد العلماء ذريعةً وحجةً على سلوك ما خالف الدليل، كحال من يتبع بعضَ آثارِ التابعين في المبالغة في التعبد الزائد عن الحدِّ المشروع.
والعلماء بشرٌ يُخطئون ويصيبون، ليسوا بمعصومين، ويعتريهم ما يعتري البشر من الغضبِ والخروجِ عن حد الاعتدال، فانظر إلى أسلوب أبي محمد بن حزم مع أعيان علماء وقته وقبل وقته، على جلالة قدره وعظم علمه، فإذا لم يكن في فعله حجة، فليس في فعل من هو دونه حجة.
الأمر العاشر: الشدة والغلظة هي على خلاف الأصل، وتكون في موضعها في حق المعاند والمتعدي
الشدة والغلظة تُشرع في موضعها، وتختلف باعتبار الشخص، وباعتبار نوع المخالفة، وباعتبار الزمان، وباعتبار المكان.
فليس الحاكمُ كآحاد الناس، وليس العالمُ كالجاهل، وليس ذو المنصب والمكانة كمن ليس كذلك، وليس الإنكارُ في زمن السنَّة وقوةِ أهلها أو في مواضع انتشارها كالإنكار في أوقات ضعفها أو قلةِ أهلها أو زمن انتشار الجهل، وليس خطأ السني كخطأ المبتدع.
فالشدةُ مطلوبةٌ في وقتها، وتكون حق من تعدَّى وظلم، وتجاوزَ الحدود، أو فعل أمراً، أو قال كلاماً لا يجهلُه مثلُه، وقد يكون فساد الكلام معلوماً بالضرورة، أو مما لا يجهله عامة الناس.
قال تعالى: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ}
والعناد والتعدي قد يظهر تارةً في إصرار المتكلم بالباطل على ما هو عليه بعد قيام الحجة وبلوغ البيان، وبعد أن توجَّه إليه النصح، ثم يعاندُ ويعارض، وقد يظهر العناد والتعدّي باعتبار ما خالف فيه من المسائل، فإنَّ تَكَلُّم الإنسان بالمسائلِ التي اشتهر عند عموم الناس مخالفتُها للكتاب والسنَّة، ومثله لا يُتصور جهلُه بها، يدلُّ على عنادٍ وتعدٍّ وإصرارٍ على الباطل.
قال الشيخ ابن باز: (وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررُها أكثر، وإنما الواجب والمشروع هو الأخذ بما بينه الله عز وجل في سورة النحل، وهو قوله سبحانه: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ}، إلا إذا ظهر من المدعو العنادُ والظلمُ، فلا مانع من الإغلاظ عليه كما قال الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ}، وقال تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ}).
وقال: (ولأنها – أي الشريعة- تبدأ في دعوتها باللين، والحكمة، والرفق، فإذا لم يؤثِّر ذلك، وتجاوز الإنسان حدَّه، وطغى، وبغى، أَخَذْتَهُ بالقوة والشدة، وعاملتَه بما يردعه، ويُعرِّفُه سوء عمله …
إلى أن قال: ولا ينبغي للداعية أن يلجأ إلى الشدة والغلظة، إلا عند الحاجة والضرورة، وعدمِ حصول المقصود بالطريقة الأولى).
وبعض طلبة العلم في ردوده بالكاد يتلطف مع مخالفه، مع أن مخالفه قد يكون من أهل السنة والجماعة، ومن الدعاة إلى الله.
الأمر الحادي عشر: التفريق في باب الردود بين أهل السنَّة والاتباع وغيرِهم من أهل البدع والانحراف
أهل السنّة والجماعة، من كان منهم معروفًا بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة، والنشاطِ في ذلك، إذا أخطأ فإنه يُردُّ عليه من غير تنفيرٍ عنه وعن دعوته، ومن دون تزهيدٍ فيه وفي علومه ونشاطه، فإنَّ المقصود بالردِّ تكميلُه وإعانتُه على الخير، لا تكثيرَ الشرِّ بالتنفيرِ عن دعوته إلى السنَّة، وتزهيدِ الناس فيها.
قال الشيخ ابن باز: (فالواجب على الداعي إلى الله أن يُرغِّب الناس في العلم، في حضورِ دعوة علماء أهل السنَّة، ويدعوهم إلى القبول منهم، ويَحْذَرَ التنفير من أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة، والدعوةِ إلى الله عز وجل، وكُلُّ واحدٍ له أخطاء، ما أحدٌ يسلم… فالواجب أن يُنبَّه على أخطاءه بالأسلوب الحسن، ولكن ما يُنفِّر منه وهو من أهل السنَّة، بل يُوجَّه إلى الخير، ويُعلَّم الخير، ويُنصح بالرفق في دعوته إلى الله عز وجل، ويُنبَّه على خطئه، ويُدعى الناس إلى أن يطلبوا منه العلم، ويتفقهوا ما دام من أهل السنَّة والجماعة، فالخطأ لا يوجب التنفير منه، ولكن يُنبَّه على الخطأ الذي وقع منه، فكل إنسان له أخطاء، ولكن الاعتبار بما غلب عليه، وبما عُرف عنه من العقيدة الطيبة).
وبعض الدعاة اليوم يستخدم في ردوده أسلوبًا واحدًا، لا يفرق فيه بين أهل السنّة وغيرهم، ولا بين الدعاة وغيرهم، وهذا أسلوب منفر مخالفٌ للكتاب والسنة، ومخالفٌ لهدي سلف الأمة، ومخالفٌ للحكمة والعقل.
الأمر الثاني عشر: الأصل في الرد أن يكون على الأوصاف دون الأشخاص، لأن المقصد هو الهدايةُ والبيانُ العام والتأصيلُ والتقعيدُ مع قطع النظر عن الفاعل والمخطئ
وهذه هي الطريقة الشرعية، كقوله صلى الله عليه وسلم: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا».
فطريقة أهل السنَّة والجماعة هي التقعيد والتأصيل، دون التشهير والتجريح.
وطريقتهم تقوم على تربيةِ الناس على الدليلِ وربطِهم به، وتعريفهم الحق به، لا بالأشخاص.
قال علي رضي الله عنه: (إنَّ الحق والباطل لا يُعرفان بالناس، ولكن اعرف الحقَّ تعرِفْ أهله، واعرف الباطلَ تعرفْ من أتاه).
وقال الشيخ بكر أبو زيد: (الأصلُ هو الستر، والعملُ على دفع دواعي الفرقة والوحشة وعدمِ الموافقة. فالردُّ ينصبُّ على المقالة المخالفة المذمومة لا على قائلها، وتعيينُ اسمِ قائلها حسب مقتضى الأحوال …).
وبهذه الطريقة يسلم الرادُّ من الهوى كالانتصار للنفس والانتقام والتشفّي، كما يسلم أيضًا من حملِ المردود عليه وأتباعه على الاستكبار والعناد.
وهذا الأصل قد تُرك وللأسف، فصارت عامة الردود اليوم، لا سيما ممن يدَّعي السلفية، ويتشدَّق بها، على خلاف هذا الأصل، وخلاف هذه القاعدة النبوية السلفية
قال ابن باز: (نصيحةُ إخواني العلماء والدعاة بأن يكون نقدُهم لإخوانهم فيما يصدر من مقالات، أو ندوات، أو محاضرات، أن يكون نقداً بناءً، بعيداً عن التجريح وتسميةِ الأشخاص. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقتِه إذا بلغه عن بعض أصحابه شيء لا يوافق الشرع نبَّهَ على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ثم يُبيّن الأمر الشرعي عليه الصلاة والسلام).
بل صار تركُ التسمية في الردّود وفي النقد عيبًا يُعاب به الرادُّ والناقد، حتى إذا قام بعض طلبة العلم بانتقاد أمورٍ خاطئة في الدعوة، أو واقعة من بعض الدعاة، بقصد التحذير والنصيحة والتنبيه، دون التشهير بفاعلها، انبرى له بعضُ الناس وطالبوه بالتسمية، وعابوا عليه ترك التسمية، سبحان الله! يطالبون بنقيض الطريقة الشرعية، ويعيبون منهج العلماء
وليس المقصودُ بهذا الكلام منعَ التسمية مطلقًا، بل ذِكر الأشخاص قد يكون مطلوبًا، بل متعيِّنًا أحيانًا، لكن يكون عند الحاجة إلى ذلك، إما لعدم تحقق المقصودِ بالنقد والتحذير إلا بالتسمية، أو لشهرةِ هذا القول عن قائله وذيوعِه وانتشارهِ في وسائل الإعلام أو التواصل، أو بسبب خطورةِ مقالتِه على الدين خشيةَ التباسها على الناس، ونحوِ ذلك من الأسباب
ومع ذلك فعند التسمية لا بد من مراعاة التلطف في العبارة أكثر مما يكون عند الإبهام دفعًا لمفسدة الاستكبار والعناد والإصرار
كما أنه يجوز التشهير والتحذير بل يجبُ بمن عَظُم خطره من المخالفين ممن ظهر عنادهم، وكذلك التشهيرُ بالجماعات والتنظيمات المنحرفة عن جادة السنَّة بعد بذل النصيحة والبيان
ومواقف السلف في هذا كثيرة، منها موقف الإمام أحمد مع حسين الكرابيسي، فقد جيء بكتاب إلى الإمام أحمد وهو لا يدري من وضع الكتاب، وكان في الكتاب الطعنُ في الأعمش، والنصرةُ للحسن بن صالح. وكان في الكتاب: (إن قلتم إنَّ الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج، فهذا ابن الزبير قد خرج). فلما قُرئ على الإمام أحمد، قال: هذا جَمَعَ للمخالفين ما لم يُحسنوا أن يحتجوا به، حذِّروا عن هذا، ونهى عنه.
وقال الشيخ ابن باز: (وأوصي بالحذر من دعاةِ الهدم، من دعاةِ الضلالة، فيجب الحذرُ منهم والتحذير، يجب الحذرُ والتحذير من دعاة الضلالة، مثلِ هؤلاء الذين يرسلون دعواتهم الضالة المضللة من لندن، ومن بلاد الكفرة كـ «المسعري» وأشباهه، ومن يتعاون معه على التخريب والفساد وتضليلِ الناس، هذا شرٌّ عظيم وفسادٌ كبير).
فالدعاة إلى البدعة والضلالة لا غيبة لهم، بل يجب فضحُهم وتعريةُ مناهجهم لئلا يلتبس الأمر على الناس، فيحصل بالسكوت عنهم فتنةٌ وشرٌّ
وهكذا الحالُ مع الجماعات والأحزاب والفِرَق، التي تدعو إلى بدعتها وتستكثر من أتباعها، لا بد من بيان خطرِها والتحذيرِ منها
قال الشاطبي رحمه الله في بيان الأحوال التي يجوز فيها تعيينُ الفِرَق الهالكة، وتسميةُ المخالفين: (والثَّاني: حيث تكون الفرقةُ تدعو إلى ضلالتها، وتزيينِها في قلوب العوام ومن لا علم عنده، فإنَّ ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس، وهم من شياطين الإنس، فلا بد من التصريحِ بأنهم من أهل البدعة والضلالة، ونسبتِهم إلى الفِرَق إذا قامت لها الشواهد على أنهم منهم، كما اشتهر عن عمرو بن عبيد وغيره…).
وقال الشيخ ابن باز: (فالواجب على علماء المسلمين توضيحُ الحقيقة، ومناقشةُ كل جماعة أو جمعية، ونصحُ الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده، ودعا إليه نبينا محمد، ومن تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية، أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله، فإن الواجب التشهيرُ به، والتحذيرُ منه ممن عرف الحقيقة، حتى يتجنب الناسُ طريقَهم، وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقةَ أمرهم، فيُضلُّوه، ويصرفوه عن الطريق المستقيم).
وهذا التحذير والتشهير يختلف بعدة اعتبارات:
باعتبار بعد المخالفة أو البدعة عن الشريعة.
وباعتبار عِظمِ الشبهة فيها.
وباعتبار كثرةِ دعاتها ونشاطِها.
فمن الخطأ الاشتغالُ ببدعة وتركُ ما هو أعظم خطرًا منها، كالتحذير من الأشاعرة مع ترك المعتزلة والجهمية والرافضة مع نشاطهم ووجودهم، والتحذيرِ من حزب التبليغ مع وجود العلمانيين والليبراليين ونشاطهم.
بل الواجب التحذيرُ من الجميع، والردُّ عليهم كلِّهم، لكن كلٌّ منهم يُردُّ على خطأه بقدره، المهم أن لا يُحذَّر من شخص أو جماعة، ويُتركَ من هم أعظم خطرًا منهم وأكثر ضلالًا.
لكنَّ الواقع اليوم يشهد اشتغالَ بعض الدعاة بالردِّ على بعض الأشخاص والجماعات والإكثارِ من ذلك، وفي نفس الوقت يسكتون عمن هم أعظم منهم خطرًا وأشدُّ بعدًا عن الشريعة، وأوجبُ في التصدِّي وردِّ باطلهم، حتى آل الأمر إلى أن صار هؤلاء الدعاة مطيةً للعلمانيين والليبراليين والتنويريين والرافضة، الذين يُوظِّفون ردودَ هؤلاء في خدمةِ أهدافهم، وتنفيذِ مخططاتهم بالطعن في الإسلام وهدمِ ثوابته وقواعدِه باسم محاربة الجماعات الثورية والحزبية، وباسم محاربة التطرف والإرهاب.
الأمر الثالث عشر: كلُّ من أظهر المنكر علانية وجب الردُّ عليه علانية في حال لم ينفع نصحُه سرًّا ليرجع عن خطأه
لا يجوز السكوت عن المنكر بعد ظهوره، فإنَّ السكوت عن المنكرات هو سبب تغيير الأديان والعقائد.
وفي الحديث: «مَثَلُ القائِمِ على حُدُودِ اللَّهِ والواقِعِ فيها، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا على سَفِينَةٍ، فأصابَ بَعْضُهُمْ أعْلاها وبَعْضُهُمْ أسْفَلَها، فَكانَ الَّذِينَ في أسْفَلِها إذا اسْتَقَوْا مِنَ الماءِ مَرُّوا على مَن فَوْقَهُمْ، فقالوا: لو أنّا خَرَقْنا في نَصِيبِنا خَرْقًا ولَمْ نُؤْذِ مَن فَوْقَنا، فإنْ يَتْرُكُوهُمْ وما أرادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وإنْ أخَذُوا على أيْدِيهِمْ نَجَوْا، ونَجَوْا جَمِيعًا»
وقال ابن تيمية: (وأما إذا أظهر الرجلُ المنكرات وجب الإنكارُ عليه علانيةً، ولم يَبْقَ له غيبة، ووجب أن يُعاقبَ علانيةً بما يردعُه عن ذلك مِن هجرٍ وغيره، فلا يُسلَّمُ عليه، ولا يُردُّ عليه السلام).
وفي النصيحة الجهرية فائدةٌ للسامع، وإرشادٌ للمجتمع، وتذكيرٌ بالحق، وتعليمٌ للناس، فنفعُها يتعدَّى المخالف والمخطئ.
لكن لا ريب أنَّ مناصحة المخطئ سرًّا إذا رُجي رجوعُه عن خطأه بنفسه وإعلامُ.
الناس بالصواب أفضلُ وأكملُ، لا سيما إن خُشي من الردِّ عليه علانيةً مضرةٌ أو مفسدةٌ، وعلى طالب العلم أن يسلك الطريقَةَ الأمثل.
قال ابن باز: (التعاون يكون بالسرِّ ويكون بالجهر، والأصل أنه بالجهر، حتى يَعلمَ السامعُ ما يُقال ويستفيد، فالتعاونُ والإرشادُ نصيحةٌ جهريةٌ للمجتمع، هذا هو الأصل، إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية عدمَ الجهر خوفاً من الشر من بعض الناس؛ لأنه لو نُصح أو وُجّه جهراً قد لا يَقْبل، وقد يتكبر، فالنصيحة سراً مطلوبة حينئذ. والناصح والموجّه والمرشدُ يتحرى ما هو الأصلح، فإذا كانت النصيحة والدعوة والإعانة على الخير جهراً تنفع الحاضرين، وتعمُّ بها المصلحة فَعَل ذلك، وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يكون التناصح في حالة السر فعلَ ذلك؛ لأن المقصود حصولُ الخير والنفعِ للمنصوح وللمجتمع، فالوسيلةُ المؤدية إلى ذلك هي المطلوبة سواء كانت سرية أو جهرية، والناصحُ والداعي إلى الله كالطبيب يتحرى الوقتَ المناسب والكميةَ والكيفيةَ المناسبة. فهكذا يكون الداعي إلى الله والناصحُ لعباده يتحرى ما هو الأنسبُ وما هو الأصلحُ وما هو الأقرب للنفع).
وعلى كل حال لا يمكن السكوتُ عن المنكر بعد انتشاره وإعلانه بين الناس، كالمقالات الفاسدة والبدع والدعوة إليها، بل لا بد من بيان الحق والصواب، لا سيما إن ظهرت المخالفة أو البدعة من شخص له منزلةٌ ومكانةٌ وقبولٌ عند الناس، بل يجب التحذيرُ من المنكر والردُّ على صاحبه ما لم تكن مضرةٌ على المنكر.
وبعض الناس اليوم قد لا يتمعر وجهُه ولا يغضبُ إذا وقع المنكر أو قيل أو نشر، كما لو قام داعية معروف أو جمعية أو جماعة، وقالوا قولاً منكرًا مخالفًا للشرع، أو نشروا بيانًا فيه مخالفاتٌ شرعية، لكن إذا قام من ينكر منكرَهم ويردُّ الباطل من كلامهم، ويبينُ الصوابَ، تمعرت وجوهُهم، وغضبوا وانتقدوا عليه قيامه بالإنكار، وبيانَه للصواب وتحذيرَه من الباطل، بينما سكتوا عن المنكر ولم يحركوا له ساكنًا، واكتفوا بالإنكار بقلوبهم وفي مجالسهم الخاصة، وهؤلاء وللأسف قومٌ انتكست مفاهيمُهم، واضطربت موازينهم، حتى صار المعروفُ عندهم منكرًا، والمنكرُ معروفًا.
لكن لا بد من التنبيه في مسألة التحذير والإنكار علانيةً من وجوب مراعاة عدة اعتبارات: منها اعتبارُ المنكر نفسِه، ومنها اعتبارُ صاحب المنكر، فمنكرُ الولاةِ يختلف إنكاره عن منكر العامة، فلا بد من سلوك الطريق الشرعي في الإنكار.
فالولاة لا يجوز الإنكارُ عليهم علانية، ولا التشهيرُ بهم، ولا نقدهم بأشخاصهم، كما جاءت بذلك النصوص، وعمل به السلف، بل يُنكر المنكرُ نفسه دون أن يُذكر فاعلُه أو قائلُه، فلو أُقرَّ قانونٌ محرم فيه ربًا مثلًا، أو مخالفةٌ للشرع، أو سمحت الدولةُ بأمرٍ محرمٍ كبيع الخمور أو إنشاءِ البنوك الربوية أو بناءِ الكنائس والمعابد ونحوِ ذلك، فيجب حينئذٍ إنكارُ المنكرِ نفسِه، والتحذيرُ منه، وبيانُ مخالفته للشرع، دون التعرض إلى صاحب الشأن كالأمير أو الوزير ونحوِهما، فيُحذَّر من الربا، ويُبيّنُ ما في القانون من مخالفة الشرع ويُحذَّرُ من العمل به، وتُبيَّنُ حرمةُ بناء الكنائس والمعابد في بلاد المسلمين، وخطورةُ ذلك على عقائد المسلمين وبلادهم، ونحو ذلك، دون أن يُشار إلى فاعلِ المنكر، أو المشرع له، فلا يقال: فعل الأمير كذا وكذا، أو أقر الوزير الفلاني كذا وكذا.
مع ضرورة التنبيه على أنَّ المنكر: هو المخالف للنص أو الإجماع، وليس المسائلَ التي يسوغ فيها الاجتهاد وتختلفُ فيها أنظار العلماء، فكلُّ ما خالف النصَّ والإجماع فهو منكرٌ يجب إنكاره، حتى لو وجد من يقول به من العلماء، فإنَّ كل قول يخالف النص أو الإجماع فهو منكر، ولا عبرة بقائله، وأما تتبع شواذ الأقوال فإنه يقود إلى الزندقة كما ذكر العلماء.
قال ابن الصلاح: (ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد).
الأمر الرابع عشر: الحذرُ من امتهان العلم وعدمِ صيانته بكثرة الردود والبيانات بغير داعٍ ولا موجب
الردُّ على المخالفين لا بد أن يكون بقدر الحاجة، فالأصلُ في الدعوة هو تأصيلُ العلم والتقعيدُ وتربيةُ الناس على ذلك، وأما الردود فهي أمورٌ استثنائية طارئةٌ عند ورود شبهة على الحق، أو ذيوعُ منكر، ونحوِ ذلك.
فالنافع للمجتمع هو البناءُ العلمي والتأصيلُ والتقعيدُ، وذلك بعقدِ حلقات العلم الممنهجةِ المرتبةِ المتدرجة، وعقدِ المحاضرات والندوات، وإقامةِ المؤتمرات البحثية ونحو ذلك من طرق البناء العلمي التأصيلي.
فمن الخطأ أن يشتغل طالبُ العلم في باب الردود أكثرَ مما ينبغي، حتى يكون هذا الأمر ديدنًا له وشغلَه الشاغل، يُضيع به وقتَه، ويُشغل به نفسَه، ويشتت أذهان متابعيه وتلاميذِه، ويُدخلهم معه في صراعاتٍ ومشاحناتٍ لا طائل من ورائها.
بل الواجب أن يكون همُّ طالب العلم الأكبر هو البناءُ العلمي، وإذا احتيج إلى الردِّ على مُبطلٍ انبرى له وزيَّف باطله، أما أنه لا يتركُ شاردةً ولا واردةً إلا علَّق عليها وصارع فيها؛ شرعيةً كانت أو تربويةً أو اجتماعيةً أو سياسيةً، فليس هذا من سبيل أهل العلم.
وهذه الطريقة تفسد أكثر مما تصلح، وقد رأينا كيف استدرجت أغمارًا وشبابًا، فانشغلوا بالقيل والقال، قال فلان كذا، وردَّ عليه فلان بكذا، وأصبح لا همَّ لهم إلا هذه المساجلات والمناكفات، حتى انشغلوا عن البناء العلمي التأصيلي، وزهدوا في مجالس العلم، وصار نشاطهم محصورًا في مثل هذه الأمور.
الأمر الخامس عشر: الحذر من الكيل بمكيالين والتطفيف في باب الردود
لا بد لطالب العلم أن تكون منطلقاتُه في كل شؤونه الشرعية مبنيَّةً على قواعدَ وأصولَ وضوابط، فإنه بهذه الطريقة يسلم من التناقض في أقواله وأفعاله ومواقفه.
ولذا عليه أن يحذر من أن تكون منطلقاته في دعوته وفي إنكاره وفي ردوده تبعًا للعاطفة، أو تحركها المصالحُ الشخصية، أو العاداتُ الاجتماعية أو السلوكية.
وكل من لم يكن متوازنًا منضبطًا بأصولٍ علمية، وقواعدَ شرعيةٍ، في ردوده، فإنه يُلحظ عليه التناقض، فتراه يردُّ على مخالفٍ، ويسكت عمن هو أعظم منه مخالفةً منه، إما لزمالة أو صداقةٍ أو بسبب توافقٍ على مصلحة مشتركة، أو هيبةٍ له بسبب منزلته العلمية أو مكانته الاجتماعية ونحو ذلك.
ومن صور التفاوت في المواقف بسبب عدم الانضباط أنك تجد بعضهم يُعلن الإنكارَ على شخص على مخالفة ظهرت منه، بينما يُسرُّ الإنكار على من هو أشد منه مخالفةً وبعدًا عن الشرع.
ومن صور ذلك: لطفُ بعضهم في ردوده على أناسٍ، وشدتُه وقسوتُه على آخرين هم أعظم علمًا وأعلى قدرًا وأقلُّ مخالفةً.
ويدخل في ذلك اعتبارُ البلد والجنسية عند بعض المشتغلين بالردود، فتجد الواحدَ منهم يسكت عن بعض المخالفات إذا صدرت من ابن بلده، وإذا ردَّ عليه ردَّ بتلطف، بينما لا يفوت مثل هذا الخطأ إذا صدر من غيره، وقد يقسو في العبارة أيضًا.
فالواجب على طالب العلم أن يزن الأمورَ بميزان الشرع، وأن تكون دعوتُه إلى الله وأمرُه بالمعروف ونهيُه عن المنكر تبعًا للمصالح الشرعية المعتبرة، لا تبعًا للأهواء والميول والطبائع.
عواقب وآثار عدم التزام منهج السلف في الردود
عدمُ التزامِ منهجِ السلف وأصولِهم في الردِّ على المخالفين له آثارٌ سيئة على الفرد والمجتمع:
منها: التنفير عن الحق، فيصبح الردُّ على المخالفين معولَ هدم لا معولَ بناء.
فإنَّ الردَّ إن لم يكن بعلم كان جهلًا.
وإن لم يكن بأدب كان سوء خلق.
وإن لم يكن بعدل كان ظلمًا.
وإن لم يعتبر الأشخاص والأحوال والأزمان كان فسادًا لا إصلاحًا.
وإن لم يكن بإخلاص كان شركًا.
وإن لم يكن بحسن قصد ونظر مصلحة كان هوىً.
ومنها: إضعافُ الحقِّ عند ضعف الردِّ والعجزِ عن إقامة الحجة، فيتقوى أهلُ الباطل ويوظفون الردَّ الضعيف لنشر باطلهم، ومن هنا منع العلماءُ أن يتولّى الردَّ على المخالفين من لم يكن متمكنًّا من العلم، ومن ليس له معرفةٌ بقواعد وضوابط الردّ.
قال ابن تيمية: (وقد ينهون -أي: السلف- عن المجادلة والمناظرة، إذا كان المناظرُ ضعيفَ العلم بالحجة وجوابِ الشبهة، فيُخافُ عليه أن يفسدَه ذلك المُضِلُّ… والمقصود أنهم نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها، أو من لا يكون في مناظرته مصلحةٌ راجحةٌ، أو فيها مفسدةٌ راجحةٌ، فهذه أمور عارضةٌ تختلف باختلاف الأحوال).
ومنها: خلقُ جوٍّ من الصراعات والصدامات والمخاصمات بغير مسوغٍ شرعي، لا سيما بين أهل المنهج الواحد، وهذا يصرف عن العلم، وفي مثل هذا الجو المشحون ينبتُ وينشطُ أهلُ الريب والزيغ والهوى.
ومنها: تحريفُ الدين ومنهجِ السلف بتغليب المصالح الشخصية وهوى النفس على المصالح الشرعية المعتبرة، فترى الواحد من هؤلاء ينسب منهجه الفاسد في الردود القائم على اتباع الهوى وتغليب المصالح الشخصية والحزبية ينسبه إلى منهج السلف ويُنظِّر في ذلك لاويًا عنق النصوص لتخدم هواه.
ومنها: إذكاءُ روحُ التعصب للأشخاص والانتصارُ لهم لا للحق، فهو يعززُ الحزبيةَ المذمومةَ باسم الانتصار لمذهب السلف ومنهجِ أهل السنة والجماعة وصيانةِ الدين.
ومنها: أنَّ الردود إذا خلت عن أدب العلم أورثت جيلًا خاويًا من الأدب والعلم والحلم والتؤدة والعقل، وهو أمر واقعٌ ملموسٌ نعيشه.
وأختم بالقول: إنَّ العلماء الراسخين، والحكماءَ أهلَ العقل والديانة، قد ردُّوا على كثير من المخالفين والأحزاب والجماعات، ولم تولِّدْ ردودُهم فتنًا ولا مشاحناتٍ ولا مخاصماتٍ بين أهل المنهج الواحد، لأنها كانت ردودًا بعلم وعدل ورحمة، سلكوا فيها مسلك الشرع، وراعوا فيها قواعدَ السلف، واعتبروا فيها تحصيلَ المصالحِ الشرعية وتكثيرَها ودرءَ المفاسدِ وتقليلَها، وهذا خلاف حالِ من لم يلتزم منهج السلف في ردوده ممن أحدثوا بردودهم فتنًا، فرَّقوا بها كلمةَ أهلِ الحق، وحزَّبوا جماعتهم، ووالوا وعادوا على آرائهم ومقالاتهم ومواقفهم