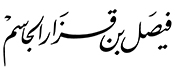الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
فقد كتبتُ تغريدة بشأن كتاب “المسلك الرشيد إلى شرح كتاب التوحيد” لمؤلفه الشيخ الدكتور سلطان العميري -وفقه الله-، انتقدتُ فيها الكتاب، وبالغتُ في نقده حيث قلت بالنص: (كتاب “المسلك الرشيد إلى شرح كتاب التوحيد” للدكتور سلطان العميري حقُّه أن يُسمَّى “الاستدراك والتعقُّب على كتاب التوحيد” فالكتاب في حقيقته استدراك وتعقبات وفيه خلط وتخبطٌ في فهم كلام العلماء ومقاصدهم وتهوين وتسهيل في مسائل الشرك بإيراد الاحتمالات وحقُّ الكتاب أن يُجتنب). وأنا أعترف أنَّ هذا الوصف العام مبالغٌ فيه، وفيه تجنٍّ وعدم إنصاف، وأنا أستغفر الله، وأعتذر عن ذلك.
لكن لمّا كثر الكلام حول الكتاب، ما بين مادحٍ وقادحٍ، ورغبةً مني في تصويب حكمي السابق فيه، رأيت لزامًا عليَّ أن أبيّن منزلة الكتاب، وأن أذكر ما له وما عليه، إحقاقًا للحقِّ، وإنصافًا للكتاب، ونصيحةً للمؤلف والقارئ.
وليس مقصودي من هذه المقالة المختصرة ذِكرَ التفاصيل والجزئيات، ولا استيعاب مواضع الثناء والنقد في الكتاب، وإنما بيانُ ما فيه من الصواب والخطأ في المُجمل، والتعليق على منهجية المؤلف فيه، وبيانُ ما هو ممدوح منها ومذموم.
فأقول: إنَّ الكتاب قد اشتمل على مميزات عدَّة، وحوى فوائد جمَّة، ليس من الإنصاف إهمالها، أو التهوين منها، كما أنَّ فيه ملاحظات ينبغي تصويبها، وإعادة النظر فيها، تكميلًا للكتاب، وتقويمًا له.
فأما مميزات الكتاب، فهي إجمالًا كالتالي:
الميزة الأولى: النَّفَس العلمي والبحثي في الكتاب ظاهرٌ لكل من قرأه واطَّلع عليه، فالمؤلف قد بذل جهدًا كبيرًا جدًّا في استيعاب فروع المسائل، وبحثها بدلائلها، والعناية بتنقيح مناطات الأحكام، وتعليق الأحكام بها. وهذا يُمكن إدراكه بسهولة بأدنى اطّلاع.
وقد اشتمل على عدة مباحث نفيسة، تستحق أن تُفرد بكتاب مستقل، فمنها على المثال لا الحصر: مباحثه في مسالك النصوص في إثبات التوحيد، وفي تعريف العبادة والردِّ على شبهات القبوريين، وفي الاستغاثة، والتبرك، وغيرها، على أنَّ بعض هذه المباحث لا تخلو من مؤاخذات.
وقد امتازت بحوثه عامةً بالاستيعاب، والعناية بتنقيح مناطات الأحكام، والردِّ على الشبهات بأجوبة محرَّرة.
الميزة الثانية: حِرصُ المؤلف على ردِّ وإبطال الأقوال الضعيفة، لا سيما أقوال أهل الضلال والشرك، وخصوم دعوة التوحيد، وقد أحسن وأجاد في عامة ردوده، مع استيعابه إيرادات الخصوم وإشكالاتهم، ونقضه دلائلهم.
الميزة الرابعة: حرصُ المؤلف على إيراد الإشكالات التي يمكن أن تُورد على القول الذي يختاره ويصححه، والجواب عنها.
الميزة الثالثة: استيعابُ المؤلف شرح كلام الماتن، وعنايتُه بجمع كلامه، وتوضيح مراده، والعناية بالدلائل، والجواب على الاعتراضات.
وأما مواضع النقد في الكتاب، فيُمكن إجمالها في الأمور التالية:
الأمر الأول: منهجية المؤلف في عَرضِ مسائل الخلاف.
الأمر الثاني: منهجية المؤلف في الاستدراك على صاحب المتن وغيره.
الأمر الثالث: بعض الاختيارات الضعيفة للمؤلف.
وهي على التفصيل كالتالي:
الأول: لم يشرح المؤلف متن كتاب التوحيد الشرحَ المعهود عن العلماء، فإنَّ العلماء اتَّخذوا هذا الكتاب قديمًا وحديثًا، منطلقًا لبيان عقيدة التوحيد وشَرْحِها، وبيانِ ما يضاد أصلها أو كمالها من أنواع الشرك كبيره وصغيره، ظاهره وخفيِّه، قوليه وفعليّه. وهو مقصود الماتن، فإنّ الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- إنما أراد من كتاب التوحيد أن يكون بيانًا لما يدعو إليه، وتوضيحًا لحقيقة دعوته الإصلاحية التي قام بها، ولذلك قيل: إنّه ألّفه في البصرة لأجل نفعِ أهلِها ونُصحِهم، وقيل: بل ألَّفه في حريملاء بعد رجوعه من البصرة، وعلى كل حال فمقصودُ الماتن: بيانُ التوحيد وتفصيلُه، والتحذيرُ من الشرك وتوضيحُه.
وعلى هذا سار شرَّاح الكتاب قديمًا وحديثًا، فإنّهم أوضحوا مسائل الكتاب، وميَّزوا التوحيد عن الشرك، فذكروا أنواع التوحيد ودلائله، وعرَّفوا الشرك وأنواعه وأحكامه، وبسطوا دلائله. ولم يقصدوا بشرحهم الكتاب أن يكون جامعًا لكلِّ ما يندرج تحت أبوابه من مسائل وفروع، أو مستوعبًا لشبهات الخصوم والجواب عليها، ونقلِ نصوصهم بحروفها وعزوها إلى مظانّها، كما صنعَ صاحب “المسلك الرشيد”.
فطريقة المؤلف مخالفةٌ للمنهجية التي سلكها العلماء في شرحهم الكتاب وعنايتهم به، وفيها خروجٌ عن مقصود الماتن، وتشتيتٌ لأذهان المبتدئين والمتوسطين في طلب العلم، في ذِكر هذه الفروع، والاستطراد في بيان الإيرادات والإشكالات والشبهات والجواب عليها.
وللمؤلف أن يقول: لستُ ملزمًا بمنهجية مَنْ سبقني، فلي منهجية بيّنتُها، وسِرتُ عليها، وهذا داخلٌ في التنوع الحاصل في عامة شروح المتون العلمية.
فالجواب أن يُقال: إنَّ كتاب التوحيد يختلف عن غيره من المتون، فإنَّه يكاد يكون المتن الشامل الوحيد في توحيد العبادة إذ لم يُنسج على منواله، ولم يُؤلف قبلُ مثله، وهذا ما يجعله مقصدًا لكلَّ من راغبٍ في دراسة التوحيد، من الصغار والكبار، والمبتدئين والمتوسطين، فتراهم يختارونه، ويطلبون شروحه، قبل البحث عن غيره من الكتب والمتون. فكان من المناسب أن يكون الشرحُ مقتصرًا على بيان التوحيد خاصة، وتوضيحه بأسهل عبارة، وأقوم تقسيم وتفريعٍ وتفصيل، على نحو ما سلكه العلماء فيه قديمًا وحديثًا، على اختلافهم في مستوى الشرح، فإنَّهم لم يُضمّنوه ما ضمَّنه مؤلف كتاب “المسلك الرشيد” من المسائل والنقولات والأبحاث، لأنَّ الأبحاث لها موضع آخر، ويمكن جمعها وإفرادها في مؤلف أو مؤلفات، والمؤلف نفسه قد ضمَّن شرحه كثيرًا من مباحث كتبه الأخرى ككتاب “تحقيق الإفادة في توضيح معنى العبادة”.
الثاني: طريقةُ المؤلف في إيراد مسائل الخلاف وعَرْضِها تختلف عن الطريقة المعهودة عند أهل العلم، فإنَّ كثيرًا من المسائل التي أوردها وأحسن في الردَّ عليها، هي شبهات أهل الشرك والوثنية والقبورية، لكنَّ طريقة عَرْضِهُ لها لا تُشعر بخطورة هذه الأقوال المخالفة وقُبحها ومناقضتها للتوحيد، فلا يستبين للقارئ حُكمُ الأخذِ بها واختيارِها، هل يستلزم شركًا أو كفرًا أو بدعةً؟ أم أنَّها من قبيل الأخطاء التي لا يُضلَّل صاحبها، أم أنَّها من المسائل التي يسوغ فيه الاختلاف. كما لا يستبين له أيضًا حالُ أصحاب هذه المقالات المردود عليها، هل هم من العلماء المعتبرين؟ أم مِن دعاة الشرك والضلالة المنحرفين؟ وهو حال أكثرهم.
فالخلاصة أنَّ المؤلف لا يصفُ تلك الأقوال المخالفة بما تستحقه من الحكم، ولا يصف أصحابَ تلك الشبهات الشركية بما يستحقونه من وصف الشرك والبدعة والضلالة.
ومن أمثلة ذلك:
نَقلُه نصوصًا كثيرة عن خصوم دعوة التوحيد، ودعاة الشرك والقبورية، مثل داود بن جرجيس، وأحمد زيني دحلان، وابن عفالق، والقضاعي، والقفي، وغيرهم من القبوريين والرافضة.
لكنَّه يعبِّر عنهم بقوله: (قرر بعض المتأخرين)، (وقد خالف بعض الناظرين)، (أطلق بعض المتأخرين القول)، (وقال بعض المعاصرين).
وقد ينقل عنهم بأسمائهم، فيقول على سبيل المثال: (قرر ابن جرجيس وغيره)، (يقول ابن عفالق).
ومعلومٌ أنَّ هذه الطريقة لا يتضح للقارئ منها حقيقة هؤلاء الملبِّسين، ولا يستبين له بها حكمُ القول الذي قرَّروه ودعوا إليه وخاصموا فيه واختاروه، مع أنَّ المؤلف قد بذل جهدًا عظيمًا في ردِّ شبهاتهم وتفنيدها بما لا مزيد عليه، لكنَّه لم ينصَّ على حُكم تلك المقالات ليكون القارئ على حذرٍ منها، فإنَّ عامة هذه المقالات توجب الكفر والردّة، مثلُ حصرِهم الشرك بالاعتقاد، وادِّعائهم أن لا شرك إلا باعتقاد الربوبية، ومثلُ تجويزهم الاستغاثة بالأموات والغائبين وسؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله، وتعليقُ الشرك فيها باعتقاد التأثير في المُستغاث به، وتَعَلُّلِهم بالإسناد العقلي، ومثل دعواهم أن الله أعطى لبعض الأولياء بعض صفات الربوبية، ونحو ذلك من المقالات التي أحسن المؤلف في ردِّها وإبطالها.
فكلُّ من لا يعرف حال هؤلاء الملبِّسين دعاة الشرك، وليس عنده من العلم ما يهتدي به إلى التمييز بين ما يستلزم الشرك والكفر من المقالات وما لا يستلزم، وما يُقبل فيه التأويل، وما لا يُقبل، قد يظن أنَّ هذه الأقوال وإن كانت خطأً وشبهة، لكنَّها لا تخرج عن الخلاف الذي يُخطَّأ صاحبه ولا يُكفَّر، وربّما اعتقدَ أنَّ القائلين يُعدَّون من العلماء المعتبرين، لا مِن دعاة الشرك والضلالة، ومِن خصوم التوحيد.
فكان الأولى بالمؤلف أن يعامل هذه المقالات معاملةَ العلماء لها، بوصفها بما تستحقه، والحكمِ على أهلها بما يليق بهم، كما جرت عادة العلماء في عَرْضِ هذه المسائل، وفي الردِّ على شبهات أهل الشرك، ولك أن تنظر إلى كتب الردود وطريقتهم في عَرض هذه المقالات، ككتاب “مصباح الظلام” و”منهاج التأسيس والتقديس” و”الرد على البكري” وغيرها كثير.
أو على أقل الأحوال أن يُعرِّف المؤلف بأصحاب هذه المقالات، ويترجم لهم في الحاشية، ليكون القارئ على بيّنة من أمرهم، وعلى علمٍ بحقيقتهم، ويعرف أنهم مِن دعاة الشرك والضلالة، لا مِن أهل العلم المجتهدين.
الثالث: أنَّ المؤلف عنده توسّعٌ في ذِكر احتمالات الأفعال التي ظاهرها الشرك، كالذبح، والنذر، وطلب الشفاعة من الميت، ومسائل أخرى، على غير الطريقة المعهودة عند العلماء في تقرير مثل هذه المسائل، فتراه يذكر أنَّ الذبح لغير الله نوعان، وهو محتملٌ لمعنيين، أحدهما شركٌ والآخر جائز، والنذرُ يحتمل معنيين، وطلبُ الشفاعة من الميت يحتمل كذا وكذا.
وبعض هذه الاحتمالات فيها تكلّف ظاهر، أو على الأقل تخالف حقيقة الحال والواقع، وكلُّ مَن يعرف حال من يُعظّمون القبور والأضرحة، وله اطلاع بواقعهم، يُدرك ذلك، وهذا التوسع في الاحتمالات يفتح الباب لأهل الشرك ليستندوا إلى هذه الاحتمالات في تبرير أفعالهم، فيقولون: نحن مقصدنا كذا وكذا، ليدفعوا عنهم إنكار أهل التوحيد عليهم، وقد وقع هذا من بعض دعاة الشرك في أيامنا هذه، فصاروا يحتجون بمثل هذه التبريرات.
الرابع: يبالغ المؤلف أحيانًا في مناقشة بعض الأقوال الأخرى في بعض مباحث الكتاب ومسائله، فتراه يُكثر مِن ذِكر دلائل القول الآخر، محاولًا استيعاب جميع أدلته، حتى لو كانت ظاهرة الضعف وبعيدة الدلالة، ويستطرد في ذكر الإيرادات والإشكالات على القول الذي يختاره، مما يضطره أحيانًا إلى الجواب بأجوبة غير مستقيمة قد تفتح بابًا لأهل الشرك والضلال ليُنفِذوا منها ضلالهم ويُبرروا شركهم.
من أمثلة ذلك استطراده في بحث مسألة سؤال الميت الدعاء والشفاعة.
الخامس: يُكثر المؤلف من الاستدراك على بعض التعاريف والتقاسيم والدلائل التي تتابع على ذِكرها والتسليم لها كثير من العلماء المتأخرين والمعاصرين، وبعضُها تعاريف وتقاسيم لبعض المحقِّقين كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وغيرهم.
منها على سبيل المثال لا الحصر: استدراكه تعريف ابن القيم للطاغوت، وتعريف السعدي للشرك الأصغر، ونفيُه أن يكون تعليق التمائم من غير القرآن والخرز والحجر شركًا أصغر، وادّعاؤه أنَّ التبرك بالأشجار والأحجار إذا لم يصاحبه أيُّ عمل من أعمال الشرك لا يكون شركًا أصغر، بل هو بدعة، واستدراكه على قاعدة: إن إثبات أسباب غير شرعية أو قدرية نوعٌ من الشرك الأصغر، وبعض المسائل في التبرّك، وغيره.
وليس المقصود مَنْعَ الاستدراك مطلقًا، ولا المطالبة بالتسليم لكلام العلماء وتعريفاتهم وضوابطهم بلا حجة ولا برهان، لكنّ المقصود أنَّ بعض هذه الاستدراكات فيها نوعٌ من التكلُّف، وليس في بعضها كبيرُ فائدة، وفي بعضها نظرٌ ظاهر كالاستدراك في مسألة أقسام وأنواع التوحيد، وادِّعائه جواز الزيادة في أقسام التوحيد حسب المصلحة.
السادس: وجود قصورٍ في بعض التعاريف، كتعريف الكفر بالطاغوت، فإنَّ المؤلف لم يذكر في معناه: تكفير المشركين، ومعاداتهم، مع أنه مِن صلب معناه، وداخلٌ في حقيقة البراءة من الشرك، كما في قوله تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ}، وفي قوله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}.
وقد أجمع العلماء على أنَّ من لم يُكفِّر المشركين فهو كافر، وتتابعوا على ذِكر هذه القاعدة في كتب الردّة.
وقال ابن القيم: (وما نجا من شَرَكِ هذا الشرك الأكبر إلا من جَرَّد توحيده لله، وعادى المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله).
وقال الإمام المصلح: (وأصله وقاعدته أمران: الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه، والإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله).
وفي تعريف مباحث تعريف العبادة، عرَّف المؤلف العبادة بالأعمال الباطنة والظاهرة النابعة من غاية الذل ونهاية الخضوع في القلب، وقد أحسن وأجاد وأفاد في الردِّ على من اشترط الربوبية فيها، في كتابيه “المسلك الرشيد” و”تحقيق الإفادة بمفهوم العبادة”، وأجاب بأجوبة محررة، لكنَّه لم يميّز بين الذلِّ الظاهر والباطن، فإنَّ العبادة منها ظاهر وباطن، ولا يستلزم وصف الشيء بأنه عبادة أن يجتمع فيه الظاهر والباطن، فكلُّ مَن تذلل لمخلوق وخضع له الخضوع الذي لا يكون إلا لله، فقد عبده، وخضوعه له عبادة، ذلَّ باطنه أو لم يذلّ.
والمؤلف لما ذكر أسباب عبادة المشركين للأصنام والأنداد والآلهة، وبيّن أنها لا تنحصر في اعتقاد الربوبية، وأبطل هذا القول، لم يُشر إلى بعض الأسباب المهمة، وهي مذكورة في القرآن، كالموافقة والموادة، وطلب السمعة والجاه، وهي أسبابٌ لا تتضمن اعتقادَ شيٍ مخصوصٍ في المعبود، لا ربوبية ولا شفاعة، ولا غير ذلك، وقد أشرتُ إلى هذا المعني في ردِّي على حاتم العوني وباحميد، ونقلتُ من تفاسير العلماء وأقوالهم ما يؤيد هذا، كما فصّل الشيخ عبد الحق التركماني هذه الأسباب في كتابه “حقيقة توحيد العبادة”.
الشاهد: أنَّ التذلل الظاهر للمخلوق والخضوع له بما لا يكون إلا لله فهو عبادة، لغة وشرعًا، ولو فَعَلَه لدنيا أو مالٍ من غير اعتقادٍ في المعبود، حتى لو كان مُبغضًا للمعبود في قلبه، وكارهًا له، ومتبرءًا منه باطنًا.
نعم، يصح تعريفُ المؤلف للعبادة إذا كان المقصود منه: كمال العبادة وتمامها وحقيقتها النافعة، وهو الوصفُ المطلوب من المؤمن في عبادة الله، أما حصرُ العبادة بما يتوافق فيه الظاهر والباطن، وأنَّ الأفعال التعبدية الظاهرة لا تكون عبادة -حسب تعريفه- إلا أن تكون نابعةً من الذل والخضوع القلبي، ففيه نظرٌ ظاهر، بل هو خطأ.
السابع: خطؤُه في بعض المسائل، منها مسألة إعذار المشركين المنتسبين إلى الإسلام، وامتناعُه من الحكم عليهم بالشرك مع تحقق الشرك فيهم. وقد أفرد المؤلف فيها رسالةً مستقلةً بعنوان “إشكالية العذر بالجهل في البحث العقدي”، بيّنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بعض أخطائه فيها.
لكن عذرُه أنه لم ينفرد في هذه المسألة، بل وافقه فيها وسبقه إليها بعض متأخري العلماء كالمعلمي والعثيمين وغيرهما، ومع ذلك فهي مسألةٌ مخالفةٌ لصريحِ الدلائل والقواعد، وإن أخطأ فيها مَن أخطأ من المتأخرين.
كما وقع له بعض الخلط واللبس في مسائل الدعاء والاستغاثة بالميت، وطلب الشفاعة منه، وفي الأحوال التي عدّها دالة على الشرك الأكبر في طلب الشفاعة من الميت، وفي مسألة التفريق بين دعاء العبادة والمسألة، ومسائل أخرى قد تكون أقل أهمية.
الخلاصة
الخلاصة أنَّ الكتاب قد حوى مباحث نفيسة جدًّا، وفيه تقريرٌ جيّدٌ لكثير من مسائل التوحيد، وردٌّ مستوعبٌ لشبهات أهل الشرك، وفيه مؤاخذات وأخطاء لا توجب التنفير منه جملةً، بل المناصحة والتنبيه.
لكنَّ الكتاب على ما هو عليه الآن في تقديري لا يصلح للمبتدئين، ولا المتوسطين، بل ينتفعُ به المتقدمون الذين درسوا التوحيد دراسة جيدة، واستوعبوا مسائله، وعرفوا الشرك وشبهاته، وقرأوا شروح كتاب التوحيد المعروفة ككتاب “فتح المجيد”، و”القول المفيد”، وغيرهما من الشروح المشهورة، واطلعوا أيضًا على كتب الردود المشهورة، مثل: “تلخيص الاستغاثة والرد على البكري” لابن تيمية، وردود أئمة الدعوة، ومن أحسنها: “مصباح الظلام” و”منهاج التأسيس والتقديس” لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وردود أبا بطين وابن سحمان وغيرهما.
وأما نصيحتي للمؤلف، فهي في أمور:
الأمر الأول: مراجعة بعض مباحث الكتاب ومواضع النقد فيه، ومدارسةُ العلماء الأكابر والمتخصصين فيها، وتنقيحُ بعض المناقشات في الكتاب، وحذفُ ما لا فائدة منه، وإغفالُ بعض الاستدراكات.
الأمر الثاني: إفرادُ بعض مباحث الكتاب في رسائل مستقلة ليعمَّ الانتفاع بها.
الأمر الثالث: تقسيمُ الكتاب بعد تنقيحه إلى كتابين: أحدهما مختصر يصلح للمبتدئ والمتوسط، والآخر مبسوطٌ للمتقدمين. بحيث يُكتب في غلاف الكتاب الأول: “للمبتدئين والمتوسطين”، وفي غلاف الثاني: “للمتقدمين”، أو نحو هذه العبارات.
هذا ما أحببت بيانه وتوضيحه، تصويبًا لحكمي السابق، وإبراءً للذمة، ونصحًا للمؤلف والقارئ، وقد بذلت جهدي في تحرِّي الإنصاف والعدل، وأسأل الله أن أكون وُفّقت في ذلك.
والله أعلم، وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
حُرّر في الكويت
١٠ ربيع أول ١٤٤٤هـ
٦ أكتوبر ٢٠٢٢م