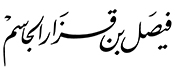الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،
فإن الناظر اليوم إلى الساحة الدعوية، سواء في الجانب العلمي أو العملي أو الإعلامي يلحظ تغيراً سريعاً يواكب ويزامن سمة هذا العصر، ألا وهي سرعة عجلة التغير والتطور المتنوع في كثير من المجالات، سواء الفكرية أو العلمية التكنلوجية، بل وحتى السياسية. ومظاهر هذا التغير الدعوي كثيرة متنوعة؛ ما بين ممدوح ومذموم.
ومما شهد تغيراً كبيراً ما يُعرف اليوم بـ «الأناشيد الإسلامية» – إن صحت تسميتها بذلك -، فالأنشودة العادية غير المتكلفة ذات الألحان السهلة العفوية التي كانت تُعرف من قبل صارت جماعية، ثم مرت بمراحل متنوعة حتى انتهت اليوم بشكل مغايرٍ في المخبر والمظهر عما كانت عليه من قبل، إذ دخل فيها التصوير، ومازجتها المؤثرات الصوتية بالتحسينات الحاسوبية التي تحاكي الآلات الموسيقية، إن لم تكن أبلغ منها، حتى إنه ليعسر أحياناً على أهل الخبرة التمييز بينهما فضلاً عن غيرهم، وصار كثير منها يحاكي في كثير من جوانبه الغناء إذ أصبحت تُنشد بألحانه وترنماته وآهاته، فدخل في تصويرها الفيديو كليب، بل وحتى النساء دخلن في تمثيل بعضها بشكل أو بآخر، وغدا الإنشاد اليوم حرفة ومهنة يمتهنها كثير من أربابها.
ولولا وجود لبسٍ عند بعض مريدي الخير من عامة الناس وخاصتهم، لما كتبت هذا المقال في حكم هذا النوع من الإنشاد لظهوره بأدنى تأمل لمن خَبَر أصول الشرع وقواعده، واطلع على واقع هذا النوع من الأناشيد وأثره على الفرد والمجتمع. إذ ظن بعضهم أن ما كان يفتي به بعض العلماء -لا كلهم-، قديماً وحديثاً، من جواز الأناشيد العادية غير المتكلفة عند أول ظهورها لا سيما عند الحاجة إليها، ظن هؤلاء أن هذا الحكم ينسحب أيضاً على ما انتهى إليه الحال بالأناشيد اليوم من الصورة التي سبق ذكرها.
وما انتشار هذه الأناشيد ورواجها بين الناس، وكثرة ظهورها وتنوعها في القنوات الفضائية، بل وظهور قنوات خاصة بها، إلا أثر من آثار هذا الظن الخاطىء.
ولذا، أحببت أن أبيَّن بشيء من الاختصار بعض الأوجه الدالة على حرمة هذا النوع من الأناشيد، وأن أذكر بعض مفاسدها المقتضية لهذا الحكم، كما أشير إلى أهم ما استدل به المجوزون لها مع الجواب عليها.
فأقول مستعيناً بالله: إن المحاذير الشرعية في الأناشيد العصرية المسماة بالإسلامية كثيرة، فمنها:
أولاً: أن فيها صداً عن ذكر الله – تعالى -، وإشغالاً عن السماع الشرعي المأمور به وهو سماع القرآن المحيي للقلوب، إذ أن تأثر القلوب بهذه الأناشيد وتعلقه بها أمر لا يجحده إلا مكابر، ومن المعلوم أن الشريعة قد رغبت في سماع القرآن وحثت عليه، وحرمت كل ما من شأنه الصدّ عنه.
قال – تعالى -: (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته)
قال ابن تيمية (الفتاوى 11/532): (قال الحسن بن عبد العزيز الحراني: سمعت الشافعي يقول: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن، وهذا من كمال معرفة الشافعي وعلمه بالدين، فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذّ بها حصل له نفور عن سماع القرآن والآيات فيستغني بسماع الشيطان عن سماع الرحمن. وقد صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن»، وقد فسره الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما بأنه من الصوت فيحسنه بصوته ويترنم به بدون التلحين المكروه….. إلى أن قال: والذين حضروا السماع المحدث الذي جعله الشافعي من إحداث الزنادقة لم يكونوا يجتمعون مع مردان ونسوان، ولا مع مصلصلات وشبابات، وكانت أشعارهم مزهدات مرققات) ا. هـ
والواقع يشهد بأن رواج أشرطة الأناشيد قد فاق رواج أشرطة القرآن، ويؤكد هذا اشتغال كثير ممن اشتهروا وعرفوا بقراءة القرآن بالإنشاد، حتى صار جل اهتمامهم واعتنائهم بإصدرات الأناشيد لا بالقرآن، فضلاً عمن لم يُعرف أصلاً إلا بالإنشاد مع قدرته على الاشتغال بالقرآن، ليس ذلك إلا لرواج سوق الأناشيد.
ثانياً: أن فيها تشبّهاً بأهل المجون والفسق أهل الغناء والطرب، وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم -:((ومن تشبه بقوم فهو منهم))، إذ أن الأناشيد العصرية تُلحّن وتُرنّم على ألحان الغناء سواء بسواء، وكثيرٌ من ألحانها من صنيع ملحني الغناء وهذا أمر معلوم، بل أصبحت تحاكي الغناء في التصوير والتمثيل كالفيديو كليب ونحو ذلك، الأمر الذي دفع بعض المطربين إلى عمل بعض الإصدارات الإنشادية، لما رأوا من رواج الأناشيد وأنها لا تختلف في حقيقتها عما يقومون به من الغناء والطرب في الألحان والتطريب.
ثالثاً: أن فيها تشبّهاً بأهل البدع في اتخاذهم القصائد الملحنة قربة وعبادة وطريقاً لتحريك القلوب، إن لم يكن هو عين فعلهم، إذ من الممتنع انفكاك اعتقاد كونها قُربة لا سيما عند المتدينين من المنشدين، فإن كثيراً منهم إنما مقصده وعظ الناس وتذكيرهم بالله في إنشاده، فتراه يستدل على جوازها بما فيها من نفع الناس وتذكيرهم، فكيف يمكن أن تنفك عنها نية التقرب لله – تعالى -بها، وإذا كان الأمر كذلك فهو عين فعل أهل البدع، فإن السلف لم يُعرف عنهم وعظ الناس بالأناشيد والقصائد الملحنة، وإنما كان وعظهم بالقرآن، وما يُعرف في القديم بالحداء ونحوه لم يكن المقصود منه الوعظ والتذكير وسيأتي الكلام عليه.
قال ابن الجوزي (تلبيس إبليس ص281): (سُئل الإمام أحمد عن استماع القصائد، فقال: أكرهه، هو بدعة ولا يجالسون).
رابعاً: أن فيها تشبهاً بالنصارى الذين يتخذون القصائد الملحنة والأناشيد الدينية ديناً يدينون به.
قال ابن تيمية (مجموع الفتاوى 22/522): (وأما ما ذكر من السماع: فالمشروع الذي تصلح به القلوب، ويكون وسيلتها إلى ربها بصلة ما بينه وبينها: هو سماع كتاب الله الذي هو سماع خيار هذه الأمة، لا سيما وقد قال: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»، وقال: «زينوا القرآن بأصواتكم» وهو السماع الممدوح في الكتاب والسنَّة. لكن لما نسي بعض الأمة حظاً من هذا السماع الذي ذُكّروا به ألقى بينهم العداوة والبغضاء فأحدث قوم سماع القصائد والتصفيق والغناء مضاهاة لما ذمه الله من المكاء والتصدية والمشابهة لما ابتدعه النصارى).
وقال أيضاً (مجموع الفتاوى 11/631): (كما أن النصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العبادة والطاعة لا على وجه اللهو واللعب).
خامساً: أن فيها من التطريب وحصول النشوة ما في الغناء، لا سيما مع ما يصاحبها غالباً من المؤثرات الصوتية التي تعمل في النفس عمل الآلات الموسيقية، بل قد يكون أبلغ منها أحياناً، ومن المعلوم أن تحريم الشريعة لآلات الطرب أمرٌ معقول المعنى، ليس أمراً تعبدياً لا يُعقل معناه، وهذا المعنى هو ما فيها من تحريك العواطف وحصول النشوة وإثارة الغرائز وإلهاء القلب عن ذكر الله وما يحصل من الطرب بها مما يخالف ما ينبغي أن يكون عليه القلب من العبودية لله – تعالى -والسكينة، وهذا عين ما تفعله الأناشيد لا سيما مع المؤثرات الصوتية المستخدمة في بعضها والتي تعمل عمل الآلات الموسيقية، إذ هي في السمع سواء، بحيث يعجز أهل الخبرة أحياناً عن معرفة ما إذا كانت هذه الأصوات صادرة عن آلة موسيقية أم طبيعية فضلاً عن غيرهم، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًَ. فإنه وإن كان أصل هذه المؤثرات الصوتية أصواتاً طبيعية، غير أن تلاعب المونتاج والأجهزة الحاسوبية بها أخرجها عن الطبيعية إلى المصطنعة، والعبرة بالمآلات والنتائج. وما حال من يجيز سماعها باعتبار أصلها إلا كحال من يجيز شرب الخمر باعتبار أصله وكونه من عنب مباح!
وعلى هذا فالأناشيد من هذه الجهة قد تكون أخطر من الغناء لكونها تدخل البيوت وتطرق مسامع الناس على أنها إسلامية مباحة، بخلاف الموسيقى التي يمتنع كثير من الناس عنها لحرمتها، ومن يسمعها منهم قد لا يخفى عليه غالباً حرمتها.
ويقال أيضاً: إذا كان كلام الله – تعالى -قد مُنع من قراءته بالألحان مع كونه أعظم الكلام وقعاً في النفوس وعظاً وتذكيراً وذلك لما لتأثير الألحان على النفوس بما يخالف العبودية والخشوع والسكينة، فلأن يُمنع ما كان من قبيل كلام البشر من باب أولى.
ولا يُقال بأن هذا خاص بالقرآن من جهة كونه كلام الله، إذ لو كان الأمر كذلك لمُنع أيضاً من ترتيله والتغني به، فلما أمر الشرع بالتغني به بل والنهي عن ترك ذلك كما في قوله – صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن» ونهى عن تلحينه، دل ذلك على أن المنهي عنه هو عين اللحن، إما لكونه تشبهاً بأهل المجون والفسق، وإما لما ينافيه اللحن مما ينبغي أن يكون عند سماع القرآن من الخشوع والسكينة والتدبر والتفكر، وهذا يدل على أن تلحين الأناشيد بألحان الغناء يعمل بها عمله بالقرآن.
قال ابن تيمية في رده على أبي القاسم القشيري (الاستقامة 1/243): (وأما قوله «فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم بأن تسمع بالألحان الطيبة، هذا ظاهر من الأمر» فإن هذه حجة فاسدة جداً، والظاهر إنما هو عكس ذلك، فإن نفس سماع الألحان مجرداً عن كلام يحتاج إلى أن تكون مباحة مع انفرادها، وهذا من أكبر مواقع النزاع، فإن أكثر المسلمين على خلاف ذلك… إلى أن قال: وهذا القرآن الذي هو كلام الله وقد ندب النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى تحسين الصوت به، وقال «زينوا القرآن بأصواتكم»…
ثم ساق الأدلة ثم قال: ومع هذا فلا يسوغ أن يُقرأ القرآن بألحان الغناء، ولا أن يُقرن به من الألحان ما يُقرن بالغناء من الآلات وغيرها) ا. هـ
سادساً: حصول الفتنة بهذه الأصوات الإنشادية الفاتنة والألحان الجميلة الجذابة، وهذا أمر معلوم لا ينكره إلا مكابر، بل الواقع يؤكد أن انتشار النشيد وذيوعه سببه في الغالب أمران: جمال الصوت، وجمال اللحن، وأما ما تحمله أبياته من معان فأبعد منهما في التأثير في النفوس، وإن شئت فانظر إلى أشهر المنشدين تراهم أجملهم صوتاً وأفضلهم ألحاناً.
قال ابن تيمية (الاستقامة 1/306): (ومن المعلوم أن استماع الأصوات يوجب حركة النفس بحسب ذلك الصوت الذي يوجب الحركة، وهو يوجب الحركة.
وللأصوات طبائع متنوعة تتنوع آثارها في النفس، وكذلك للكلام المسموع نظمه ونثره، فيجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة لهم…. إلى أن قال: وذلك أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثير يغنيها ويغذيها، حتى قيل إنه لذلك سمي غناء لأنه يغني النفس) ا. هـ
والفتنة بهذه الأصوات قد عظمت بدخول التصوير بنوعيه، فجمع النشيد المعاصر بين فتنة الغناء والألحان وفتنة الصور، فكم من امرأة فتنت، وكم من شهوة تحركت، والله المستعان.
سابعاً: أنها تؤول غالباً إلى التوسع والدخول فيما هو محرم نصاًّ كآلات اللهو ونحو ذلك، وإلى الاستكثار والاشتغال بها عما هو واجب، ومن المعلوم أن الشريعة قد جاءت بسدّ الذرائع ومنع الوسائل والطرق المؤدية إلى المحرمات، لا سيما إذا لم يكن فيها مصلحة محققة فضلاً عن أن تكون راجحة، فكيف إذا كان الغالب عليها المفسدة مع وجود ما يغني عنها.
ومن تأمل واقع الأناشيد والمنشدين يظهر له بشكل جلي حجم التطور الذي حصل فيها، وحجم التغير الذي طرأ على أهلها.
فتلحين المتون العلمية صار أنشودة فردية بسيطة ثم صارت الأنشودة الفردية جماعية، ثم دخل عليها الكورال ونحوه، ثم المؤثرات الصوتية التي لا تختلف عن الآلات الموسيقية، ثم صارت تصويرية، ثم دخل عليها التمثيل، ثم نظام الفيديو كليب، ثم دخل النساء، وهلم جرا. قليلها يدعو إلى كثيرها، ومباحها يدعو إلى حرامها، وهذا كله من خطوات الشيطان، وقد قال – تعالى -(لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر).
وهذا شأن البدع، فهي في زيادة ونمو مع الأيام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى 8/425): (فالبدع تكون في أولها شبراً، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعاً وأميالاً وفراسخ).
وقال ابن الجوزي (تلبيس إبليس ص274): (ولما يئس إبليس أن يسمع من المتعبدين شيئاً من الأصوات المحرمة كالعود نظر إلى المعنى الحاصل بالعود فدرجه في ضمن الغناء بغير العود وحسنه لهم، وإنما مراده التدريج من شيء إلى شيء، والفقيه من نظر في الأسباب والنتائج وتأمل المقاصد).
وقال الألباني (تحريم آلات الطرب ص181): (وإني لأذكر جيداً أنني لما كنت في دمشق -قبل هجرتي إلى هنا (عمان) بسنتين- أن بعض الشباب المسلم بدأ يتغنى ببعض الأناشيد السليمة المعنى قاصداً بذلك معارضة غناء الصوفية بمثل قصائد البوصيري وغيره، وسجّل ذلك في شريط، فلم يلبث إلا قليلاً حتى قرن معه الضرب على الدف، ثم استعملوه في أول الأمر في حفلات الأعراس على أساس أن الدف جائز فيها، ثم شاع الشريط واستنسخت منه نسخ، وانتشر استعماله في كثير من البيوت، وأخذوا يستمعون إليه ليلاً نهاراً، بمناسبة وبغير مناسبة، وصار ذلك سلواهم وهجيراهم، وما ذلك إلا من غلبة الهوى، والجهل بمكائد الشيطان، فصرفهم عن الاهتمام بالقرآن وسماعه فضلاً عن دراسته).
وأما المنشدين فحدّث ولا حرج عن حجم التأثر الذي طرأ على كثير منهم في الملبس والمظهر والمخبر وغير ذلك.
الجواب عما استدل به المجوّزون
وقد استدل بعض من يجوز الأناشيد بأمور:
منها: ما جاء في السنَّة من إنشاد حسان بن ثابت – رضي الله عنه – بين يدي النبي – صلى الله عليه وسلم -، وما حصل من إنشاد بعض الصحابة في غزوة خيبر وما كان يُفعل من الحداء ونحو ذلك.
وهذه الأدلة هي عين أدلة الصوفية في احتجاجهم على سماعهم المحدث وقصائدهم الملحنة، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وأجاب عنها بالتفصيل.
فقال عن احتجاجهم بإنشاد حسان وغيره (الاستقامة 1/286): (وهذا من القياس الفاسد،….، وقد تقدم أن الرخصة في الغناء في أوقات الفرح للنساء والصبيان أمر مضت به السنَّة، كما يُرخص لهم في غير ذلك من اللعب، ولكن لا يُجعل الخاص عاماً).
وقال عن احتجاجهم بالحداء (الاستقامة 1/282): (أما الحداء فقد ذُكر الاتفاق على جوازه، فلا يُحتج به في موارد). قلت: لعله يريد موارد النزاع.
ثم قال عن جملة ما يحتجون به (الاستقامة 1/289): (ومدار الحجج في هذا الباب ونحوه: إما على قياس فاسد، وتشبيه الشيء بما ليس مثله، وإما على جعل الخاص عاماً، وهو أيضاً من القياس الفاسد. وإما احتجاجهم بما ليس بحجة أصلاً).
وقد ذكر شيخ الإسلام قاعدة مفيدة فيما جاء في السنَّة من إنشاد الأشعار والحداء وغناء الجواري في الأفراح ونحو ذلك فقال (الاستقامة 1/277): (والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة، فهذا يُرخّص فيه للنفوس الضعيفة التي لا تصبر على ما ينفع. وهذا الحق في القدر الذي يُحتاج إليه: في الأوقات التي تقتضي ذلك: الأعياد، والأعراس، وقدوم الغائب، ونحو ذلك).
والفروق بين ما جاء في السنَّة من إنشاد الأشعار والحداء وبين الأناشيد المعاصرة اليوم ظاهرة بأدنى تأمل فمنها:
أولاً: أن الحداء ونحوه عفوي لا تكلف فيه، بخلاف الإنشاد الذي أصبح حرفة ومهنة لها أصول ودراسة ومقامات على نحو مقامات الغناء.
ثانياً: أن الحداء بسيط في ألحانه بخلاف الإنشاد الذي هو على ألحان الغناء، وفي كثير منها تكسر وميوعة.
ثالثاً: أن الحداء ونحوه إنما يكون في أحوال معيّنة تتطلب التيسير والتخفيف والترويح كالسفر أو العمل الجاد وتقوية النفس في الجهاد، ولأجل هذا رُخّص في بعض الأحوال ما لم يُرخص في غيرها، فرخّص في الجهاد مشية الاختيال ولبس الذهب وضرب الطبول ونحو ذلك مما فيه مصلحة: إما تقوية لعزائم المجاهدين أو تهوين لعزائم الكافرين. وأما الإنشاد المعاصر فإنه في كل وقت وعلى أي حال.
قال الشاطبي في بيان أوجه ما كان يحصل من الإنشاد بين يدي النبي – صلى الله عليه وسلم – (الاعتصام 2/112): (ومنها: أنهم ربما أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية تنشيطاً لكلال النفوس، وتنبيها للرواحل أن تنهض بأثقالها، وهذا حسن، لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم، بل كانوا ينشدون الشعر مطلقاً من غير أن يعتملوا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم، بل كانوا يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمّية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى، فلم يكن فيه إلذاذ، ولا إطراب يلهي، وإنما كان لهم فيه شيء من النشاط؛ كما كان أنجشة وعبد الله بن رواحة يحدوان بين يدي رسول الله، وكما كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق).
ونقل عن القرافي قوله (الاعتصام 2/116): (إن الماضين من الصدر الأول حجة على من بعدهم، ولم يكونوا يلحنون الأشعار، ولا ينغمونها بأحسن ما يكون من النغم، إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي. فإن كان صوت أحدهم أشجى من صاحبه كان ذلك مردوداً إلى أصل الخلقة لا يتصنعون ولا يتكلفون).
وقال الشيخ صالح الفوزان جواباً على هذه الشبهة (الخطب المنبرية 3/185): (إن الأشعار التي كانت تُنشد عند رسول الله ليست تُنشد بأصوات جماعية على شكل أغاني، ولا تُسمى أناشيد إسلامية، وإنما هي أشعار عربية، تشتمل على الحِكَم والأمثال، ووصف الشجاعة والكرم، وكان الصحابة ينشدونها أفرادًا لأجل ما فيها من هذه المعاني، ويُنشدون بعض الأشعار وقت العمل المتعب كالبناء، والسير في الليل في السفر، فيدل هذا على إباحة هذا النوع من إنشاد في مثل هذه الحالات خاصة، لا على أن يُتخذ فنًا من فنون التربية والدعوة، كما هو الواقع الآن؛ حيث يُلقّن الطلاب هذه الأناشيد، ويُقال عنها: أناشيد إسلامية، أو أناشيد دينية. هذا ابتداع في الدين، وهو من دين الصوفية المبتدعة؛ فهم الذين عُرف عنهم اتخاذ الأناشيد دينًا).
ومما استدلوا به أيضاً ما يزعمونه فيها من حصول النفع والتذكير، وهو أيضاً عين ما استدل به الصوفية على سماعهم المحدث.
وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن استدلالهم بذلك بأمرين:
الأول: أن فيه مخالفة لطريق السلف.
الثاني: بطلان هذه الدعوى من أصلها، وذلك بكون السماع يحرك الهوى ويثير الغرائز ويبعث على ما لا يحبه الله ورسوله، فيحصل منه نقيض المقصود منه.
فقال في الوجه الأول (الاستقامة 1/248): (الوجه الأول: أن نقول يجب أن يعرف أن المرجع في القرب والطاعات والديانات والمستحبات إلى الشريعة ليس لأحد أن يبتدع ديناً لم يأذن الله به ويقول هذا يحبه الله، بل بهذه الطريق بدل دين الله وشرائعه، وابتدع الشرك وما لم ينزل الله به سلطاناً… فكل من اتبع ذوقاً أو وجداً بغير هدى من الله، سواء كان ذلك عن حب أو بغض، فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه ديناً وينهى عما يبغضه ويذمه ويتخذ ذلك ديناً إلا بهدى من الله، وهو شريعة الله التي جعل عليها رسوله، ومن اتبع ما يهواه حباً وبغضاً بغير الشريعة فقد اتبع هواه بغير هدى من الله…. ولهذا كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء، ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء، ويذمونهم بذلك، ويأمرون بألا يغتر بهم ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام والحجاج أو العبادة والأحوال…. وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه يجب الاعتناء به، وذلك أن كثيراً من الأفعال قد يكون مباحاً في الشريعة أو مكروهاً أو متنازعاً في إباحته وكراهته، وربما كان محرماً أو متنازعاً في تحريمه، فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن مستحب، ودين وطريق يتقربون به، حتى يعدون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله، وربما جعلوا ذلك من لوازم طريقتهم إلى الله، أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله ويكون ذلك خطأً وضلالاً وابتداعَ دين لم يأذن به الله).
وقال في الوجه الثاني: (الوجه الثاني: أن قولهم إن هذا السماع يحصل محبوب الله، وما حصل محبوبه فهو محبوب له، قول باطل، وكثير من هؤلاء أو أكثرهم حصل لهم الضلال والغواية من هذه الجهة فظنوا أن السماع يثير محبة الله، ومحبة الله هي أصل الإيمان الذي هو عمل القلب وبكمالها يكمل…. فيقال: إن ما يهيجه هذا السماع المبتدع ونحوه من الحب وحركة القلب ليس هو الذي يحبه الله ورسوله، بل اشتماله على ما لا يحبه الله وعلى ما يبغضه أكثر من اشتماله على ما يحبه ولا يبغضه، وحدُّه عما يحبه الله ونهيه عن ذلك أعظم من تحريكه لما يحبه الله، وإن كان يثير حباً وحركةً ويظن أن ذلك يحبه الله، وأنه مما يحبه الله، فإنما ذلك من باب اتباع الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى).
ومن تأمل واقع الأناشيد الملحنة اليوم يجد أن صدها عن القرآن والذكر وإلهاءها للقلوب أعظم من حثها على مكارم الأخلاق أو استدعاءها محبة الله ونحو ذلك، فيتحصل بها نقيض المقصود منها، ناهيك عما تحركه من الهوى وتستحثه من مكامن النفوس بتلك الأصوات المطربة والألحان المثيرة، والآهات والترنمات.
واستدلوا أيضاً بأنها بديل عن الغناء والموسيقى، وأنه عوض للتائبين عن الغناء الذي اعتادوه، والذي أصبح اليوم واقعاً لا يمكن الفكاك منه في كثير من الأماكن.
ولا شك أن هذا كلام جاهل بما يصلح الله به أحوال الناس، وما يهدي الله به التائبين، فإن من اعتاد السماع الشيطاني سماع الألحان أُمِر بسماع النبيين والعالمين سماع القرآن، وهو الكتاب الذي هدى به الأولين وبه يهتدي الآخرين، لا بالطرق المبتدعة.
قال – تعالى -(قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم).
وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عمن سأله عن رجل أراد أن يُتوِّب العصاة ببعض أنواع السماع المبتدع، فقال في كلام طويل أذكر نتفاً منه (مجموع الفتاوى 6/620): (فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لا بد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنَّة، وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول – صلى الله عليه وسلم – لا يكفي في ذلك لكان دين الرسول ناقصاً محتاجاً تتمة…
إلى أن قال: إن الشيخ المذكور قصد أن يُتوِّب المجتمعين على الكبائر فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي، يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة، أو عاجز عنها، فإن الرسول – صلى الله عليه وسلم – الصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية. فلا يجوز أن يقال: إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه ما يتوب به العصاة، فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله – تعالى -من الأمم بالطرق الشرعية التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي…. وأمصار المسلمين وقراهم قديماً وحديثاً مملوءة ممن تاب إلى الله واتقاه وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية). في كلام نفيس طويل فليراجع.
واستدلوا أيضاً ببعض كلام لأهل العلم في الترخيص في الأناشيد كما هو منقول عن الشيخ ابن باز – رحمه الله -، ولا ريب أن أقل أحوال نسبة هذا القول للشيخ أن يكون من قبيل الخطأ البيّن؛ إذ أن الذي رخّص به الشيخ ابن باز – رحمه الله – من الأناشيد ليس هو المعمول به اليوم والذي فيه من الترنيم والتلحين ما يشابه ويحاكي تلحين أهل الغناء والمجون، فضلاً عما يُنشد على وقائع وتأثيرات المؤثرات الصوتية المشابهة لأصوات الآلات الموسيقية، أو يكون فتنة للناس إما لجمال الصوت أو الصورة فيما كان مصوراً.
ويؤكد هذا اتفاق أصحابه وتلاميذه من أمثال الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ وغيرهم، على الفتيا بحرمة هذه الأناشيد وهم الذين شاركوه في الفتوى التي أصدرتها اللجنة الدائمة.
فقد قال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ (مجلة البحوث الإسلامية 66/86): (إن ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، سمعنا بعضها، وللأسف الشديد وجدناها أناشيد على النغمات الموسيقية، مختار لها أرق الأصوات، وألطفها، وأحسنها جاذبة للقلوب، فيؤتى بها وكأنها الغناء، بل بعض الأصوات يفوق صوت الموسيقى، ونغمات الموسيقيين؛ لأنه يختار لها نوع خاص، ويعطى ذلك ثوب الإسلام، ودين الإسلام بريء من هذه الأمور، دين الإسلام فيه القوة والعزة، وهؤلاء يشتغلون بتلك الأناشيد عن كلام الله، وتصدهم تلك الأناشيد عن تلاوة القرآن، يتعلقون بها، وللأسف الشديد إنها قد تصحبها الطبول والدفوف، على نغمات يسمونها إسلامية، وهذا بلا شك خطأ، أرجو من إخواننا أن يتجنبوه، ويبتعدوا عنه).
وقال أيضاً (مجلة البحوث الإسلامية 59/95): (الأناشيد الإسلامية من الأمور المحدثة، وهي في الحقيقة صيغتها صيغة غناء، فهم يأتون بالأذكار على طريقة الأغاني غالباً، يختار لها أحسنهم صوتاً، وأطربهم صوتاً، فيلقي تلك الأذكار على هيئة تلحين خاص، وهي في الحقيقة من بقايا الصوفية).
وقال الشيخ صالح الفوزان (الخطب المنبرية 3/184): (وما ينبغي التنبيه عليه: ما كثُر تداوله بين الشباب المتدينين من أشرطة مسجل عليها أناشيد، بأصوات جماعية يسمونها الأناشيد الإسلامية، وهي نوع من الأغاني، وربما تكون بأصوات فاتنة، وتباع في معارض التسجيلات مع أشرطة تسجيل القرآن الكريم، والمحاضرات الدينية.
وتسمية هذه الأناشيد بأنها أناشيد إسلامية تسمية خاطئة؛ لأن الإسلام لم يشرع لنا الأناشيد، وإنما شرع لنا ذكر الله، وتلاوة القرآن، وتعلّم العلم النافع.
أما الأناشيد فهي من دين الصوفية المبتدعة، الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً، واتخاذ الأناشيد من الدين فيه تشبه بالنصارى، الذين جعلوا دينهم بالترانيم الجماعية والنغمات المطربة. فالواجب الحذر من هذه الأناشيد، ومنع بيعها وتداولها).
وقال الشيخ ابن عثيمين (اللقاء الشهري رقم 11): (الأناشيد الإسلامية كثر الكلام حولها، وأنا لم أستمع إليها إلا من مدة طويلة، وهي أول ما خرجت لا بأس بها، ليس فيها دفوف وتؤدى تأدية ليس فيها فتنة، وليست على نغمات الأغاني المحرمة، لكنها تطورت وصارت يسمع منها قرع يمكن أن يكون دفاً ويمكن أن يكون غير دف. ثم تطورت باختيار ذوي الأصوات الجميلة الفاتنة، ثم تطورت أيضاً إلى أنها تؤدى على صفة الأغاني المحرمة، لذلك: بقي في النفس منها شيء وقلق، ولا يمكن للإنسان أن يفتي بأنها جائزة على كل حال ولا بأنها ممنوعة على كل حال، لكن إن خلت من الأمور التي أشرنا إليها فهي جائزة، أما إذا كانت مصحوبة بدف، أو كانت مختاراً لها ذوو الأصوات الجميلة التي تفتن، أو أديت على نغمات الأغاني الهابطة، فإنه لا يجوز الاستماع لها).
وقال أيضاً في (اللقاء المفتوح 229/15): (الأناشيد الإسلامية تغيرت حسب ما نسمع، صار الآن يترنم فيها المنشد حتى تكون مثل الأغاني الماجنة.
ثانياً: فيها أصوات رخيمة جميلة تفتن، هذا بقطع النظر عن موضوعها، فلذلك لا نحكم عليها بحل ولا حرمة إلا بشيء معين نعرفه).
وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي (نقلاً من موقعه على الشبكة العنكبوتية): (أرى أن الأناشيد الإسلامية لا تجوز، ولا سيما الآن، الموجود في الساحة الآن؛ فإنها أناشيد مطربة، فيها تأوهات تشبه تأوهات الأغاني، فأنت لا تفرق بين الأناشيد وبين الغناء إذا سمعتها، حتى ولو كان المنشد واحداً، تجده ينشد ولكن يتأوه مثل تأوهات المغني، لا فرق، وحتى إن قيل لي: إن بعضهم جعل معه مزمارا، وبعضهم أيضًا أناشيد في المولد، هذا أعظم وأعظم -والعياذ بالله- فصارت فتنة.
والأناشيد الجماعية لو سلمت من التأوهات والمزمار وكذا فهي فيها مشابهة للصوفية الصوفية هم الذين يتعبدون بالأناشيد، ثم أيضًا الأناشيد الآن فيها طرب؛ لأن الذي يستمع للأناشيد حتى ولو كانت -يعني- مفيدة معانيها، ما يتأمل المعنى ولا يتدبر، إنما يتلذذ بالصوت، متى يرفع الصوت ومتى ينزلون الصوت، فقط، لا يتأمل المعنى.
لكن إذا كانت القصيدة مفيدة طيبة ينشدها واحد بصوت عادي، والباقي يستمعون، كما أن القارئ يقرأ القرآن واحد والباقي يستمعون، يقرأ حديث واحد والباقي يستمعون، ينشد القصيدة المفيدة إذا كان ما فيها غزل ولا هجاء، ولا لبس الحق بالباطل، وليس فيها محظور، فإنه ينشد واحد بصوت عادي غير ملحن، وليس فيه تأوهات ولا مزمار، ولا كذا، والباقي يستمعون.
أما جماعة يرفعون الصوت وينزلونه، هذه ولو كان معناها مفيداً وجيداً ما ينتبه للمعنى، إنما ينتبه للصوت ويتلذذ بالصوت، متى يرفعونه ومتى ينزلونه، وفيه مشابهة للصوفية فأنا أنصح الشباب بترك هذه الأناشيد، وإذا كانت القصيدة مفيدة يقرؤها واحد بصوت عادي، لا تأوهات ولا تلحين، والباقي يستمعون حتى يستفيدون).
وكلام العلماء السلفيين الذين يُرجع إليهم في الفتوى كثير في حكم الأناشيد، وهم ما بين مجيز للأناشيد العادية غير المتكلفة لبعض الأغراض المباحة، وما بين مانع مطلقاً، إلا أن الجميع -بحسب ما اطلعت عليه- متفقون على حرمة الأناشيد العصرية الملحنة تلحين الغناء على المقامات المعمول بها ذات الترنمات والآهات، أو التي تُنشد بالأصوات الجميلة الفاتنة، فضلاً عن التي تنشد على واقع المؤثرات الصوتية المحسّنة، أو تلك التي تُصوّر ويصحبها التمثيل ونحو ذلك مما عليه عامة الأناشيد العصرية.
ومن هؤلاء العلماء سوى من ذكرنا:
– الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (رسالة «تحريم آلات الطرب»)
– الشيخ حمود التويجري (رسالة «إقامة الدليل على المنع من الأناشيد الملحنة والتمثيل»)
– الشيخ عبد الله الجبرين (موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية)
– الشيخ بكر أبو زيد (تصحيح الدعاء/حاشية ص311)
– الشيخ عبد المحسن العباد (شرح سنن أبي داود)
– الشيخ عبد الرحمن البراك (موقع «نور الإسلام» على الشبكة العنكبوتية)
– الشيخ عبد الكريم الخضير (موقع «نور الإسلام» على الشبكة العنكبوتية)
هذا ما لزم بيانه فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله أعلم وصلىّ الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.