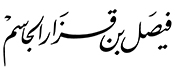الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فقد استوقفني بيان جديد للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق -عفا الله عنه- على نسق بيانه الأول عنونه بـ “رسالة إلى الأمة المصرية العظيمة في يوم من أيامها المجيدة” بتاريخ 4 شوال 1434هـ، يخاطب فيه الأمة المصرية بأطيافها، ويكرر دعوتها إلى الوقوف في وجه الانقلابيين -على حد وصفه-، ويؤكد فيه أن جهادهم يُعدُّ من أعظم القربات عند الله، بل ويرى أنه لو مات في سبيل إعادة الرئيس المصري المعزول مليون شهيد لم يكن كثيراً.
والحقيقة أنه لم يكن من نيتي الرد على بيانه هذا اكتفاءاً بالرد الأول لولا أنه ضمنه نصوصاً يستدل بها على ما ذهب إليه، كما أنه وصف مخالفيه بالأفاكين الكذابين على الله ورسوله، فكان من الواجب كشف زيف ما يستدل به لئلا يغتر به من يقف عليه، لا سيما وأن بيانه يدعو إلى فتنة عظيمة الله أعلم بعواقبها.
وقد جاء هذا الرد المختصر عبر هذه الوقفات:
الوقفة الأولى: أنكر الشيخ –عفا الله عنه- صحة ولاية من تغلّب على المسلمين وأخذ الحكم بالقوة والقهر، فقال: (ونأسف إذا خرج بعض الأفاكين الكذابين ليقول أن هذا عمل مشروع في الإسلام، وأنه إذا ما تم لمغتصب للسلطة أخذ الأمر وحيازة القوة فإنه يُصبح إماماً للمسلمين، وولي أمر واجب الطاعة، وأن القيام عليه يكون من عمل الخوارج المارقين، ونسبوا قولهم هذا إلى الكتاب والسنة والإجماع. ونقول أولاً لهؤلاء الكذابين الأفاكين: أين وجدتم هذا في القرآن والسنة، وعمل الصحابة أو التابعين، أو في قول عالم يُؤخذ بقوله في كل قرون الإسلام).
وأني أستغرب أشد الاستغراب من جرأة الشيخ على هذا الإنكار، وجزمه به، على الرغم من أن ثبوت الولاية بالتغلّب قد نقل غير واحد من العلماء الإجماع عليه، وجاءت فيها نصوص صحيحة، وعَمِل بها السلف قرناً بعد قرن.
من ذلك ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن تأمَّر عليكم عبد»، في أحاديث أخرى كثيرة.
وقوله: «تأمَّر»، أي: أخذ الأمارة بالقوة والغلبة.
وقد نص على ذلك جمع من الأئمة، منهم الشافعي كما في مناقب الشافعي للبيهقي، حيث قال: «كل من غلب على الخلافة بالسيف، حتى يُسمى خليفة، ويُجمع الناس عليه فهو خليفة».
وجاء مثله عن الإمام أحمد ويحيى بن يحيى وأبي حاتم وغيرهم.
ونقل غير واحد الإجماع على ذلك استناداً للنصوص الواردة، واحتجاجاً بعمل الصحابة والسلف، منهم ابن بطال كما في شرح البخاري حيث قال: (والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته واجبة، وأن طاعته خير من الخروج عليه).
بل ونصّ رحمه الله على وجوب طاعة الخوارج فيما لو تغلبوا على بلد من البلاد فقال: (وأهل السنّة مجمعون على أن المتغلّب يقوم مقام الإمام العدل في إقامة الحدود وجهاد العدو، وإقامة الجمعات والأعياد، وإنكاح من لا ولي لها، فكذلك الخوارج، لأنهم من أهل القبلة وشهادة التوحيد).
وممن نصّ على هذا الإجماع الحافظ ابن حجر كما في الفتح، والإمام محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية، وغير واحد من العلماء.
وعلى الرغم من ثبوت هذه النصوص وغيرها من الأقوال المستفيضة عن العلماء في هذا مما لم نذكره اختصاراً، فقد أنكر الشيخ عبد الرحمن -عفا الله عنه- هذه الحقيقة المجمع عليها، وادعى أن من قال بها فهو أفاك كذاب !!!!
وقد ادعى الشيخ –عفا الله عنه- أن سلف الأمة لم يُقرّوا إماماً بغير رضا ولا مشورة، فقال: (وأما سلف الأمة فلم يُقروا واحداً على أخذ الإمامة الكبرى بغير رضا ولا مشورة قط، بل قاموا بوجهه إنكاراً باللسان، وقتلاً بالسيف والسنان).
ولا يخفى على أدنى متأمل في الأحاديث والآثار أن عمل السلف كان على ما خلاف ما ذكره الشيخ عنهم، ما خلا أقواماً تأولوا فأخطئوا.
وقد ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عن السلف عبر القرون ما يدل على نقيض ما ذكره الشيخ عبد الرحمن عنهم، وذلك في معرض ذكر ما جرى على المسلمين من ولاية المتغلبين فقال: (وأوَّل ذلك: ولاية آل مروان، لم تصدر لا عن بيعة ولا عن رأي، ولا عن رضى من أهل العلم والدين، بل بالغلبة حتى صار على ابن الزبير ما صار، وانقاد لهم سائر أهل القرى والأمصار. وكذلك مبدأ الدولة العباسية، ومخرجها من خراسان، وزعيمها رجل فارسي، يدعى أبا مسلم، صال على من يليه، ودعا إلى الدولة العباسية، وشهر السيف وقتل من امتنع عن ذلك، وقاتل عليه، وقتل ابن هبيرة أمير العراق، وقتل خلقاً كثيراً لا يحصيهم إلا الله، وظهرت الرايات السود العباسية، وجاسوا خلال الديار قتلاً ونهباً في أواخر القرن الأول؛ وشاهد ذلك أهل القرن الثاني، والثالث، من أهل العلم والدين، وأئمة الإسلام، كما لا يخفى على من شم رائحة العلم، وصار على نصيب من معرفة التاريخ وأيام الناس. وأهل العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلَّب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف، وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة ظلمة فسقة، ما لم يروا كفرا بواحاً، ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم، وأمثالهم ونظرائهم). [الدرر السنية 9/28]
وقال في موضع آخر مؤكداً الإجماع على عدم جواز الخروج على المتغلِّب، فقال: (ولم يَقُل أحد منهم بجواز قتال المتغلِّب والخروج عليه، وترك الأمة تموج في دمائها، وتستبيح الأموال والحرمات). [الدرر السنية 9/20]
وأما اتهام الشيخ معارضيه بكونهم يزعمون أن ولاية التغلَّب مشروعة -بمعنى أنها جائزة-، فإني لا أعرف قائلاً بمشروعية الخروج على الأئمة وأخذ الحكم بالقوة والغلبة، كيف والنصوص صريحة في النهي عن ذلك، بل ولاية التغلّب عند العلماء هي من باب الضرورة لا الاختيار.
الوقفة الثانية: استدل الشيخ –عفا الله عنه- على وجوب قتال المتغلّب حتى توضع الإمامة في مكانها -كما يزعم- بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه«.
وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» رواهما مسلم.
والحديثان ليس فيهما دلالة على ما ذهب إليه، بل هما دليل عليه لا له من أوجه كثيرة:
منها: أن هذه الأحاديث محمولة على الخوارج الذين يريدون شق صف المسلمين المجتمعين، وليست في الطائفتين الكبيرتين المتنازعتين مع عدم اجتماع كلمة الناس على أحدهما، فضلاً عن الاستدلال بهذه الأحاديث على القيام على الطائفة الغالبة التي بيدها زمام الأمور، ومفاصل القوة بأسرها كالجيش والشرطة.
وألفاظ الأحاديث نصٌّ في هذا، إذ فيها: «وأمركم جميع»، وفي الحديث الآخر الذي رواه مسلم: «فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان«.
قال القرطبي في شرحه على مسلم: (أي : مجتمعة على إمام واحد).
وقال النووي في شرحه على مسلم: (فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين).
وقال ابن الجوزي في شرح المشكل: (إذا استقر أمر الخليفة وانعقد الإجماع عليه فبويع لآخر بنوع تأويل كان باغياً وكان أنصاره بغاة)
فالأحاديث إذاً فيمن خرج على إمام قد اجتمع الناس عليه، وليست فيمن خرج على إمام قد تنازع الناس فيه إذ قد يترتب على الانتصار له حينئذٍ فتنة، فضلاً عن الاستدلال بها في الخروج على من غلب واستقر له الأمر.
ومثله يقال في استدلال الشيخ بقول عمر رضي الله عنه: « فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه«.
ومنها: أن الحكمة من الأمر بقتل الخليفة الخارج على الإمام المجمع عليه هي درء الفتنة باختلاف الكلمة، وتفرق الصف، وتنازع المسلمين.
ولذلك قال ابن القيم كما في إغاثة اللهفان: (وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» سداً لذريعة الفتنة والفُرقة).
ولا ريب أن الدعوة إلى الخروج والثورة على من تغلّب -لا سيما وقد تغلّب بإرادة أمة من الناس قد لا تقل عن أنصار الرئيس المخلوع- هو عين الفتنة والفُرقة التي جاء الحديث لدرئها وسدّ ذرائعها، فالحديث دليلٌ على الشيخ لا له.
ومنها: أن من تأمل ألفاظ الأحاديث التي استدل بها الشيخ والتي جاءت في وصف هذا الخارج الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، والتي منها وصفه في حديث بالخليفة الثاني، وفي حديث بمن أراد أن يفرق كلمة المسلمين ويشق عصاهم، يجدها ظاهرة في أن هذا الخارج ليس له قوة ظاهرة ولا منعة، ولذلك جاء الأمر بقتله بقوله: «اقتلوه»، وبقوله: «اضربوه بالسيف»، ولم يقل «قاتلوه»، مما يُشعر بأن هذا الخارج كالمقدور عليه، بحيث لا يعسر التغلب عليه وقتله، وليس هو ممن قد يقع في محاولة التمكن منه فتنة عظيمة، فالحديث إذاً ليس فيمن خرج على الإمام وله قوة ومنعة ظاهرة، أو غالبة على خصمه، أو الذي لا يمكن دفعه إلا بقتال وفتنة عظيمة، فضلاً عمن غلب أصلاً وتمكن من مفاصل الدولة ومعاقد القوة، بل الحديث جاء فيمن لا يترتب على قتله ودرء انشقاقه فتنة كبيرة، ولا يحصل بذلك اختلاف وفُرقة، بل تنقطع الفتنة بقتله وتجتمع الكلمة بذلك.
الوقفة الثالثة: استدل الشيخ عبد الرحمن -عفا الله عنه- بحوادث من التاريخ، منها ما وَهِم فيها، ومنها ما ليس فيها حجة، بل الحجة على خلافها.
من ذلك: أنه أوهم أن ابن عمر رضي الله عنه لم يبايع يزيد بن معاوية، مستدلاً بما ذكره ابن عمر لمعاوية رضي الله عنهما عندما أراد أن يعهد بالخلافة لابنه يزيد من بعده، وهذا الذي ذكره الشيخ خلاف الصواب، فإن موقف ابن عمر رضي الله عنه من بيعة يزيد دليلٌ على الشيخ لا له، فإنه لما آلت الخلافة ليزيد، ورام أهل المدينة خلع بيعته أنكر عليهم ابن عمر رضي الله عنه إنكاراً شديداً، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن نافع قال: (لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة»، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يُبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه).
فموقف ابن عمر دليلٌ على الشيخ لا له.
ومن ذلك: أن الشيخ زعم أن أهل مكة خرجوا عن بيعة يزيد وبايعوا عبد الله بن الزبير، وهذا خلاف الصواب، فإن أهل مكة لم يخلعوا بيعة يزيد، وإنما بايعوا ابن الزبير رضي الله عنه بعد موت يزيد واستخلاف ابنه معاوية الذي لم بقي أياماً ثم مات ولم يستخلف، كيف وابن الزبير كان ممن نصح الحسين رضي الله عنه بعدم الذهاب إلى العراق والخروج على يزيد.
ومن ذلك: أن الشيخ -عفا الله عنه- احتج بذهاب طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم إلى العراق لمطالبة علي رضي الله عنه بدم قتلة عثمان، ومثله أيضاً استدلاله بمطالبة معاوية رضي الله عنه علياً بدم قتلة عثمان ومنازعته بسبب ذلك، حتى قال الشيخ بعد ذكره لهذه الوقائع: (والشاهد من كل ذلك، أن أهل الإسلام لم يستكينوا أو يستسلموا لمن وثب على الحكم وقتل خليفتهم).
ولا أدري كيف يستجيز الشيخ الاحتجاج بمثل هذه الوقائع التي اتفق العلماء أنها كانت فتنة، والتي ندم كل من دخل فيها، وقد جرى بسببها ويلات عظيمة على المسلمين، بل والتي قد جاءت الأحاديث في تخطئة فاعليها، أو على أقل تقدير عدم مدح فعلهم، على الرغم من كونهم كانوا متأولين مأجورين على اجتهادهم، من ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره عن قيس قال: (لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلاً نبحت الكلاب، قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب، قالت: ما أظنني إلا أني راجعة، فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز و جل ذات بينهم، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم: «كيف بأحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب».).
ففيه أن خروجها رضي الله عنها لم يكن محبوباً ولا ممدوحاً، ولذلك جرت بسببه فتنة عظيمة.
ومن النصوص أيضاً وصف النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة علي رضي الله عنه بأنها أقرب إلى الحق من طائفة معاوية، كما في حديث: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق»، فكانت المارقة هي الخوارج، والتي قتلتها طائفة علي رضي الله عنه.
ومن النصوص أيضاً مدح النبي صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه بسبب تنازله عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، كما في قوله: «إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين«.
قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: (فأصلح الله به بين شيعة علي وشيعة معاوية، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بهذا الصلح الذي كان على يديه، وسماه سيداً بذلك؛ لأجل أن ما فعله الحسن يحبه الله ورسوله، ويرضاه الله ورسوله، ولو كان الاقتتال الذي حصل بين المسلمين هو الذي أمر الله به ورسوله لم يكن الأمر كذلك؛ بل يكون الحسن قد ترك الواجب، أو الأحب إلى الله، وهذا النص الصحيح الصريح يبين أن ما فعله الحسن محمود، مرضي لله ورسوله).
فكيف يستدل الشيخ –عفا الله عنه- بخلاف المحبوب لله ولرسوله !!!!
ومن ذلك: احتجاج الشيخ بخروج الحسين رضي الله عنه إلى العراق لنزع سلطان يزيد.
ولا يكاد ينقضي عجبي من احتجاج الشيخ بمثل هذه الحوادث التي هي عليه لا له، وذلك من أوجه كثيرة:
منها: أن الحسين رضي الله عنه لم يوافقه عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة على هذا الأمر، منهم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم رضي الله عنهم.
ومنها: أن الحسين رضي الله عنه لم يمض فيما خرج له، بل إنه عزم على مبايعة يزيد وكان ذلك من ضمن ما عرضه على أهل الكوفة.
قال ابن تيمية في المنهاج: (وكذلك الحسين رضي الله عنه لم يقتل إلا مظلوماً شهيداً تاركاً لطلب الإمارة طالباً للرجوع إما إلى بلده، أو إلى الثغر، أو إلى المتولي على الناس يزيد).
فإذا كان الحسين رضي الله عنه قد عزم على مبايعة يزيد وتَرْكِ منازعته له، كيف يستجيز الشيخ الاحتجاج بما رجع عنه الحسين رضي الله عنه وتركه ؟؟؟
ومنها: أن النصوص صريحة في وجوب السمع والطاعة لمن تأمّر علينا، ولا قول لأحد مع النص كائناً من كان.
الوقفة الرابعة: لقد استمات الشيخ -عفا الله عنه- في الدفاع عن ولاية من تولى عن طريق الانتخابات، في الوقت الذي أنكر فيه بشدة ولاية التغلّب، على الرغم من إجماع العلماء على ثبوت الولاية بالتغلب، في حين لم يذكروا الأخرى في طرق الولاية المعتبرة، لكونها من هدي المشركين لا المسلمين، ولا ريب أن استماتته في الدفاع عن هذا النوع من الولاية إقرارٌ بهذه الطريقة التي قد تُخرج من ليس أهلاً للولاية، بل قد تُخرج من ليس مسلماً، وهذا مسألة لها بحث آخر.
الوقفة الخامسة: شكر الشيخ صنيع من انتفض من المصريين لرفض من أراد إبطال دستوره الذي ارتضاه، على الرغم من علم الشيخ بأن هذا الدستور، والذي يرى الشيخ أن من قُتل في سبيل إرجاع التحاكم إليه يموت شهيداً، قد احتوى على قوانين وضعية مخالفة للشريعة، وقد أعياني التماس تأويلٍ للشيخ في هذا، لعلمي بأن الشيخ قد قضى عمره في إنكار التحاكم إلى القوانين الوضعية، بل وتكفير من تحاكم إليها، حتى ابتدع قسماً جديداً في التوحيد سماه “توحيد الحاكمية” حتى جرت بسبب آرائه المخالفة للنصوص ولأقوال العلماء فتنٌ وشرور.
هذا ما تيسر بيانه، والله نسأل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبساً علينا فنضل.
والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.