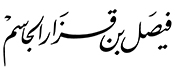مفهوم الوسطية
قد جاء وصف الله تعالى للأمة بأنها وسط في قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) البقرة 143.
وفسَّر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوسطية بالعدالة، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت؟. فيقول: نعم أي رب، فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلَّغ، وهو قوله جل ذكره (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) والوسط العدل».
ورواه الطبري بلفظ: «عدولاً».
وهذا التفسير منقولٌ عن كثير من الصحابة والتابعين.
قال الطبري في تفسيره: (وأما الوسط فإنه في كلام العرب الخيار، يقال منه: فلان وسط الحسب في قومه، أي: متوسط الحسب إذا أرادوا بذلك الرفع في حسبه، وهو وسط في قومه وواسط،….،
إلى أن قال: وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين، مثل وسط الدار، مُحرَّك الوسط مثقله غير جائز في سينه التخفيف، وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم فى الدين، فلا هم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالترهب وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه، ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله، وقتلوا أنبياءهم، وكذبوا على ربهم، وكفروا به، ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها، وأما التأويل فإنه جاء بأن الوسط العدل وذلك معنى الخيار لأن الخيار من الناس عدولهم).
وبالنظر إلى ما جاء في السنَّة وما أُثر عن السلف وما حكاه أهل التفسير، نجد أن «وسطية الأمة» تٌفسَّر بمعنيين:
الأول: العدالة والخيرية.
الثاني: الاعتدال والتوسط في الأمور بين الغلو والجفاء، وبين التفريط والإفراط.
وهذان المعنيان متداخلان، فإن الأمة الإسلامية هي خير الأمم وأفضلها وأعدلها، وذلك لاعتدالها وتوسطها في عقائدها وشرائعها، ولأجل استحقوا أن يكونوا شهداء على الأمم، إذ الشهادة مبناها على العدالة، وهم أعدل الناس وأفضلهم.
تحرير معنى «الوسطية»
إن المتأمل في أقوال السلف وكلام أهل العلم واصطلاحاتهم يجد أن مصطلح «الوسطية» بهذا الإطار الذي هو شائعٌ اليوم لم يكن معروفاً بين السلف والعلماء، إذ لا يكاد يوجد له ذكر بهذا الاسم، في حين أننا نجد أن كثيراً من العلماء يستدل بوصف الله عز وجل للأمة بكونها وسطاً في أبواب وجوب الاتباع ونبذ الابتداع، وفي بيان وجوب التمسك بالسنَّة وهدي سلف الأمة، وفي بيان وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم، ووصفهم بالعدالة والخيرية الموجبة لاتباعهم والاقتداء بهم، والتمسك بآثارهم.
فقد بوَّب البخاري على ذلك فقال في صحيحه: (باب قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً) وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم.
حدثنا إسحق بن منصور حدثنا أبو أسامة حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب، فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير، فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته، فيجاء بكم فتشهدون، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ).)
وذكر البخاري هذا الحديث أيضاً في كتابه «خلق أفعال العباد» ثم قال: (قال أبو عبد الله: هم الطائفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم»).
فتراه يستدل بوسطية الأمة على وجوب لزوم السنَّة والجماعة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (فتاوى 3/375) في تفضيل طريق أهل السنَّة والجماعة: (وكذلك في سائر أبواب السنَّة هم وسط، لأنه متمسكون بكتاب الله وسنَّة رسوله وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان).
وقال (الفتاوى 5/261): (وقد قال تعالى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً)، والسنَّة فى الاسلام كالإسلام فى الملل).
وقال ابن القيم في سياق الأوجه الدالة على وجوب اتباع الصحابة وعدم الخروج عن أقاويلهم (إعلام الموقعين 4/132): (الوجه التاسع: قوله تعالى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ).
ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خياراً عدولاً، هذا حقيقة الوسط، فهم -أي الصحابة- خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداؤه، ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم و أثنى عليهم لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء، وأمر ملائكته أن تصلى عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم).
ومعلوم أن هذه الآية إنما نزلت على الصحابة رضي الله عنهم، فهم المخاطبون بها أصالة، ومن سار على طريقهم تبعاً، فدل على أن الوسطية التي وصفت بها الأمة إنما هي اتباع السنَّة وطريق الصحابة رضي الله عنهم.
قال ابن حجر الهيتمي (الصواعق المحرقة 2/604): (ومنها قوله تعالى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ)، والصحابة في هذه الآية والتي قبلها هم المشافهون بهذا الخطاب على لسان رسول الله حقيقة، فانظر إلى كونه تعالى خلقهم عدولاً وخياراً ليكونوا شهداء على بقية الأمم يوم القيامة).
ومما لا شك فيه أن الصحابة رضي الله عنهم هم أهدى الناس، وهم أعلم الناس بدين الله تعالى الموصوف بكونه وسطاً، إذ هم الذين أمر الله بالاقتداء بهم واتباعهم.
قال تعالى: (وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [التوبة100].
وقال تعالى: (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً) [النساء115].
قال ابن قدامة في كتابه «ذم التأويل» في بيان وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم (ص28): (الباب الثاني: في بيان وجوب اتباعهم والحث على لزوم مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من الكتاب والسنَّة وأقوال الأئمة.
وأما الكتاب فقول الله تعالى ((وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً ).
فتوعَّد على اتباع غير سبيلهم بعذاب جهنم، ووعد متبعهم بالرضوان والجنة فقال تعالى: ((وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ).
فوعد المتبعين لهم بإحسان بما وعدهم به من رضوانه وجنته والفوز العظيم.
ومن السنَّة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة».
فأمر بالتمسك بسنَّة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته، وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة، وهو ما لم يتبع فيه سنَّة رسول الله ولا سنَّة أصحابه.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. إن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة ويزيدون عليها ملة، وفي رواية وأمتي ثلاثاً وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله من الواحدة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية: الذي أنا عليه وأصحابي».
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه هو وأصحابه، فمتبعهم إذاً يكون من الفرقة الناجية لأنه على ما هم عليه، ومخالفهم من الاثنتين والسبعين التي في النار).
ثم ذكر رحمه الله آثاراً كثيرة في وجوب اتباع طريق السلف والصحابة.
إذا عُلم هذا، صار أقرب المصطلحات المرادفة لمصطلح «الوسطية» المعاصر عند السلف والأئمة، وهو الذي يذكرونه لبيان وجوب الاعتدال والتوسط هو مصطلح «السنَّة».
ولا يُراد بمصطلح «السنَّة» هنا المعني الفقهي أو الأصولي، وإنما المراد به الطريقة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل والدعوة، وهو الذي يُذكر في باب الاعتقاد والاتباع، وهو المعني بقول السلف «فلان على السنَّة»، ومنه الكتب المؤلفة في هذا الباب مثل كتاب «السنَّة» لعبد الله بن الإمام أحمد ولابن أبي عاصم وللخلال وللمروزي، وغيرهم.
ومما يدل على ذلك: أمرُ النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته عند وجود طرفي الوسط كالغلو أو الجفاء.
ومنه ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله أني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني».
فانظر كيف قابل غلو هؤلاء وزيادتهم في العبادة على الحد المطلوب، بذكر سنته القائمة على التوسط والاعتدال.
ومنه أيضاً ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: «صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت لها الأعين، ووجلت منها القلوب. قلنا أو قالوا: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة».
وهذه المحدثات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون في الزيادة على المشروع فتكون غلواً وإفراطاً، وإما بترك بعض المشروع فيكون جفاءاً وتفريطاً، والحق بين هذين، وهو التوسط والاعتدال الذي هو سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم وسنَّة خلفاءه من بعده وهم الصحابة رضوان الله عليهم.
وعلى هذا فالوسطي: هو المتمسك بالسنَّة وآثار السلف، وهو الأمر الذي صلح عليه أول هذه الأمة، ولا يصلح آخرها إلا به.
قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه ابن عبد البر في الجامع (باب ما تكره فيه المناظرة والمجادلة): (من كان منكم متأسياً فيتأسَّ بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، وأقومها هدياً، وأحسنها حالاً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم).
وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً فيما رواه الدارمي وغيره: (ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق).
وقال الإمام مالك كما في «العتبية» («المدخل» لابن الحاج/فصل زيارة سيد الأولين والآخرين): (ولن يأتي آخر هذه الأمه بأهدى مما كان عليه أولها).
وقال أيضاً («الشفا» للقاضي عياض 2/71): (ولا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلحَ أولها).
فالسنَّة وهدي السلف هو الطريق الموصل إلى رضوان الله، وهو الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح الأمة في كل زمان ومكان، لأنه الطريق الوسط، فهو أعدل الطرق وأفضلها وأقربها إلى الله، لأنه سلم من الانحراف، وكان بين الغلو والجفاء، وبين الإفراط والتفريط، ولذلك كان السلف والأئمة يوصون دوماً بالتمسك بالسنَّة واقتفاء آثار السلف، ويحذرون من مخالفتهم.
والانحراف عن وسطية الأمة واعتدالها لم يظهر إلا لمخالفة طريق السنَّة وهدي السلف، فظهر الغلو من جانب، والجفاء من جانب، وكلا طرفي الأمر ذميم.
ولذلك قال بعض السلف تلك الكلمة المشهورة وهي: (دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه).
ولما ظهر الانحراف عن الوسطية والاعتدال من أهل الغلو والجفاء، أنكر عليهم السلف، وأمروهم بلزوم السنَّة وطريق الصحابة الأولين، وقالوا في بيان مخالفتهم للصواب وانحرافهم عن طريق الحق: «هذا خلاف السنَّة»، أو «هذا خلاف طريق السلف».
فمن ذلك ما ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: (قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه.
فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يداً من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وقال: ليس هذا صواب، هذا خلاف الآثار).
وهكذا كان الأئمة ينكرون على من خرج عن طريق الوسطية والاعتدال بكونه خلاف السنَّة والآثار السلفية.
وهذا يؤكد بأن مصطلح «السنَّة» عند الأولين هو أقرب مرادف لمصطلح «الوسطية» المعاصر. وهذا يدلنا على جواب سؤال مهم وهو:
من يحدد المنهج الوسط؟ وما هو ميزان الوسطية التي توزن به الأقوال والآراء والأفعال؟
قد تباينت الآراء حول «الوسطية» وتحديدها، واضطرب الناس في الميزان الذي توزن به الآراء والأفعال: أيٌّ منها يُعد من «الوسطية»، وأيٌّ منها خارجٌ عن «الوسطية».
فلقد خاض كثيرٌ من الناس في «الوسطية» واستعملوها بلا ضوابط شرعية، حتى صارت الوسطية تبعاً لآرائهم واختياراتهم من غير ميزان يزنها، ولا ضابط يضبطها، ولا مفهومٍ يحددها، حتى آل الأمر ببعضهم إلى نبذ مسلمات من الدين باسم «الوسطية».
ومعلوم أن وصف الله تعالى لهذه الأمة بأنها وسطٌ، هو وصف عام للشريعة، فالوسطية سمة لكل الشريعة بكافة جوانبها: الاعتقادية منها والعملية. فهي وسط في العقيدة، كما أنها وسط في الشريعة.
وإذ كنا قد بينا بأن مصطلح «السنَّة» عند السلف هو أقرب مرادف لمصطلح «الوسطية»، صارت «السنَّة» وما كان عليه السلف من العلم والعمل هو الميزان الذي توزن به الأمور، ويُعرف به الوسطي من الأقوال والأفعال، مما ليس بوسطي. فما وافق السنَّة وطريق السلف الصالح من الأقوال والأفعال كان من الوسطية، وما خالفها فليس من الوسطية. وبهذا نضبط «الوسطية» ونحدد مفهومها تحديداً يُعرف به ما هو منها مما ليس منها.
وعلى هذا فشعار الوسطية الحقَّة ينبغي أن يكون:
(ما وَسِعَ السلف من الأقوال والأفعال وَسِعَنا، وما لم يَسَعْهم لم يَسَعْنا)
قال الأوزاعي: (اصبر نفسك على السنَّة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، ولو كان هذا -يعني ما حدث من البدع- خيراً ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يُدَّخر عنهم خيرٌ خُبِّئَ لكم دونهم لفضلٍ عندكم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختارهم الله لصحبة نبيه، وبعثه فيهم ووصفهم به فقال: (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً)). [رواه أبو نعيم في الحلية (6/143) واللالكائي (1/154)]
وروى أبو داود أن رجلاً كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر. فكتب إليه: (أما بعد، أوصيك بتقوى الله، والاقتصاد في أمره، واتباع سنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته، وكُفوا مؤونته، فعليك بلزوم السنَّة فإنها لك بإذن الله عصمة، ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنَّة إنما سنَّها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصرٍ نافذٍ كَفُّوا، وَلَهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم، ورغب بنفسه عنهم، فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مَقْصَر، وما فوقهم من مَحْسَر، وقد قَصَر قوم دونهم فجفوا، وطَمَح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم).
وقوله: (عليك بالاقتصاد في أمره) أي التوسط بين الإفراط والتفريط.
فتأمل وصيتهما بلزوم السنَّة، وعدم الخروج عن أقاويل السلف، وترك القول فيما لم يخض فيه السلف، ولزوم طريقتهم فيما وقفوا فيه وفيما كشفوه، وأن المخالف لهم في ذلك مبتدع ضال عن سواء السبيل.
ولنضرب لذلك أمثلة يتضح به المقال:
فمن ذلك أن الصحابة والسلف الكرام قد اتفقت كلمتهم في ما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنَّة من وجوب إقرارها والإيمان بها كما جاءت من غير تَعرُّضٍ لها بتعطيل أو تحريف، ولا تكييف ولا تمثيل، لم تختلف كلمتهم في ذلك. وأنكر السلف على من تعرَّض لها بشيء من ذلك واشتد نكيرهم على الفرق التي خاضت فيه، وهذا أمرٌ معلوم لمن له أدنى اطلاع على كتب السنَّة، مما يعني أن السلف لم يسعهم الخلاف في هذا الباب ولا الخوض فيه بغير طريق الصحابة والسلف، فلا يمكن إذاً أن يسعنا ما لم يسع السلف، ولذلك كان من دعا إلى قبول قول من خاض في مسائل الأسماء والصفات لله تعالى بغير ما كان عليه السلف وظن أن قبول مثل هذه الأقوال يعتبر من الوسطية، فهو مخطئ، لأن «الوسطية» لا يمكن أن تخرج عن طريق السلف وهديهم، وإلا لاستلزم ذلك: أن السلف لم يكونوا وسطيين، وهذا باطل.
ومما يؤكد هذا أنه لما خاض بعض الخلفاء العباسيين في ذلك وألزم الناس به كما حصل من الفتنة بمسألة خلق القرآن، ومع كون السلف من أكثر الناس دعوة إلى السمع والطاعة لولاة الأمور، فإنهم لم يقبلوا الخوض في هذا الباب بغير طريق السلف حتى لو كان الذي تبنَّاه هو خليفة المسلمين الذي تلزمنا طاعته، فكيف بغيره.
ومن المسائل التي وسع السلفَ الخلافُ فيها: مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، فقد وقع فيها الخلاف بين الصحابة أنفسهم ومن بعدهم من السلف ما بين مثبت لذلك ونافي، وهذا يستلزم أن يسعنا ما وسعهم من الخلاف فيها، فلا يُنكر على من اختار أحد القولين.
وإذا نظرنا إلى المسائل الفقهية، فمنها أيضاً ما وسع السلف الخلاف فيها لما ورد فيها من الأدلة، ومنها ما لم يسعهم الخلاف فيها كالمسائل التي تخالف النصوص، والتي عدُّوا من خالف فيها شاذاً لا عبرة بقوله ولا خلافه.
وعلى هذا فلا فرق في هذه القاعدة بين ما يُسمّى بمسائل الأصول ولا غيرها من مسائل الفروع، بل العبرة في ذلك هو قبول السلف للخلاف من عدمه. فما قَبِلَه السلف ووسعهم من الأقوال وسعنا، وما لم يقبلوه ولم يسعهم لا يمكن أن يسعنا.
ومسألة قبول السلف رحمهم الله وسعة صدرهم للخلاف من عدمه مبني على الدليل، فهم لا يقبلون القول المخالف لنص الكتاب أو السنَّة أو الإجماع، لأنه من المنكر الذي أمَرَنا النبي صلى الله عليه وسلم بإنكاره في قوله: «من رأى منكم منكراً فليغيره» الحديث، وأما ما ليس فيه نص وللاجتهاد فيه مجال فلا إنكار فيه عندهم.
قال ابن القيم في «إعلام الموقعين 3/288»: (وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنَّة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره اتفاقاً، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنَّة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنَّة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنَّة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً.
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد ،كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم.
والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً؛ مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعنٌ على من خالفها ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب). ا.ه
العلم الصحيح الراسخ هو أبرز ما تقوم عليه «الوسطية»
«الوسطية» باعتبار ما تم توضيحه من معناها لا تقوم إلا على علم صحيح راسخٍ، إذ مبناها على اتباع الدليل والأثر، ونبذ التعصب والهوى، فلا يمكن أن توجد وسطية مع الجهل بالشرع والأدلة والآثار، لأن الشرع بكل تشريعاته قائم على الاعتدال والتوسط، وهذا الاعتدال ليس منشأه الآراء المحضة، ولا الأهواء المختلفة، وإنما هو موجود في أصل التشريع، فالشريعة إنما شرعها الله عز وجل قائمةً على الاعتدال ومراعاة الأحوال والمتغيرات، وهذه الوسطية والاعتدال قد دلت عليها الشريعة في أصولها، وإنما تُعرف هذه الأصول بالعلم الراسخ.
والعلم الراسخ إنما هو: كتابٌ، وسنَّة، وقول صاحبٍ، واجتهاد العلماء الراسخين فيما لم يرد فيه دليل.
قال ابن القيم:
( العلم قال الله قال رسوله قـال الصحابة هم أولو العرفـان
ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً بين الرسول وبين قول فلان).
فكل من ادعى الوسطية في رأي معين، أو منهج معين، نظرنا: فإن كان عليه أثارة من علم قبلناه، وإلا نبذناه. إذ الوسطية لا تعني ابتداع منهج جديد، أو تبني رأي محدث، فما لم تدل عليه أصول الشريعة فليس من الوسطية.
ولهذا كان السلف ينكرون على أهل الانحراف عن الوسطية من أهل الغلو أو الجفاء بلزوم السنَّة واتباع الآثار، ويحذرون من مغبة اتباع الآراء وتبنيها من غير دليل ولا سنَّة ماضية، وآثارهم في هذا الباب كثيرة.
فمنها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم محذراً من هذا المسلك فيما رواه أحمد وأهل السنن: «فإنه من يعش منكم يرى بعدي اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة».
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر).[أخرجه اللالكائي]
وقال أيضاً: (عليكم بالعلم قبل أن يُقبض، وقبضه أن يذهب أهله، وإنكم ستجدون قوماً يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق).[أخرجه البيهقي في «المدخل»]
وما من قولٍ أو رأيٍ هو في نفسه حقٌّ إلا ولا بد أن يكون عليه أمارة تبينه ودليل يدل عليه، فكيف بأمور الدين والإسلام، فمن ادعى شيئاً من الوسطية مما ليس عليه أثارة من علم فهو مردود غير معدود من الدين.
قال تعالى: (قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) الأحقاف4.
قال الطبري في تفسيره: (فتأويل الكلام إذن: ائتوني أيها القوم بكتاب من قبل هذا الكتاب بتحقيق ما سألتكم تحقيقه من الحجة على دعواكم ما تدعون لآلهتكم، أو ببقية من علم يوصل بها إلى علم صحة ما تقولون من ذلك، (إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) في دعواكم لها ما تدعون، فإن الدعوى إذا لم يكن معها حجة لم تغن عن المدَّعى شيئاً).
وهذ يجعل «الوسطية» ليست بالأهواء المختلفة والآراء المحضة.
وإذا كانت وسطية الإسلام تعني الاعتدال والتوسط في الأمور بين الغلو والجفاء، ومراعاة الأحوال والمتغيرات، فإن هذين الطرفين المذمومين المجانبين للوسطية منشأهما أحد أمرين، أو كلاهما:
الأمر الأول: الجهل.
الأمر الثاني: الهوى.
والعلم الراسخ الصحيح يُبرِّئ من هذين الأمرين، لأن الجهل ضد العلم، والهوى ضد الاتباع والتسليم والإذعان.
والعلم الصحيح الراسخ يشمل أمرين:
الأول: علمٌ بأحكام الله تعالى وشرعه، وهذا يُبرِّئ من الجهل في الأحكام، أو قلة الصبر على المأمور، أو الاستعجال في الثمرات ونحو ذلك من آثار قلة العلم.
الثاني: علمٌ بالله تعالى وما له من العظمة والكبرياء والجلال والبهاء الذي يستلزم الاستسلام لأمره، والإذعان لحكمه، والرغبة في طاعته، والرهبة من مخالفته، وهذا يُبرِّئ من الهوى الذي منشأه الجهل بالله تعالى وبما عنده، بحيث يُؤثر صاحب الهوى ما يهواه على أمر الله تعالى.
قال تعالى محذراً من اتباع الهوى في مخالفة أمر الله تعالى: (فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) القصص50.
وقال تعالى: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ) الجاثية23.
وجاء في الحديث: «لا يُؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به» [أخرجه الهروي في «ذم الكلام» وغيره وصححه النووي].
وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أثر الجهل في انتكاس الأحوال، واضطراب الأمور، واختلال الموازين فقال في بيان علامات الساعة: «من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل».[متفق عليه]
وقال أيضاً في بيان تلازم الخيرية بالعلم: «ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين».[متفق عليه]
وهذه الخيرية المرتبطة بالعلم تعم الأفراد والمجتمعات.
سمات «الوسطية»
لوسطية الإسلام واعتداله سمات وخصائص، فمنها:
أولاً: أنه المنهج الذي ارتضاه الله تعالى واختاره لأفضل وأكمل وأشرف رسله صلى الله عليه وسلم، وخصَّ الله تعالى به أمته صلى الله عليه وسلم ليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، يشهدون للأنبياء في تبليغهم الرسالة.
قال تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) آل عمران110.
فرفع الله عن هذه الأمة الأغلال والآصار التي كانت على من سبقهم من الأمم، فجعلهم خير الأمم، معتدلين في شريعتهم، متوسطين في أمورهم.
قال تعالى: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ) الأعراف157.
ثانياً: أن فيها مراعاة الأحوال والمتغيرات، سواءٌ المتعلقة بالأفراد، أو المجتمعات، أو الدول، انطلاقاً من قوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن16.
فالوسطية والسنَّة لا تكلف العباد ما ليس في وسعهم ومقدورهم، فهي تراعي اختلاف الأحوال والأزمنة، ولذلك كانت صالحة لكل زمان ومكان.
ومن ذلك مثلاً تشريع الجهاد: فإن الله تعالى شرعه على مراحل تناسب حال الناس والوقت والزمان، فشُرع الصبر أولاً لما كان المسلمون في حال ضعف وقلة، كما في قوله تعالى: (فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ) البقرة109.
ثم أُذن لهم في القتال من غير إلزام لأنهم مظلومون كما في قوله تعالى (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) الحج39.
ثم أمره الله عز وجل بقتال من قاتله والكف عمن كف عنه كما في قوله تعالى (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ).
ثم أمر بقتال الكفار جميعاً وجهاد المشركين مطلقاً وغزوهم في بلادهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله كما في قوله تعالى: (فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) التوبة5.
وهذه الأحكام يُعمل فيها بحسب الحال والمقام.
فالشريعة قائمة على اعتبار الأحوال والتغيرات، ولذلك كان من قواعد الشريعة: أن المشقة تجلب التيسير.
وكما أن المشقة تجلب التيسير، فقد يمنع الشرع ابتداءاً بعض الأمور سداًّ للذريعة وصيانة للتوحيد. فيبدأ بالأشد ثم الأخف والأيسر، ومن ذلك منعُ النبي صلى الله عليه وسلم الانتباذ في الأوعية التي يُسرع إليها الإسكار، كالحنتم والنقير والمزفت، كما جاء في الصحيحين من حديث وفد عبد القيس وفيه: «ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزقت. وربما قال: المُقَيَّر».
ثم لما استقرت الشريعة وداخل الإيمان بشاشة القلوب نسخ ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً». [رواه مسلم]
ثالثاً: أنها تراعي القدرات والإمكانات.
فيختلف التشريع بحسب قدرات الناس وطاقاتهم، ولذلك فإنه أوجب على الرجل ما لم يوجبه على المرأة، ويوجب أيضاً على العالم ما لا يوجبه على الجاهل، ويوجب على الحاكم ما لا يوجبه على آحاد الرعية، وهكذا نجد التشريع يناسب قدرات الناس وإمكاناتهم.
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه» [رواه مسلم].
وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب». [رواه البخاري]
رابعاً: أنها مبينية على التيسير والتخفيف، ورفع الآصار والأغلال.
قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة». [ت حم ]
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة». [رواه البخاري]
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه» [متفق عليه]
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لن ينجي أحداً منكم عملُه، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولكن سددوا و قاربوا، و اغدوا و روحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا».[متفق عليه]
وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة و عشرين جزءاً من النبوة». [رواه أحمد وأبو داود]
و«القصد» المذكور في الحديث وكذا «الاقتصاد» إنما هو الاعتدال والتوسط في الأمور بين الغلو والجفاء.
وهذا التيسير والتخفيف موجود في أصل التشريع، فإن الله تعالى شرع للمسلمين شريعة سمحة سهلة ليس فيها أغلال ولا آصار. ولذلك جاءت الشريعة بالرخص التي تناسب أحوال الناس ومتغيرات الزمان والأحوال.
وهذا يعني أن المراد بالتيسير هو ما جاءت الشريعة لا ما ابتدعه الناس بأهوائهم وآرائهم المحضة، فإن بعض الناس قد نبذ بعض مسلمات الدين بحجة التيسير، فأحل ما حرم الله، وحرم ما أحل الله، وهذا من الجهل والخطأ.
خامساً: أنها تعصم من الفتن.
إذ أن الفتن إنما تنشأ من المبالغة والمجاوزة، سواءٌ كانت في طرف الغلو أو في طرف الجفاء، فما من فتنة وقعت إلا وسببها الغلو ومجاوزة الحد والبعد عن التوسط والاعتدال الذي هو «السنَّة».
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين». [رواه أحمد والنسائي وغيرهما]
وكل الفتن التي ظهرت في الإسلام كان منشأها مخالفة السنَّة، والبعد عن الوسطية، كالخوارج الذين غلو في الوعيد، وقابلهم المرجئة الذين غلو في الوعد، ثم الجهمية الذين غلو في التنزيه، وقابلهم المشبهة الذين غلو في التشبيه، وهكذا كلما ظهرت فرقة تغلو في جانب قابلتها أخرى تغلو في الجانب الآخر، والإسلام وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين.
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الاعتدال والتوسط في الأمور، فقال: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تُبغِّض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبتَّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى». [رواه أحمد والبيهقي]
سادساً: أن منهج التوسط والاعتدال في الأمور يوافق العقل الصحيح والميزان القويم الذي ركزه الله تعالى في الفطر، والذي يميزون به بين الحق والباطل ويعرفون أن هذه الشريعة حقٌّ من عند الله تعالى.
قال تعالى: (اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ) الشورى17.
وقال تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) الحديد25.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (الفتاوى 19/176): (فان الله بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل، وقد فسَّروا إنزال ذلك بأنْ أَلْهَم العباد معرفة ذلك).
وقال أيضاً (الرد على المنطقيين ص333): (والميزان: قال كثير من المفسرين هو العدل، وقال بعضهم هو ما به توزن الأمور وهو ما به يُعرف العدل، وكذلك قالوا في قوله: (وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ:) الأمثال المضروبة والأقيسة العقلية).
غايات الوسطية
أولاً: تحقيق العبودية لله تعالى، وهي التي خُلق لها الثقلين.
قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) الذاريات56.
فالوسطية قائمة على الاعتدال والتوسط ليتمكن العباد من عبادة ربهم على الوجه الأكمل، بحسب قدراتهم وإمكاناتهم، في كل زمان ومكان.
وهذا هو أعظم الغايات وأزكى المقاصد، وعليه قوام الدين، وبه ينال العبد ما عند الله عز وجل من النعيم، ويظفر بجنة رب العالمين.
ثانياً: دعوة الناس إلى الإسلام، وإدخالهم فيه. فإن الناس إذا علموا ما في الإسلام من الوسطية والاعتدال الذي يوافق العقل الصحيح رغبوا فيه، وآثروه على غيره. وهو الأمر الذي أدخل كثيراً من الكفار في الإسلام.
قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) الأنبياء107.
وقال تعالى: (لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ) التوبة128.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث عماله على الأمصار يوصيهم بالتبشير وترك التنفير، كما روى الشيخان أن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن فقال: «يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا«.
ثالثاً: تحقيق مصالح الناس الدنيوية والتي لا قوام لهم إلا بها. فإن الإسلام لم يهمل ما للناس به حاجة من معاشهم، فأباح لهم ما يتكسبون به ويقتاتون على وجه الاعتدال والتوسط.
قال تعالى: (وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأعراف31.
وقال تعالى: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً) الفرقان67.
وقال: (وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً) الإسراء29.
وأبطل الإسلام الرهبانية.
ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: «ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا».
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ)». [رواه أبو داود وغيره]
ورغَّب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل فقال: «لأن يحتزم أحدكم حزمةً من حطب، فيحملها على ظهره فيبيعها، خيرٌ له من أن يسأل رجلاً يعطيه أو يمنعه». [متفق عليه]
اعتبار التاريخ والنظر في أحداثه وما جرى فيه من الفتن أحد موازين الوسطية
إذا أردنا أن نتحدث عن «الوسطية» فمن المهم بمكان اعتبار التاريخ واستقراءه، فإن التاريخ مليء بالأحداث الجسيمة والفتن العظيمة. وهذه الفتن لها مبادئ ومقدمات آلت إليها، فكم من أمرٍ يُدَّعى أنه من الوسطية هو في حقيقته من أسباب الفتن عند النظر في سنَّة الله الكونية وتجارب الناس.
فالتاريخ وما فيه من أحداث شاهد لسنَّة الله الشرعية، وقد قال تعالى (فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً) فاطر43.
ومن ذلك مثلاً ما يُعرف اليوم بقبول الآخر، ويعنون به كل مخالف، ويزعمون أن الوسطية تستدعي قبول الآراء والاختلافات ولو كانت في أصول الدين، ولو كانت تصادم النصوص الصريحة، ففتحوا بذلك أبواب البدع والمحدثات.
ومن تأمل التاريخ علم أن أحد أكبر أسباب الفتن والمحن التي جرت في بلاد الإسلام كان منشأها هذه الأفكار المبتدعة والأقوال المحدثة، والتي ولَّدت عند أهلها استباحة رفع السيف على الأمة.
ومن أظهر ذلك: بدعة الخوارج والتي كانت أول البدع ظهوراً. فخلاف الخوارج وخروجهم على علي رضي الله عنه وشقهم لصف المسلمين مشهور، وما ترتب على ذلك من استباحة الدماء وتكفير المسلمين حتى استحقوا الوعيد الشديد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم.
ومثله ما حصل ممن بعدهم من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم.
ولذلك لما علم السلف ما يترتب على هذه الآراء المخالفة من الفتن والمحن واضطراب الأمور وشيوع الفوضى وطمس الحق والسنَّة حذروا منها ومن أهلها أشد التحذير، ونصوصهم في هذا الباب معلومة مشهورة.
وكان السلف أعرف بهذه الأقاويل والآراء المحدثة وما فيها من الشر ممن بعدهم، فمع كونها تُلبِّس الحقَّ على الناس، فإنها تنتهي بالسيف متى ما تمكن أهلها.
قال أبو قلابة رحمه الله: (ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف). [رواه اللالكائي]
وكان كثير من السلف يطلقون على أهل البدع والآراء المنحرفة عن السنَّة وصف «الخوارج»، بجامع خروجهم عن الشريعة وخروجهم بالسيف على المسلمين.
فمن جهل الشرع وجهل التاريخ أيضاً ظن بجهله أن فسح المجال لكل رأي وبدعة ولو خالفت النصوص يُعدُّ من الوسطية، وهو الأمر الذي يزعمه بعض الناس اليوم ويَدْعون إليه ويقررونه في تنظيراتهم، بل ويَسِمُون من حذَّر من البدع ومَنَع من إفساح المجال لهم بالرجعية والتطرف والغلو.
قال تعالى في أهمية اعتبار التاريخ والنظر في قصص الأمم الماضية والأزمان السالفة: (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) يوسف111.