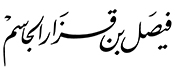الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
فقد استمتعت إلى محاضرة الدكتور جاسم الجزاع بعنوان، «السلفيون والسلطة»، فوجدته -عفا الله عنا وعنه- عريضَ الدعوى، واسعَ الإطلاق، كثير الإبهام، جريئًا في الأحكام، خاض في أمورٍ شرعية لا يُحسنها ولا يفقهها، وحرَّف أصولًا عقدية بمحض الرأي والتخرُّص والظنُّ، وأطلق دعاوى عريضة لا خطام لها ولا زمام، وذكر أقوالًا لا تُعرف عن أهل العلم والإيمان، وخلط بين المسائل فقلب المعاني والأحكام، فكان أكثر ما خاض فيه وقرَّرَه ليس من قبيل الحقائق بل الأوهام.
ولولا عِظَمُ ما وقع فيه من الأخطاء والأوهام، وخطورة ما ضمّنه من الجرأة في إطلاق الأقوال والأحكام، لأعرضنا عما قال، فإنَّ الدكتور -وفقنا الله وإياه لهداه- له نشاط طيبٌ في عَرْضِ التاريخ، وسَرْدِ الوقائع بأسلوب شيق لاقى قبولًا واسعًا، وهذا من فضل الله تعالى عليه، فأحزننا جدًّا أن يخوض في الأحكام الشرعية بلا بينة ولا برهان، فكان هذا الردُّ بمثابة النصيحة له والتقويم، فضلًا عن كونه نصيحة للمسلمين حكاماً ومحكومين.
ومواضع النقد عليه كثيرة، لا يسع المقام للردِّ عليها بالتفصيل، لكنني أشير إلى المهم منها، وأبدأ بأعظمها خطرًا، وأكثرها بعدًا عن الحقِّ، ثم أعقبها بالتعليق المختصر على بعض ما وقع فيه من الأوهام، على سبيل الإشارة والتنبيه.
وقبل الشروع في ردِّ أوهامه وأخطائه، فإني أحبُّ أن أنبّه على جملة من الأخطاء المنهجية والعلمية العامَّة في طرحه للقضايا الشرعية، وهي كالتالي:
الأمر الأول:
إنَّ الأمور الشرعية المبنيَّة على الدلائل النصيَّة والأصول الشرعية والقواعد المرعيَّة لا يحقُّ لغير علماء الشريعة الخوض فيها تحليلًا وتحريمًا وإباحةً، لأن المتكلم فيها إنما يتكلم نيابة عن صاحب الشرع، فهو موقِّعٌ عن الله تعالى، ومن هنا سمَّى ابن القيم كتابه في هذا الباب بـ «إعلام الموَقِّعين عن ربِّ العالمين»، فلا يجوز لأحدٍ كائنًا من كان أن يُحرّم ويُحلّل ويُبيح بمحض الرأي، بل لا بد من العلم والفقه في الدين، فقد قال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ}، وقال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}، وقال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أُفتيَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه».
وقال ابن القيم: (وأما القول على الله بلا علم فهو أشدُّ هذه المحرمات تحريمًا، وأعظمها إثمًا، ولهذا ذُكِر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير، الذي يباح في حال دون حال). «مدارج السالكين» ١/٣٧٨
وقد كان السلف يهابون الفتيا والكلام في الحلال والحرام خشية الزلل، وكان الإمام مالك ابن أنس رحمه الله يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يَعرِضَ نفسه على الجنة والنار، وكيف خلاصه؟ ثم يجيب. وسُئل -رحمه الله- عن مسألة، فقال: لا أدري، فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب، وقال: ليس في العلم شيء خفيف. «آداب المفتي والمستفتي» للنووي ص١٦
وهذا التغليظ يعمُّ جميع مسائل الدين، فكيف بالمسائل العامة التي يعظم خطرها، ويعمُّ أثرها، كمسائل الدماء، والفتن، والخروج، والإنكار على الولاة والسلاطين ونحوها من المسائل التي تُعدُّ من مسائل السياسة الشرعية العامة التي لا يتولاها إلا أهل الشأن وأهل الرسوخ في العلم، وفي ذلك قوله تعالى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}. فخصَّ الله تبارك وتعالى في هذا النوع من مسائل الدين أولي الأمر من العلماء والأمراء، ولم يجعله لآحاد العلماء، فضلًا عن العامة.
فمن أعظم أسباب الفتن في التاريخ؛ قديمه وحديثه: خوضُ غير أهل الرسوخ في العلم في هذا النوع من المسائل العامّة، والكلام فيها من غير أهل الشأن والحلِّ والعقد.
والدكتور جاسم الجزاع -عفا الله عنا وعنه- لا أظنُّه يخفى عليه ما جرى في التاريخ من الفتن والقلائل التي حلَّت ببلاد المسلمين، فكانت سببًا في تفريق كلمتهم، وإراقة دمائهم، وتسلُّط أعدائهم، وضعف شوكتهم، وأنَّ دخول غير أهل الشأن فيها كان المحرّكَ الأهم في إيقادها واشتعالها، ومواقفُ العلماء في هذا كثيرة.
والدكتور جاسم الجزَّاع لم يتلقَّ العلم الشرعي في الجامعات والكليَّات، ولا في حلقات العلم حيث لم يُعرف عنه ملازمة العلماء، بل هو متخصصٌ في علم الأرغونوميات وجودة الخدمات الحكومية، ومثله لا يحقُّ له بحال أن يتكلم في الأحكام الشرعية في أمور الطهارة والصلاة، فضلًا عن مسائل السياسة الشرعية العامة، وسبل تقويم الراعي والرعية.
ومن عجيب الأمور أنَّ الدكتور -عفا الله عنا وعنه- قد ظهر جهلُه بمعنى كلمة التوحيد، التي هي أصلُ الإسلام وأسُّه وبوَّابته، وعليها قامت سوق الجنة والنار، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، حيث قال في ندوة الحقوق والحريات بالنصّ: (المقصود بهذه الكلمة أنَّ هناك تشريعات جديدة سوف تنطلق من هذه الجملة، سوف تتحرر أيها العربي في الجاهلية من الإرث الاجتماعي، والإرث السياسي، والإرث الاقتصادي، لا إله إلا الله أتت بنظام اقتصادي جديد، لا إله إلا الله أتت بنظام سياسي جديد…).
ولا أدري من أين جاء الدكتور -هداه الله- بهذا التفسير، أَمِن معاجم اللغة، أم من الآيات، أم من الأحاديث، أم من أقوال العلماء؟
أم إنه ابتدع تفسيرًا جديدًا، ضلَّ عنه العلماء، وغابت عن بيانه الآيات، وأهملته الأحاديث، وأغفلته كتب اللغة والتفسير والغريب.
فإنَّ كلمة التوحيد تعني: لا معبود بحقٍّ إلا الله، كما فسّرها الله في كتابه، كما في قوله: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ}، والتي فهمها قريش فامتنعوا عنها، كما في قوله تعالى: {وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. أَجَعَلَ الْآَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ}، وفي قوله: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آَلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ}، وفي قوله: {قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا}. فمدار كلمة التوحيد حول إفراد الله بالعبادة والتأله، وترك جميع المعبودات من دونه، من شجرٍ وحجرٍ ووليٍّ ونبيٍّ ومَلَك، والعبادة: هي غاية التذلل والخضوع والتعظيم للمعبود.
وعجبًا! كيف يدَّعي الدكتور مثل ذلك، مع علمه بأنَّ المشركين قد عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم المالَ والملكَ، حتى إنهم لا يقطعون أمرًا دونه، على أن يترك دعوتهم إلى التوحيد، فأبى إلا أن يُعبد الله وحده لا شريك له.
والردُّ على هذه السقطة العظيمة ليس من موضوع مقالي هذا، لكنني أشرت إليها لأبيّن جهل الدكتور بمعنى كلمة التوحيد التي لا يجهلها صبيان المدارس، فالذي يجهل معنى كلمة التوحيد، هل يُتصوَّر أو يجوزُ له أن يتكلم فيما هو أدقُّ وأخفى من مسائل الدين كمسائل الفقه والسياسة الشرعية؟!
ومن العجيب أنَّ الدكتور جاسم بدأ محاضرته بتقرير القاعدة العلمية (الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره)، ثم إذا هو أوَّل من يخالفها، حيث صار يخوض في عظائم المسائل والأحكام الشرعية من غير دربة ولا تأهل ولا تمكّن! {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ}، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ}.
الأمر الثاني
قد يُقبلُ من الدكتور خوضُه في أحداث التاريخ، وسرد وقائعه، وتحليل أحداثه من الجهة التاريخية لا الشرعية، على الرغم من عدم تخصصه الأكاديمي في ذلك، لكن بحكم عنايته واهتمامه به. لكنَّ مثله لا يجوز له أن يتعدَّى حدود علمه بالوقائع التاريخية إلى حدِّ تنزيل الأحكام الشرعية على تلك الوقائع، وربط تلك الوقائع بقواعد الشرع وأصوله. وهذا المنع ليس خاصًّا بالدكتور جاسم الجزاع، بل يُقال في حقِّ كل مؤرخٍ متقدّمًا كان أو متأخرًا. فليس لغير العالم بالشرع تنزيل الأحكام الشرعية على الأحداث التاريخية، وهذا الخطأ قد وقع فيه كثير من المعاصرين المعتنين بالتاريخ. وهو يقع أيضًا من بعض أهل الفنون والعلوم الأخرى كعلم القراءات واللغة والمصطلح ونحوها من العلوم، حيث يتكلمون في الحلال والحرام من منطلق ما يتقنونه من فنٍّ فرعيٍّ تكميليٍّ، مع جهلهم بالنصوص والقواعد والأصول الشرعية.
وليت الدكتور جاسم الجزاع وقف عند حدِّ تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع التاريخية، بل تعدَّى ذلك إلى استنباط قواعد وضوابط وأصولٍ علمية وعقدية ما أنزل الله بها من سلطان، هَدَمَ بها ما هو مقرّرٌ ومستقرٌّ في كتب المعتقد، فضلًا عن كتب الفقه والحديث. فأخذ يُشرِّق ويغرِّب، ويميل يمنة ويسرة، ويبتدع بفهمه دينًا جديدًا، ويؤسسُ عقيدةً مُحدثة مصادمةً للنصوص والإجماعات المستقرة التي تواتر ذكرها وتقريرها في كتب علماء أهل السنَّة والجماعة، فلم يخلُ من ذكرها كتاب من كتب المعتقد والأصول، مختصرًا كان أو مبسوطًا.
بل إنَّه جعل الأصول الثابتة، والقواعد الراسخة في الدين، المبنية على النصوص المحكمة، والإجماعات المستقرة، من قبيل النظريّات القابلة للقبول والردِّ، والتوسيع والتضييق، حسب الأهواء والأفكار والعقول القاصرة، فصارت حجية النصوص والإجماعات نسبية، قابلة للتغيير والتحريف بحسب الظروف والمستجدات، وهذا هو أساس فكر التنوير الذي خرج من رحمه كل فكرٍ وتيارٍ مصادمٍ للأديان، إذ إنَّه يقوم على أنه لا حقيقة مطلقة، بل كل الأمور قابلةٌ للقبول والردِّ، والمقياس إنما هو التجرِبة والمصلحة الزمانية والمكانية، حتى لو كان الأمر وحيًا من السماء.
الأمر الثالث
الذي يظهر من صنيع الدكتور في محاضرته أنَّه يعتقدُ ثم يستدل، وهذا خلاف طريقة أهل السنَّة والجماعة، فإنَّهم يستدلون ثم يعتقدون، فيأخذون العقيدة والعلم والأحكام من النصوص، وهذا هو كمال الاتباع والتسليم الذي أمرنا به، وإنَّما زلَّ من زلَّ بكونهم اعتقدوا أولًا، ثم بحثوا في النصوص عمَّا يشهد لما اعتقدوه، وهو ضدُّ ما أمرنا به من التسليم والاتباع، كما في قوله تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ}، وقوله: { َلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}، وقوله: {وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى}، وقال الطحاوي في عقيدته: (ولا تثبت قدم الإسلام إلا ظهر التسليم والاستسلام).
ودليل ذلك ما سيأتي ذِكرُه من أقوال الدكتور الغريبة والخاطئة والمُحدثة.
هذا ما يتعلَّق بالردِّ على المنهجية العامة التي سلكها الدكتور، وأمَّا الردُّ على أخطائه وزلاته وأوهامه في المحاضرة المشار إليها، فأقول مستعينًا بالله طالبًا الاختصار لا البسط:
الخطأ الأول:
زعم الدكتور -هدانا الله وإياه- أنَّ السلف كانوا يرون مسألة الخروج على الحاكم الظالم مسألة تقديرية، مناطةً بالمصلحة والمفسدة، وعلى هذا فهي تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، واستدلَّ على ذلك بما وقع من الحسين وابن الزبير رضي الله عنهما، وما وقع من بعض التابعين في العراق كسعيد بن جبير وغيره في فتنة ابن الأشعث. وزعم: (أنَّ أهل السنَّة والجماعة في التعامل مع السلطة ينظرون إلى المقاصد والمصالح والمفاسد، إن كانت المصلحة في الرأي الأول -وهو الخروج على الظلمة- انتهجوه، وإن تغيّرت المصلحة إلى الرأي الآخر ارتضوه). وقال: (فالسلفيون لا يرون الخروج المسلح تبعًا لهذه النظرية، فهو ليس قولًا حاكمًا في كل زمان ومكان).
وليت الدكتور وقف عند حدِّ عدِّ هذا القول قولًا لبعض السلف، لكنَّه جعله قولًا للسلف كلِّهم، فإنَّه أطلق عبارات التعميم، مثل: (كان أهل السنَّة يرون)، و(كان السلف من مذهبهم كذا)، هكذا بإطلاق، وقد سلك هذا المسلك في كثير من مباحث المحاضرة، يُطلق الدعاوى العريضة، ويجعلها قولًا لجميع السلف، ولعامة أهل السنَّة والجماعة معبِّرًا بألفاظ العموم، دون تفصيل وتخصيص وتقييد.
فأقول مجيبًا على هذا الخطأ الكبير، والدعوى العريضة: إنَّ هذا القول الذي ذكره الدكتور بدعةٌ وضلالة في الدين، ومصادمةٌ صريحة للنصِّ والإجماع، وخروجٌ عن منهج السلف الماضين والأئمة المرضيين.
والجواب عليه: إجماليٌّ وتفصيليٌّ.
فأمَّا الإجماليُّ:
فإنَّ تحريم الخروج على الحاكم الظالم والفاسق يُعدُّ من الأصول العظام في منهج أهل السنّة والجماعة، ومن الأمور الفارقة بين أهل السنَّة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، وهو من القواعد المحكمة في الدين، التي أفاضت في بيانها نصوص الكتاب والسنَّة، وآثار سلف الأمة، والدلائل فيها أكثر من أن تُحصر.
فمنها قوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}.
قال ابن كثير -رحمه الله-: (وقوله {وَلاَ تَفَرَّقُواْ} أَمَرَهم بالجماعة، ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف). «تفسير ابن كثير»
وقال القرطبي -رحمه الله-: (عن عبد الله بن مسعود: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} قال: الجماعة، روي عنه وعن غيره من وجوه، والمعنى كله متقارب متداخل، فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة). «تفسير القرطبي».
وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «دعانا النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايَعَنَا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرةٍ علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان». متفق عليه
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: «قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشرٍّ، فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركتُ ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع». رواه مسلم
وعن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا». رواه مسلم
وقد أجمع العلماء على ما دلَّت عليه النصوص المستفيضة من تحريم الخروج على الحاكم المسلم بمجرد الظلم والفسق، وأنَّ الخروج عليه ضلالٌ مبين، وخروج عن سبيل المؤمنين، ونصوصهم في ذلك كثيرة جدًّا.
فقد قال الإمام أحمد -رحمه الله-: (ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، وقد كان الناس قد اجتمعوا عليه، وأقروا له بالخلافة، بأيِّ وجٍه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شقَّ عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان، ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق). «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي ٢٨١
وقال البربهاري -رحمه الله-: (ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية). «شرح السنَّة» ص٧٦
وقال الشهرستاني -رحمه الله-: (كلُّ مَن خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان إلى يوم الدين والأئمة في كل زمان). «الملل والنحل» ١/١٠٥
وقال النووي -رحمه الله-: (ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم، إلا أن تروا منهم منكراً محقَّقًا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحُكِيَ عن المعتزلة أيضًا فغلط من قائله مخالف للإجماع). «شرح مسلم» ١٢/٤٦٩
وقال عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: (هذا دين الخوارج والمعتزلة: الخروج على ولاة الأمور، وعدم السمع والطاعة لهم إذا وُجدِت معصية). «الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية» ص١٤
وقال العثيمين -رحمه الله-: (وأما قول بعض السفهاء: إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة، فهذا خطأ، وهذا غلط، وهذا ليس من الشرع في شيء. بل هذا مذهب الخوارج الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء، وهذا لم يحصل من زمن، فقد تغيرت الأمور). «شرح رياض الصالحين» ٤/٩٧
فأهل السنَّة والجماعة مجمعون على تحريم الخروج على الأئمة بالظلم والفسق، والقولُ الذي يُبيح الخروج على الظلمة إنما هو قول الخوارج والمعتزلة، وليس قولًا لبعض أهل السنَّة والجماعة، فضلًا أن يكون قول جميعهم -حسب زعم الدكتور جاسم-.
قال القرطبي -رحمه الله-: (والذي عليه أكثر العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأنَّ في منازعته والخروج عليه استبدالُ الأمن بالخوف، وإراقة الدماء، وانطلاق أيدي السفهاء، وشن الغارات على المسلمين، والفساد في الأرض. والأول – أي القول بجواز الخروج على الحاكم الظالم- مذهب طائفة من المعتزلة، وهو مذهب الخوارج، فاعلمه!). «تفسير القرطبي» ٢/١٠٩
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله-: (ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزومُ الجماعة، وتركُ قتال الأئمة، وتركُ القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم). «مجموع الفتاوى» ٢٨/١٢٨
فأمَّا الجواب التفصيلي، فأقول:
قد احتجَّ الدكتور جاسم على ما يدَّعي بخروج الحسين بن علي وابن الزبير على يزيد بن معاوية، وخروج من سمَّى من التابعين على عبد الملك بن مروان.
والجواب من وجوه:
الوجه الأول:
إنه لا حجَّة في قول أحدٍ كائناً من كان في مخالفة الكتاب والسنَّة وما أجمعت عليه الأمة، وهذا من بدهيات الدين، ومن أبجديات معتقد أهل السنة والجماعة، والنصوص الآمرة بالصبر على جور الولاة، والناهية عن الخروج عليهم صريحة في ذلك، بما لا حجة لأحد في خلافها بعد بلوغها عنده.
قال الأُبّي -رحمه الله- لما ذكر أحاديث طاعة الأمراء والنهي عن منابذتهم: (وأحاديث الباب كلُّها ظاهرةٌ أو نصٌّ في المنع – أي من الخروج على ولاة الجور-). «شرح مسلم للأبّي» ٥/١٩٦
ولا تخفى دلائل وجوب تقديم نصوص الكتاب والسنَّة على أقوال وأفعال آحاد الرجال، ولو كانوا أئمة وعلماء.
وقد قال الشافعي -رحمه الله-: (أجمع الناس على أنَّ من استبانت له سنَّةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أنْ يَدَعَها لقول أحدٍ من الناس). «إعلام الموقعين» ٢/٢٨٢
فأقوال العلماء يُحتجُّ لها ولا يُحتجُّ بها، وما من أحدٍ إلا ويُؤخذ من قوله ويُرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثاني:
أنَّه على التنزَّل بوجود خلافٍ قديم بين السلف في حكم الخروج على الحاكم الظالم، فإنَّ الخلاف لم يستقر، بل استقرَّ الإجماع بعده على تحريم الخروج في ذلك القرن، فلم تَبْقَ المسألة خلافية، بل صارت إجماعية. ولهذا النوع من المسائل الإجماعية بعد الخلاف غير المستقر أمثلة فقهية كثيرة، منها: مسألة الوضوء مما مسَّت النار، ومسألة عدم وجوب الغسل من الجنابة بمجرد الإيلاج بدون إنزال، ومسألة نكاح المتعة، وغيرها من المسائل التي وُجد فيها خلافٌ في عصر الصحابة لأسباب متعددة، ثم استقرَّ الإجماع على حكمها.
قال النووي -رحمه الله-: (قال القاضي: وقيل إنَّ هذا الخلاف –أي جواز الخروج على أئمة الجور- كان أولًا، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم). «شرح مسلم» ١٢/٤٦٩
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (استقرَّ أمرُ أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم). «منهاج السنَّة» 4/592
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في ترجمة الحسن بن صالح بن حي: (وقولهم «كان يرى السيف» يعني: كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقرَّ الأمرُ على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة بن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر). «تهذيب التهذيب» ٢/٢٥٠
الوجه الثالث:
أن من ثبت عنهم الخروج من أهل العلم والدين، فإنهم يُقابَلون بمن نهوا عن الخروج، وحذَّروا منه، ممن هم أجلُّ وأعلم وأعظمُ قدراً في الإسلام، مستدلين بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل من نهي ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم الحسين في ذهابه إلى العراق.
وكما نهى ابن عمر والنعمان بن بشير رضي الله عنهما أهلَ المدينة من الخروج على يزيد عام الحرة، وكما حصل من نهي الحسن البصري ومجاهد وغيرهما من الخروج على الحجاج في فتنة ابن الأشعث.
فإذا كانت أقوال الرجال وأفعالهم حجَّةً، فإنَّ أقوالَ مَنْ نهوا عن الخروج وحذّروا منه أولى بأن تكون حجَّةً على تحريم الخروج على السلطان الجائر، لأنهم أكثرُ وأعلمُ، فكيف إذا كانت أقوالُهم تؤيدها النصوص المستفيضة المتظاهرة في النهي عن الخروج على أئمة الجور.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث). «منهاج السنّة» ٤/٥٩٢
الوجه الرابع:
أنه قد ثبت رجوعُ كثيرٍ من أهل العلم والدين عن الثورة بعد أن شرعوا فيها، أو كادوا، وثبت أيضًا ندمُ بعضهم على ما فعلوا وأخطأوا من الخروج ومفارقة الجماعة.
فالحسين بن علي رضي الله عنه رجع عن عزمه انتزاع العراق من يزيد بن معاوية لما تبين له غدر أهل العراق، وأنَّ الأمر سيترتب عليه فتنة وفساد أكبر، حتى قُتل مظلوماً شهيداً، فإنَّه لم يبايع يزيد بن معاوية أولَّ الأمر، بل ظل معتزلاً في مكة حتى تتابعت عليه كتب أهل العراق تطلب منه القدوم عليهم، فخرج إليهم متأولًا ظنًّا منه أن الناس يطيعونه، وقد حاول جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن يثنوه عن مراده، وأشاروا عليه ونصحوه بعدم الخروج إلى أهل العراق، إلا أنه أصرَّ على ما أراد فخرج متأولًا، فلما تبيَّنَ له انصراف الناس عنه رجع عما عزم عليه، وتَرَكَ طلب الإمارة، طالباً إما الذهاب إلى يزيد ليبايعه، أو الذهاب إلى ثغور المسلمين للجهاد، أو الرجوع إلى بلده، لكن أبى عليه جيش الكوفة إلا أن ينزل على حكمهم، ثم يرون فيه رأيهم، فأبى عليهم حتى قاتلوه فقتلوه مظلوماً شهيداً رضي الله عنه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (وعليٌّ رضي الله عنه في آخر الأمر تبيَّن له أن المصلحة في ترك القتال أعظم منها في فعله، وكذلك الحسين رضي الله عنه لم يُقتل إلا مظلومًا شهيدًا، تاركًا لطلب الإمارة، طالباً للرجوع إما إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى المتولي على الناس يزيد). «منهاج السنة» 4/535
فكيف يستشهد الدكتور جاسم بخروج الحسين رضي الله عنه، مع كونه قد رجع عما عزم عليه، وأراد الدخول في بيعة يزيد، ولم يقاتل يزيد أصلًا.
وأما عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فإنَّه لم يبايع يزيد بن معاوية ولم يخرج عليه، بل كان ممن أشار على الحسين بعدم الخروج إلى أهل الكوفة، فبقي معتزلًا مدة ولاية يزيد، حتى توفي معاوية بن يزيد دون أن يستخلف أحدًا، فبايعه عامةُ المسلمين في الأمصار بالخلافة ما خلا الأردن، فصار ابنُ الزبير رضي الله عنه هو الخليفة آنذاك على الصحيح، حتى بغى عليه مروان بن الحكم وبنوه، فأخذوا ما تحت يده من البلاد، إلى أن قتلوه رضي الله عنه في مكة.
فعبد الله بن الزبير لم يخرج على إمام، وإنما بويع له بالخلافة وبُغي عليه فيها.
وممن ثبت رجوعه واعترافه بخطأه في الخروج على الحجاج عامر الشعبي، فقد قيل له في فتنة ابن الأشعث –وكان ممن شارك فيها-: أين كنت يا عامر؟ قال: (كنت حيث يقول الشاعر:
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوَّت إنسان فكدت أطير
أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء، ولا فجرة أقوياء). «منهاج السنة» (4/529)، وقد أخرجه البيهقي في الكبرى (12229)، وأبو نعيم في الحلية في ترجمة الشعبي بأطول منه.
الوجه الخامس:
أنَّ بعض من سمَّاهم الدكتور جاسم الجزاع من التابعين ممن خرجوا على الحجاج بن يوسف الثقفي، مستدلًا بفعلهم على جواز الخروج على الحاكم الظالم للمصلحة، لم يكن خروجهم لمجرد الفسق والظلم، بل بما ثبت عندهم من الكفر.
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: (وقال الأوزاعي: سمعت القاسم بن مخيمرة يقول: كان الحجاج ينقض عرى الإسلام، وذكر حكاية. وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم: لم يَبْقَ لله حرمةٌ إلا ارتكبها الحجاج بن يوسف. وقال يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش: اختلفوا في الحجاج، فسألوا مجاهدًا، فقال: تسألون عن الشيخ الكافر. وروى ابن عساكر عن الشعبي أنه قال: الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت، كافر بالله العظيم. كذا قال والله أعلم. وقال الثوري عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: عجباً لإخواننا من أهل العراق، يُسمُّون الحجاج مؤمنًا!…
إلى أن قال ابن كثير: وقد رُوي عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفر كما قدمنا، فإن كان قد تاب منها وأقلع عنها، وإلا فهو باق في عهدتها). «البداية والنهاية» 9/136
وقد نقل الأبّي عن القاضي عياض قوله: (وأجاب الجمهور –أي على قيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج– بأنَّ القيام على الحجاج لم يكن بمجرد الفسق، بل لما غيَّر من الشرع، وظاهَرَ الكفر وبيعة الأحرار، وتفضيلَه الخليفة على النبي، وقوله المشهور المنكر في ذلك). «شرح مسلم للأبّي» 5/180
الوجه السادس:
أنَّ أهل السنَّة والجماعة قد تتابعوا على ذكر النهي عن الخروج على الظلمة وحكام الجور في كلِّ كتب العقائد، مختصرها ومتوسطها ومبسوطها، وعدُّوا ذلك أصلًا من أصول معتقد أهل السنَّة والجماعة المُحْكَمَة لا المتغيّرة، فإن كانت المسألة -حسب ما يزعم الدكتور جاسم- راجعة إلى المصلحة، وأنَّ هذا هو قول أهل السنَّة والجماعة وليس المذكور في كتب العقائد، فإنَّ مقتضاه: أنَّ العلماء قد غشُّوا الأمة وخدعوها، حيث ضيَّقوا ما وسَّعه الإسلام، وبدَّعوا أهل العلم والإيمان العاملين بالسنَّة والأحكام، وعدُّوا من خرج على الإمام مطلقًا مبتدعًا خارجيًّا مستحقًّا للتغليظ والعقوبة والهجران!
الوجه السابع:
أننا نطالب الدكتور جاسم الجزاع أن يُسمّي لنا علماء أهل السنَّة والجماعة الذين جعلوا مسألة الخروج على الظلمة تابعةً للمصالح والمفاسد، وليست مسألة محكمة، فإنَّ الدكتور أطلق هذا القول، وجعله قولًا لأهل السنَّة والجماعة جميعهم لا بعضهم، فاستعمل عبارات الإطلاق، فليذكر لنا نصوصهم، وليس أفعال آحادهم، إذ إنَّ الفعل تَرِدُ عليه الاحتمالات، فقد يخرجُ عالمٌ في وقت من الأوقات بسبب ما يراه من الكفر لا الظلم، وقد يكون متأوَّلًا، ونحو ذلك. فالمقصود أن يذكر عن مجموعة من علماء أهل السنَّة والجماعة إلى عصرنا هذا من ينصُّ على أنَّ المسألة راجعة إلى تقدير المصالح والمفاسد.
الوجه الثامن:
أننا لو تنزلنا، وقلنا بإنَّ مسألة الخروج على الحاكم الظالم، ترجع في حكمها والإقدام عليها إلى المصلحة والمفسدة، فإلى من يرجع هذا التقدير، هل يرجع إلى عامة الناس، أم إلى السياسيين، أم إلى الأكاديميين، أم إلى عموم طلبة العلم والدعاة؟
لا ريب أنَّ المسألة لو كانت راجعة إلى تقدير المصالح والمفاسد، فإنَّ هذا التقدير مردُّه إلى مَنْ جَمَعَ أربعة أمور:
الأمر الأول: العلم بالشرع وقواعده وكليَّاته ومقاصده، وترتيبها في الأولوية، ومنزلتها من الدين، وهذه هي مرتبة الرسوخ في العلم.
الأمر الثاني: العلم بالواقع، وتصوُّره تصوَّرًا صحيحًا.
الأمر الثالث: الخبرة والحِنكة والإحاطة بمبادئ الأمور وعواقبها، وعوامل قيام الدول وسقوطها، وأسباب الفتن وآثارها وغوائلها.
الأمر الرابع: الديانة والتقى، وهو أعظم أسباب التوفيق والهداية إلى الصواب.
فمن لم يكن عالمًا بالشرع ومقاصده وكليّاته، فقد يُقدّم ما أخَّره الشرع، ويؤخر ما قدّمه الشرع، فيفعل مباحًا ويترك واجبًا، أو يأتي بواجب ويترك ما هو أوجب منه، أو ينكر منكرًا، ويقع فيما هو أنكر منه، وعند التعارض قد يُقدِّم أعلى المفسدتين ويترك أدناهما، ويترك أعظم المصلحتين ويفعل أدناهما. وقد سبق الإشارة إلى ذلك.
ومن لم يكن عالمًا بالواقع، متصوِّرًا له، لم يهتد إلى ما يوافقه من الأحكام، فإنَّ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوّره.
ومن لم يكن ذا خبرة وتجرِبة واطّلاع ودراية ومعرفةٍ بمبادئ الأمور، وأسباب الفتن، وعواقب الأحداث، وآثارها، قد يُفسد ولا يُصلح، ويهدم ولا يبني، وقد قال تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور}، وقال: {أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}.
ومن لم يكن ذا ديانة وتقوى تحجزه عن اتباع الهوى، وتحول بينه وبين الانسياق وراء دوافع النفوس وطلب الانتقام والتشفي، أو تقديم المصالح الخاصة على العامة ونحو ذلك، كان فريسة للهوى والنفس والشيطان. قال تعالى: {وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}، وقال تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ}.
وفي مثل ذلك قال تعالى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}.
قال السَّعدي -رحمه الله- في تفسيرها: (بل يردُّونه إلى الرسول، وإلى أولي الأمر منهم، أهلِ الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها… وفي هذا دليلٌ لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحثٌ في أمر من الأمور، ينبغي أن يولَّى مَنْ هو أهل لذلك، ويُجعل إلى أهله، ولا يُتقَدَّم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ). «تفسير السعدي»
فعلى هذا، فلا يحلُّ أن يتولَّى الكلام في هذه الأمور العامة، والحكمَ بما يجب فعلُه فيها، وما ينبغي الإقدام عليه، أو الإعراض عنه من الأمور والمواقف، إلا أهل الرسوخ في العلم والخبرة والديانة والإحاطة بالواقع. أما أن تُجعل لمن لا علم عنده، أو لضعيف الديانة، أو لقليل الخبرة، أو للشباب والمتحمِّسين، فهذا هو الهلاك بعينه.
فكيف والمسألة نصيَّةٌ إجماعيّةٌ؟!
الخطأ الثاني:
أشار الدكتور إلى ثورة عامة أهل العراق على الحجَّاج بن يوسف الثقفي في فتنة ابن الأشعث، وبيَّن أنَّ فتنتهم عليه لم تُؤت أكلها، بل باءت بالفشل، حيث أريقت فيها الدماء، وانتهكت المحارم، دون أن يتحقق المقصود من الثورة والخروج، ثم قال: إنَّ السلف بعد فشل تجربة الخروج على الظالم، قالوا: دعونا نرجع إلى الأصول النبوية، فوجدوها تأمر بالصبر على الظالم ونحو ذلك.
فأقول: هذا طعنٌ في السلف، وتناقضٌ من الدكتور.
فإنَّ مفهوم كلامه أنَّ الخارجين على الحجَّاج، ومنهم العلماء الذين سمَّاهم كسعيد بن جبير وغيره، قد خرجوا على الحجاج قبل النظر في النصوص الشرعية في باب التعامل مع الحكام الظلمة، فأقدموا على مثل هذا الأمر العظيم، وأراقوا الدماء بغير علم ولا بيّنة، ودون أدنى نظرٍ في النصوص. وهل هذا إلا اتهامٌ للسلف بالجرأة على الدماء والجهل بالشرع؟! فلا أدري هل يَتصوَّرُ الدكتور ما يَخرُجُ من لسانه!
ثم إنَّه تناقض منه من عدة أوجه:
منها: أنَّه استدلَّ بخروج أمثال هؤلاء العلماء على الحجاج في تقرير جواز الخروج على الظالم للمصلحة، وهو ما عدَّه مذهبًا للسلف كلَّهم!، ثم هو هنا يُقرر أنهم إنما فعلوه قبل النظر في النصوص النبوية، والآثار السلفية، فكان فعلُهم -على مقتضى كلامه- غير مبنٍّي على دليل، فكيف يكون القول الذي لم يُبنَ على النصوص والدلائل قولًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مذهبًا للسلف؟!
ومنها: أنَّ ادّعاءه رجوع علماء العراق إلى النصوص النبوية بعد فشل التجرِبة، ووقوفهم على ما جاء فيها من الصبر على الظالم، يُؤكد أنَّ النصوص تنهى عن مثل فعلهم، وتمنع من الخروج على الظلمة، وهو إقرارٌ من الدكتور بأنَّ النصوص تؤكَّد وتنصُّ على خطأ فعلهم بالخروج، فكيف يكون الخطأ عند الدكتور قولًا سائغًا، فضلًا عن أن يكون مذهبًا للسلف.
الخطأ الثالث:
ذكر الدكتور جاسم الجزاع أنَّ منكر الحاكم نوعان: قاصر ومتعدٍّ، أما القاصر فكفسقه وتقصيره، وأما المتعدي فهو ما يتعدى إلى الرعية، كسنِّ القوانين المخالفة للشرع، ووجود الفساد الحكومي والإداري، ونحو ذلك، ثم أشار إلى حديث إسرار النصيحة للحاكم، وهو حديث: «من أراد أن ينصح لذي سلطان، فلا يُبده علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلوا به، فإن قَبِل منه فذاك، وإلا كان قد أدَّى الذي عليه». فزعم أنَّ الحديث محمولٌ على فسق الحاكم القاصر لا المتعدِّي.
ثم ذكر أن المنكر المتعدِّي نوعان: ما يَعلمُ الناس نكارته ومخالفته للشرع، وما قد يجهلون حكمه، فأمَّا الأول فقد يُقال فيه: لا حاجة إلى الإنكار العلني فيه، وذكر المثالب، لِعِلْمِ الناس بمخالفته للشرع، وهو كافٍ في بعدهم عنه واجتنابهم له، وأما الثاني فيجب إنكاره علنًا، لأنَّ المصلحة تقتضيه.
فأقول: ليت الدكتور يُحيلنا إلى الموضع الذي استقى منه تخصيص حديث مناصحة الحاكم سرًّا بالمنكر القاصر دون المتعدِّي؟ فإنَّ الحديث عام، وقد بوَّب العلماء عليه: باب كيف نصيحة الرعية للولاة؟، ولم يخصُّوه بنوعٍ من المنكر.
نعم، لو قيَّد الدكتور إظهار الإنكار على الولاة أو الإسرار بالمصلحة، لكان له وجهٌ، على كونه مخالفًا للنصِّ، أما التفريق بين القاصر والمتعدِّي فلا وجه له من هذه الجهة.
ومن أوهام الدكتور في هذه المسألة: أنَّه لم يُفرِّق بين إنكار المنكر نفسه، والإنكار على صاحب المنكر، حيث زعم أنَّ السلفيين المعاصرين يسكتون عن المنكرات العامَّة التي تكون بأمر السلطان، كالقوانين المخالفة للشرع، أو الظلم الواقع على فئة من الناس، أو الفساد الإداري أو المالي، ونحو ذلك، وهذا تقوُّل منه، وخلطٌ بين صور المسائل، فإنَّ أهل السنَّة والجماعة لا يسكتون عن منكرٍ أبدًا، بل يُنكرون المنكر، ويُحذِّرون منه، مهما كان فاعله، حتى لو كان واقعًا من السلطان، لكنَّهم في الإنكار على السلطان، يُنكرون المنكر نفسه، دون التعرِّض لشخص السلطان، فيُنكرون الزنا، وشرب الخمر، وتحكيم القوانين الوضعية، ويُنكرون الفساد، والظلم، والقوانين التي تُسنَّ مخالفًة للشرع، دون أن يُسَمُّوا السلطان.
قال عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: (ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فيُنكر الزنا، ويُنكر الخمر، ويُنكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة. ويكفي إنكارُ المعاصي والتحذيرُ منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكمًا ولا غير حاكم…
ثم ذكر الشيخ فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم قال: وقُتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني، وذِكر العيوب علنًا، حتى أبغض الكثيرون وليَّ الأمر وقتلوه). «مجموع فتاوى ابن باز» ٨/٢١١
وقال العثيمين -رحمه الله-: (أما المنكرات الشائعة فأَنْكِرْها، لكن كلامنا على الإنكار على الحاكم، مثل أن يقوم الإنسان -مثلاً- في المسجد، ويقول: الدولة ظلمت، الدولة فعلت، فيتكلم في نفس الحكام، وهناك فرقٌ بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك، وبين أن يكون غائباً؛ لأنَّ جميع الإنكارات الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم. وهناك فرق بين كون الأمير حاضراً أو غائباً…. أنا أريد مثلاً أن أقول للناس: اجتنبوا الربا، ويأتي ويقول: هذه بيوت الربا معلنة ورافعة البناء، فلا يقول هكذا، يعني: هذا إنكارٌ ضِمنِيٌّ على الولاة، لكن يقول: تجنَّبوا الربا، والربا محرم، وإن كثر بين الناس، الميسر حرام وإن أُقرَّ، وما أشبه ذلك). «لقاء الباب المفتوح» ج٦٢ ص١٣
فالمقصود من إنكار المنكرات، هو: تحذيرُ الناس منها لِتُجتنب، وهذا يحصل بإنكار المنكر نفسه، وبيان نكارته ومخالفته للشرع، ظلمًا كان أو فسقًا، مع قطع النظر عن فاعله. فإن كان واقعًا ممن هو دون الحاكم، فإنه موجبٌ للعقوبة المقدَّرة شرعًا أو التعزيرية، وهذا من شأن القضاة والولاة، فيدخل في الإنكار حينئذٍ رفعُ الدعاوى على الفاسدين والظالمين، ويُناصحُ الولاة في عقوبتهم ومنعهم من منكراتهم، دون أن يُفتأت عليهم فيه.
نعم، قد يَصْدُقُ كلام الدكتور في منع إنكار منكرات الحكام مطلقًا، بتسمية وغير تسمية، على فئة تنتسب إلى السلفية، لكنَّها فئة شاذَّة لا تُمثَّل إلا نفسها، وليست من السلفيّة في شيء.
الخطأ الرابع:
ذَكَرَ الدكتور في سياق كلامه على مسألة الخروج المسلَّح على الحاكم، وأنَّها منوطة بالمصلحة، نجاح بعض الثورات، ومَثَّل بثورة العباسيين على الأمويين.
فأقول: إنْ كان معيار نجاح الثورات عند الدكتور هو الوصول إلى الحكم، مع قطع النظر عن الآثار المترتبة عليه، والطريقِ الذي سُلك لتحقيقه، فبئس الميزان.
فإنَّ الثورة العباسية لم تقم إلا على أشلاء ودماء مئات الآلاف من المسلمين، حتى إنَّ المؤرخين كالطبري وغيره ذكروا أنَّ من قُتلوا صبرًا -أي: مُقيَّدين- في تلك الثورة على يد أبي مسلم الخراساني بلغوا ستمائة ألف مسلم، فضلًا عمَّن قُتل في المواجهات والمعارك. ناهيك عن قتل ما يقرب من خمسين ألفًا من أهل دمشق على يد أبي العباس السفاح عند دخول دمشق، حتى ذكر المؤرخون أنه دعا بالبُسْط فبَسَطَها على جثث القتلى، ثم جلس فوقهم، ودعا بطعامه.
فأيَّ نجاح حصل، وأي مصلحة تحقَّقت؟!
الخطأ الخامس:
ذكر الدكتور أنَّ الإنكار العلني على ممارسات السلطة والحاكم لا علاقة لها بالخروج المسلَّح أبدًا، وعاب على من حذَّر منها لهذا السبب.
فأقول: وهل يكون خروجٌ مسلَّح على حكومة أو حاكم إلا وقد سبقه الإنكار العلني، وذكرُ المعايب والمساوئ، والتشنيعُ بها عليه.
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «تكون فتنة تَسْتنظِفُ العرب، قتلاها في النار، اللسان فيها أشدُّ من وقْعِ السيف». رواه أحمد
وقد عقد أبو عمرو الداني -رحمه الله- بابًا في ذم الكلام في الفتنة في كتابه «السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها»، أورد فيه أحاديث وآثارًا، منها قول ابن عباس رضي الله عنهما: (إنما الفتنة باللسان، وليست باليد).
وقال عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: (ولما فَتَحَ الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه، وأنكروا على عثمان علنًا، عَظُمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقُتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقُتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني، وذِكرِ العيوب علنًا، حتى أبغض الكثيرون من الناس وليَّ أمرهم وقتلوه، وقد روى عياض بن غنم الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه»). «مجموع فتاوى ابن باز» ٨/٢١١
الخطأ السادس:
نَقَلَ الدكتور عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّه يرى أنَّ من صلاحيات نظام الحسبة في الإسلام تقويم ممارسات السلطة والحاكم.
فأقول: هلَّا أوقفنا الدكتور الفاضل على موضع كلام ابن تيمية؟! وهذا من جملة جراءة الدكتور في حكاية الأقوال ونسبتها إلى العلماء.
فإنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية قد بيَّن أنَّ ولاية الحسبة تختلف اختصاصاتها بحسب الأمكنة والأزمنة والأحوال، وأَنَّ هذه الاختصاصات تُعرف إمَّا مِنْ أَمْرِ الوالي أو من جهة العرف، فقال -رحمه الله- في مسؤولية المحتسب: (عمومُ الولايات وخصوصها، وما يستفيده المتولِّي بالولاية يُتَلقَّى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حدٌّ في الشرع، فقد يدخل في ولاية القضاة في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر، وبالعكس، وكذلك الحسبة وولاية المال…
إلى أن قال: وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم، وكثيرٌ من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور، فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه). «الحسبة في الإسلام» ص١٥
فتقويم ممارسات الحاكم ليست من اختصاصات نظام الحسبة، بل يقوم به أهل الشأن والعلم بالطرق الشرعية، عن طريق المناصحة والمراسلة والإنكار بين يدي السلطان، وكذلك الإنكار العام في المنكرات العامة كما أسلفنا، دون تعيين الحاكم أو السلطان.
وأما السلطة فإن أريد بها الحكومة والوزراء، فهؤلاء لهم نصيبٌ من الولاية بقدر مناصبهم، فإنَّ السلطان إنما يأمر وينهى من خلالهم، لكن ليس لهم الولاية التامة، ومن هنا فإنه يجوز شكايتهم عند السلطان، ومطالبته بعزلهم عند وجود ما يستدعي ذلك من الظلم أو الفسق أو عدم الكفاءة، فإنْ جَعَلَ السلطان عليهم هيئة أو أشخاصًا معيّنين يراقبون أعمال الحكومة ويُقوِّمونها، كالمجالس النيابية في بعض البلاد ونحوها، فهؤلاء لهم ولاية في تقويم ومحاسبة الحكومة بقدر ما ولَّاهم الحاكم، فيمارسون ما خُوِّلوا به، فإن خوِّلوا بعزلهم، ومحاكمتهم ومحاسبتهم، فلهم ذلك، لأنَّهم إنما يقومون بذلك نيابة عن السلطان والحاكم وبحكم ما ولَّاهم.
الخطأ السابع:
قد أطلق الدكتور جاسم الجزاع على أصول الإسلام، وعلى أصل الإمامة والجماعة بالخصوص مصطلح: «نظرية»، والنظرية كما لا يخفى مشتقَّة من النظر، وهو نظرُ العين ونظرُ القلب كما عرَّفه ابن منظور، على أنَّ الاستعمال المعاصر لها يختلف من جهة الدلالة باختلاف الفنون، وعامة الباحثين يفسروها بأنها: مجموعة من العبارات والرؤى تفسر سلسلة من الأحداث، كما ذكره بوشامب. وفي العلوم الطبيعية، تطلق النظرية على محاولة تفسير عدد من الفروض أو قوانين الطبيعة، ووضعها في إطار عقلي عام.
وفي كلام علماء الشرع، يُطلق النظر في مقابل السَّمع، فيُقال إنَّ الدلائل نوعان: سمعية ونظرية، فأما السمعية فهي النصوص، وأما النظرية فهي المستنبطة أو المستخرجة بالاستنباط والقياس ونحو ذلك.
ومعلومٌ أنَّ مسائل الإمامة والجماعة، مسائلُ نصيَّة سمعية، لم تُعرف بالقياس والنظر، فضلًا عن التجرِبة. وقد اتفق العلماء على أنَّ كلَّ قياسٍ ونظرٍ يؤول إلى إبطال دلالة النصوص فهو قياسٌ فاسدٌ، وهو الرأيُ الذي ذمَّه السلف، وجعلوه مصادمًا للنصِّ.
قال ابن القيّم -رحمه الله-: (النصوصُ محيطة بأحكام الحوادث، ولم يُحِلْنا الله ولا رسوله على رأي ولا قياس، بل قد بَيَّن الأحكام كلها، والنصوص كافية وافية بها، والقياس الصحيح حقٌّ مطابق للنصوص، فهما دليلان للكتاب والميزان، وقد تخفى دلالة النص، أو لا تبلغ العالم، فيعدل إلى القياس، ثم قد يظهر موافقًا للنصِّ فيكون قياسًا صحيحًا، وقد يظهر مخالفًا له فيكون فاسدًا). «إعلام الموقعين» 1/337
وعلى هذا، فإطلاق مصطلح «النظرية» على أصول الإسلام النصيَّة الإجماعية المدوَّنة في كتب عقائد أهل السنَّة والجماعة، حتى لو أراد بها الدكتور معنًى صحيحًا، لا شكَّ أنه يفتح الباب لنقدِ هذه الأصول، وجعلِها عرضةً للمناقشة والقبول والردِّ والتأويل والتحريف، وهو عينُ ما فعله الدكتور -هداه الله- حيث سلَّط سهام التأويل، بل التحريف، على دلالات النصوص السمعية وإجماعات السلف النصيّة في اعتبار أصل السمع والطاعة ولزوم الجماعة بتحريم الخروج على الحاكم الظالم، باعتبار أنها نظرية من النظريات، فزعم أنَّ من حرَّم الخروج على الحاكم المسلم بالظلم فإنه أخذ بنظريةٍ من النظريات في هذه المسألة، وهي النظرية التي تقول: لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم بمجرد الظلم، ومن جوَّز ذلك، فقد أخذ بالنظرية الأخرى التي تجعل مناط الحكم راجعًا إلى تقدير المصالح والمفاسد.
أقول: وبمثل هذه التأويلات والتحريفات والتلاعب بالمصطلحات حُرَّفت الأصول، وهُدمت الثوابت قديمًا وحديثًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الخطأ الثامن:
زعم الدكتور جاسم الجزاع أنَّ المذاهب إنما انتشرت بسبب تَبنِّي الدولة لها، وادَّعى أنَّ مذهب الأوزاعي لم ينتشر لعدم وجود دولة تبنَّته، والسبب أنَّه كان ميَّالًا للحياد في الصراعات السياسية، ثم أفاض في ذكر منزلة الأوزاعي عند ولاة زمانه، وقربه منهم، مع قيامه بالحق، وإنكاره عليهم ما يراه باطلًا، وعدم مداهنته لهم.
فأقول: إنَّ الدكتور قد وقع في مجازفة وتناقض، فأمَّا مجازفته فَزَعْمُه أنَّ المذاهب لم تنتشر إلا بتبني الدول والحكومات، وهذا وإن كان أحد أسباب انتشار المذاهب، لكن ليس شرطًا، فضلًا أن يكون السبب الوحيد، فإنَّ عوامل انتشار المذاهب، سواء الأربعة الباقية، أو المنقرضة كمذهب الثوري والأوزاعي والليث والمذهب الظاهري، متعددة، منها: كثرة الأتباع والأصحاب، ومنها: تولّي القضاء، ومنها: قوة الحجة، وغير ذلك من العوامل.
قال الذهبي -رحمه الله- في ترجمة الأوزاعي: (وكان له مذهبٌ مستقلٌّ مشهور، عمل به فقهاء الشام مدةً، وفقهاء الأندلس، ثم فَنِيَ). «سير أعلام النبلاء» 7/117
وقال الدكتور عبد القادر بوعقادة: (كان الأوزاعي إمامَ أهل الشام بإجماع المؤرخين، وقد لبث أهل الشام إلى أواسط القرن الرابع الهجري يعملون بمذهبه، فكان لا يلي القضاء ولا الخطابة بجامع بني أمية إلاّ من كان على مذهبه، وكان آخر من عمل بالمذهب الأوزاعي القاضي أحمد بن سليمان بن حذلم المتوفى سنة 347هـ/958م.
ويروى أنّ مذهبه بقي منتشرًا في بلاد الشام، ولم يُقض عليه إلاّ بعد أن تطور مذهب الإمام الشافعي، وانتشر في العراق والحجاز ومصر ووصل إلى الشام، وصار قضاء الشام شافعيًّا… كما انتشر المذهب الأوزاعي في أماكن أخرى، أهمها بلاد المغرب والأندلس، إذ دخل المسلمون بلاد الأندلس أيام موسى بن نصير…
انقرض مذهب الأوزاعي بالأندلس بعد دخول مذهب الإمام مالك إليها، وكان أول من أدخله زياد بن عبد الرحمن اللخمي المعروف بشبطون المتوفى سنة (193هـ/808م)). «الإمام الأوزاعي ودوره الاجتماعي والسياسي»
فأمَّا دعوى عدم انتشار مذهب الأوزاعي لإعراض الدولة عن مذهبه بسبب ميله إلى الحياد في الصراعات السياسية، فهذا من غرائب الدكتور، وما أكثر غرائبه وعجائبه، فهل يُفهم منه أنَّ انتشار مذهب مالك والشافعي وأحمد إنما كان بسبب دخولهم في الصراعات السياسية؟! فهلا دلّنا الدكتور على تلك الصراعات، وأبان لنا الفوارق بين منهج الأوزاعي ومنهج هؤلاء الأئمة في الصراعات السياسية.
وهل انتشر مذهب الإمام أحمد -على سبيل المثال- بسبب دخوله في الصراعات السياسية؟!
لا يخفى على من اطلع في تراجم هؤلاء الأئمة بطلان هذه الدعوى، فإنهم كانوا أبعد الناس عن الصراعات السياسية. والكلام في أسباب انتشار مذاهبهم يطول، ويخرج بنا عن المقصود.
والذي يظهر أنَّ الدكتور لم يستنبط هذه المعلومة ويتوصَّل إليها من مجرد قراءته في سير هؤلاء العلماء والأئمة، وإنما تلقَّاها من بعض كتابات المعاصرين الميَّالين إلى النشاط السياسي، ممن يحللّون الأحداث التاريخية والمواقف ويطوّعونها لتكون وفق أهوائهم وميولهم، لا وفق أصول وقواعد النقد والتحليل.
وأما تناقضه، فذلك أنَّه عزا عدم انتشار مذهب الأوزاعي إلى حيادِه في الصراعات السياسية، وعدمِ تبني الدولة لمذهبه، ثم ذَكَرَ قُرْبَه من الولاة، ومخالطته لهم، وقبولَهم لنُصْحِه وإنكارِه، وتقديمَهم له، بما لم يَحصُل مِثلُه ولا قريبٌ منه من أئمة المذاهب الأربعة. فكيف تتبنى الدولة مذاهب من اجتنبهم وابتعد عن مجالسهم، وتترك تبنِّي مذهب من يخالطُهم، ويجتمعُ معهم، ويُقدِّمونه على غيره، ويقبلون كلامه ونصحه ويُقيمون له وزنًا؟! هذا تناقض. فإنْ كان من أعظم أسباب انتشار المذاهب تبني الدول لها -حسب زعم الدكتور، لوجب أن يكون مذهب الأوزاعي أكثرها انتشارًا. فتأمَّل.
أمَّا ما يتعلَّق بإفاضة الدكتور في ذكر مواقف الأوزاعي وسيرته، فإنَّ مقصوده بذلك ذِكرُ مواقفِه من منكرات الولاة، وقيامِه بالنصح والإنكار، ليستدلَّ بها على ما وجوب الإنكار علنًا على ولاة هذا الزمان بلا خروج ورفع سلاح. لكنَّ الدكتور غفل عن أنَّ جميع ما ذكره من مواقف الأوزاعي من ولاة زمانه، وإنكاره عليهم، إنما كان بين أيديهم، وفي مجالسهم، ولم يكن في الخطب والندوات، وفي المجالس العامة عند الناس، فضلًا عن نظم الأشعار، أو كتابة المقالات العامة.
والذي يظهر أنَّ مقصود الدكتور جاسم في حياديّة الأوزاعي في الصراعات السياسية، هو عدمُ ميله إلى الحكام، وتركُ دفاعه عنهم، فكأنَّ الدكتور يُعرِّضُ بالدعاة الذين يدافعون عن الحكام والحكومات اليوم ويقفون معهم، عند وجود الخلافات السياسية في بلادهم، كما هو الحال عندنا في هذه الأيام، فإنْ كان هذا مقصوده، فإنَّ الدفاع عن الحكومة والتماس الأعذار لها ليس مذمومًا على الإطلاق، ولا ممدوحًا على الإطلاق، بل يُمدح إن كان بحقٍّ، ويُذمُّ إن كان بباطل، دون أن يكون ذلك ديدنًا وشغلًا شاغلًا، وأما النهيُ عن الثورة والخروج عند وجود أسبابه ومقدٍّماته، فهذا واجبٌ متعيّنٌ على أهل العلم والدعاة، وداخلٌ في أعظم صور إنكار المنكر، وأعظم أنواع النصيحة، لما فيه من حفظ الجماعة ووحدتها.
الخطأ التاسع:
ادّعى الدكتور -عفا الله عنا وعنه- أنَّ طاعة الأمراء في هذا العصر ليست طاعة تعبّدية، وإنما طاعةٌ منوطةٌ بالمصلحة، من باب التنظيم، لا من باب الطاعة والعبادة، ونَسَبَ هذه الدعوى إلى الشيخين: ابن باز والعثيمين.
وهذا التفريق الذي زعمه إنما هو باعتبار أنها حكومات لا تحكم بالشريعة، بل قد استبدلتها بغيرها، وأمَّا من سبق من حكومات المسلمين في الماضي فإنها عطَّلت الحكم بالشريعة، ولم تستبدله.
فأقول: وهل التعبّدُ إلا طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}. وقال تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ}.
فإنَّ المؤمن إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اسمع وأطع وإن ضُرب ظهرك وأُخذ مالك»، فما عساه أن يعتقد حينما يستجيب لهذا الأمر النبوي، أتراه يفعل ذلك تعبّدًا لله وطاعة لرسوله؟ أم يفعله من جهة التنظيم والمصلحة؟!
فالذي قاله الدكتور ليس إلا تحريفًا للدين، ولمفهوم العبادة والطاعة!
إلا إنْ كان الدكتور يرى أنَّ الحكومات اليوم حكوماتٌ كافرة، فحينها يستقيم كلامه، فلا تكون طاعتها إلا على وجه التنظيم لا التعبُّد، لأنها حكومات خارجة عن الإسلام.
أمَّا إن كان لا يرى فعلها كفرًا بالله، بل معصيةً وظلمًا، فهي إذًا داخلة في جميع الأحاديث التي جاءت بوجوب السمع والطاعة، والصبر على جور الحاكم، وإن أُخذ المال، وضُرب الظهر بغير حقٍّ، ووقع الظلم، على ما سبق الإشارة إليه، فبأي وجهٍ يُخرج هذه الحكومات عن تلك الأحاديث، طالما أنها لم تخرج عن الإسلام؟ فإنَّ الأحاديث عامَّة في الظلم، لم تستثن من الصبر على الجور إلا الكفر البيّن البواح، حيث جَعَلَتْهُ غاية الصبر ونهايته، كما في حديث عبادة رضي الله عنه: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان».
قال ابن بطال -رحمه الله-: (قوله: «وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا» فدلَّ هذا كلُّه على ترك الخروج على الأئمة، وألا يشق عصا المسلمين، وألا يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريم، إلا أنْ يَكْفُرَ الإمام، ويُظهرَ خلاف دعوة الإسلام، فلا طاعة لمخلوق عليه). «شرح البخاري» ١٠/٩
فأمَّا دعواه أنَّ هذا هو قول الشيخين: ابن باز والعثيمين، فهو من جملة المجازفات عند الدكتور في إطلاق الأقوال، ونسبتها إلى العلماء بلا بينة ولا برهان.
ونحن نطالب الدكتور أن يُوقفنا على نصوص الشيخين في ذلك، بمثل ما ذكر ونسب إليهما.
ثم إنَّ تفريقه بين الاستبدال والتعطيل في مسألة الحكم، تفريقٌ باطل، فإنَّ من عطَّل الحكم بما أنزل الله، فقد حَكَم بغيره، فاستبدل الحكم بما أنزل الله بما حكم به، سواءٌ حَكَمَ برأيه، أو بعادته، أو بأي أمرٍ آخر، فإنَّ المعطِّل للأحكام، لم يكن فعلُه مجرد الترك، إذ لا بدَّ من حُكْمٍ يحكم به فيما عُرض عليه من الأمور والقضايا، فإذا تَرَك الحكم بالشريعة، فقد حَكَمَ بغيره، فأيُّ فرقٍ حينئذٍ بين هذا المعطِّل وذاك المستبدل، حيث أنَّ الجميع قد حكما بغير ما أنزل الله وعطَّلا حكم الله.
ومن أوهام الدكتور بهذا الخصوص، أنَّه لما أراد التفريق بين الطاعة التعبدية، والطاعة التنظيمية، مَثَّل بطاعة عمر بن العزيز، وقال: (لا نطيع طاعةً تعبدية، يعني ليس علينا عمر بن عبد العزيز الذي جمع بين الإمامة السياسية والإمامة الشرعية، حتى نتقرَّب إلى الله بِحُبِّه). فَجَعَل علامة الطاعة التعبّدية للحكام: التقرب إلى الله بحبّهم، وهذا خطأٌ ووهمٌ كبير، فإنَّ الطاعة: التزام الأمر واجتناب النهي، وليس الحبُّ من شرطها، فقد نطيعُ من لا نحبُّه، ونحبُّ من لا نطيعه. فليس من شرط طاعة الأئمة حبُّهم، وإنما يُحبُّ منهم التقيُّ الصالح. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويُصلُّون عليكم وتصلُّون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم»، قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة». فأثبت لهم الإمامة مع بُغضِ الناس لهم ولَعْنِهِم لهم، فلا تلازم بين طاعة الأمراء ومحبتهم.
ولو كان من لازم طاعتهم التعبّدية محبَّتُهم، فإنَّ من المعلوم أنَّ هذا لا ينطبق إلا على عدد قليل من الولاة في تاريخ المسلمين. فهل يُفهم من كلام الدكتور أنَّ جميع مَن نبغضهم، فإننَّا لا نطيعهم تعبَّدًا، بل تنظيميًّا للمصلحة؟!
لو كان الأمر على هذا النحو، لبَطَلَ تقييد الطاعة التعبدية -حسب زعمه- بالحكم بالشريعة من عدمه، ولكانت مرتبطة بالمحبَّة لا غير. فتأمل.
هذا ما أحببت بيانَه وتوضيحه، والنصيحةَ به، وكلِّي أملٌ أن يراجع الدكتور الفاضل أفكاره وأطروحاته، وألا يستقي شيئًا منها إلا من معين الكتاب والسنَّة وهدي سلف الأمة، وأن يحذر من كتب المفكرين وأنصاف المتعلمين، التي تُسمّم الأفكار، وتلوّث العقائد، وتُفسد الإيمان، وتَقلب الحقائق.
والله أسأل أن يُلهمنا رشدنا، وأن يرينا الحقَّ حقًّا ويرزقنا اتَّباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسًا علينا فنضل.
والله أعلم وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.