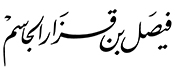الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فقد وقفت على مقطع قصير للشيخ خالد باحميد الأنصاري الحضرمي، وقد سُئل عن أبرز أخطاء شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأجاب إجابة أقلُّ ما يُقال عنها: أنها تنمُّ عن جهلٍ منه بحال الشيخين ومذهبهما. فقد كان الشيخ -هدانا الله وإياه- عريض الدعوى جدًّا، ولا أدري هل استوعب قراءة كتب الشيخين، أم أنه تلقف عن غيره، أم أنه قرأ مواضع من كلامهما من هنا وهناك فبنى عليه رأيًا وموقفًا، أم أنه أُتي من قلة الفهم وضعف التصور، أم بسبب قلة العلم، والاعتماد على القراءة المجردة التي يصحبها الخطأ غالبًا في تصور المسائل والتمييز بينها. الله اعلم بحقيقة الحال.
وأنا في هذا اللقاء سأعلق تعليقًا مختصرًا على الفِرى التي افتراها، والدعاوى التي أطلقها -هدانا الله وإياه- بلا زمام ولا خطام، وأحيل إلى المواضع التي يجد فيها الراغبُ المسائلَ والدلائلَ على وجه التفصيل:
افتراؤه على شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-
أولُ هذه الدعاوى والفِرى زعمُه: أنَّ أكبرَ أخطاء ابن تيمية: مزجُه بين السلفية والمذهب الظاهري، وأن هذا الأمر قد ترتب عليه الخروج عن المذاهب الأربعة وتسبب بفوضى كبيرة في الفتوى.
فأقول: هذه الدعوى والفرية وحدها كافيةٌ في بيان حال هذا المتكلم ومعرفةِ مدى ضبطه للمسائل ودرجة تصوره لها، ومدى إلمامه بمذاهب العلماء، فإنَّ كل من قرأ كتب ابن تيمية وعرف حالَه، يعلم علم اليقين أنه لم يبتدع قولاً ليس له فيه سلف قط من الصحابة، أو التابعين، أو أتباعهم، أو الأئمة المتبوعين بعدهم، قبل وجود ما يُعرف بالمذهب الظاهري.
وابن تيمية رحمه الله لم يكد يخرج عن أقوال المذاهب الأربعة إلا قليلا، وقلما يختار قولًا خارجًا عن المذاهب الأربعة إلا وتجد للإمام أحمد له فيه رواية، وما من مسألة اختارها شيخ الإسلام ولم يقل بها أحد من الأئمة الأربعة، ولو رواية، إلا وتجد له فيها سلفًا عمن هم في منزلة الأئمة الأربعة أو أرفعُ؛ كالتابعين والصحابة رضي الله عنهم.
وحتى يصحح الشيخ باحميد دعواه، فنحن نطالبه أن يذكر لنا مسألة واحدة قال بها ابن تيمية ليس له سلفٌ فيها إلا الظاهرية؟ فإذا لم يوجد -وهو الواقع- بطلت دعواه من أصلها. هذا ما يتعلق في كلامه على ابن تيمية.
افتراءاته على الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-
أما افتراؤه على الإمام محمد بن عبد الوهاب، ودعاواه فهي أكبر وأكثر وأخطر، فقد ادعى -هدانا الله وإياه- أن أكبر خطأٍ للشيخ محمد بن عبد الوهاب هو التكفير، وزعم أن له ثلاثَ مسائل يظهرُ فيها التكفيُر أكثرُ من أيِّ مسألة أخرى.
أما المسألة الأولى: فهي القول بأن دعاء الأموات شركٌ بإطلاق، وزعم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب هو أول من قال بهذا القول، وزعم أن الأوائل -كما يدّعي- عندهم فيها تفصيل، وأن ابن تيمية يقول بأن دعاء الأموات قد يكون شركًا وقد يكون ذريعة للشرك.
والشيخ -عفا الله عنا وعنه- لم يذكر صورة المسألة، ولم يُبين ما هو الدعاء الذي يكون شركًا، وما هو الذي يكون ذريعة للشرك. وإنما أطلق الكلام دون تفصيل وبيان.
وتعليقي على هذه الدعوى والفرية أن أبيّن أولًا: أن الدعاء عبادةٌ من أجل العبادات، قال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين}، وقال: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا}، وفي الحديث: (الدعاء هو العبادة).
وقد أجمع المسلمون أن دعاء الميت وسؤاله وطلب الحاجات منه شركٌ أكبر، وعبادةٌ للمدعو، وفي ذلك يقول تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ} فسمى الله دعاء الميت عبادةً له.
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ}، فبيّن تعالى أن الميت لا يسمع الدعاء، ولم سمع لم يستطع الإجابة، وأنه يتبرأ ممن دعاه، ثم أكّد تعالى أن دعاء الميت شرك بقوله: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ} أي: بدعائكم إياهم.
ومن ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} .
ولا أريد في هذا اللقاء بسطَ هذه المسألة بالدلائل، لكن من أرادها طلبها من مظانها وهي كثيرة.
وأما دعواه أن الأوائل لهم في دعاء الميت تفصيلٌ، وأن ابن تيمية يرى أن دعاء الميت منه ما يكون شركًا ومنه ما يكون ذريعة، فهذا إن قصد باحميد بدعاء الميت: سؤالَه وطلبَ الحاجات منه، فهو محضُ افتراء وكذبٌ على الأوائل وعلى ابن تيمية، وإن أراد به أمرًا آخر، فهو لم يبينه ولم يوضحه، وإنما أطلق الكلام هكذا إطلاقًا.
على أنَّ الذريعة في هذا الباب إنما تكون بتعظيم القبر بدعاء الله بجانبه، وقصدِ القبر للتبرك بأداء العبادات كالصلوات والصدقات وغيرها من الطاعات، بأن تكون الطاعة بجانب القبر لا له، وهو ما نصّ عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد كما في باب (باب ما جاء في الغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده).
وأما إن قصد الشيخ باحميد بدعاء الميت: طلبَ الدعاء من الميت، مثل أن يخاطب الداعي الميت بقوله: يا فلان ادعُ الله لي، فهذه مسألةٌ مختلف فيها، منهم من يراها شركًا لعموم الأدلة الدالة على كون دعاء الميت شركًا، ومنهم من يراها بدعة وشركًا أصغر، لأن الميت لم يطلب من الميت حاجته، وإنما طلب منه أن يدعو الله له بحاجته، فالميت بهذا الاعتبار مطلوبٌ به لا مطلوبًا منه، وهذه المسألة بالخصوص من قبيل المسائل المختلف فيها، ولا أعرف للإمام محمد بن عبد الوهاب نصًّا فيها، وإنما كان نزاع الإمام محمد بن عبد الوهاب مع خصومه في دعاء الميت وسؤالِه العون والمدد والذبح له والنذر ونحو ذلك من العبادات التي يصرفها القبوريون للأموات.
أما إن عنى الشيخ باحميد بكلامه في مسألة دعاء الميت، وما ادعاه من أن الأولين لهم فيها تفصيل، هو ما يدّعيه المشركون القبوريون، من أنَّ: دعاء الميت والاستغاثة به لا تكون شركًا إلا مع اعتقاد التأثير في المدعو أو مِلك النفع والضر أو شيءٍ من الربوبية، وأنا أستبعد بلا شك أن يقصد الشيخ بكلامه هذه المسألة، لأن هذا القول كفرٌ بالله بالكتاب والسنة والإجماع، فإنَّ مَن زعم أن عبادة الأموات بالذبح والنذر والدعاء لا تكون شركًا إلا أن تكون مصحوبة باعتقاد الربوبية في المدعو أو قدرتِه على التأثير أو مِلكه النفعَ والضر، فهذا مروقٌ من دين الإسلام، وهذا هو الوثنية بعينها، وهو دين المشركين الذي ذكره الله تعالى في غير موضع من كتابه عنهم، وأنهم لم يعتقدوا في معبوداتهم المتنوعة كالأولياء والملائكة والأحجار والأشجار شيئًا من الربوبية أو القدرةَ على التأثير أو ملكَ النفع والضر، كما في قوله تعالى: {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ} والآيات في هذا كثيرة، وقد قال تعالى {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}، فأثبت لهم إيماناً وشركًا، وقد فسره ابن عباس وغيره: أنه يقرون لله بالربوبية وأن يخلق ويرزق ومع ذلك يعبدون مع الله غيره.
والكتب في هذه المسألة بالخصوص كثيرة جدا، ولي حلقتان منشورتان في الرد على الدكتور حاتم العوني في هذه الضلالة بالخصوص، وهي موجودة في قناتي على اليوتيوب.
أما المسألة الثانية التي ادعاها الشيخ باحميد من مسائل التكفير عند الإمام محمد بن عبد الوهاب فهي: مظاهرة الكفار على المسلمين، فقد ادعى أن مظاهرة الكفار على المسلمين ومساعدتهم عند الإمام محمد بن عبد الوهاب كفرٌ بإطلاق، بأيِّ نوع من أنواع المساعدة والمظاهرة، وقال بالنص: مسلمٌ ساعدتَ كافرًا أيَّ مساعدة تلحق ضررا بالمسلمين فأنت بذلك تَكفُر -أي عند الإمام محمد بن عبد الوهاب.
وزعم أيضًا أن السلف إنما يعتبرون المقاصد في مسألة المظاهرة، وأنَّ العبرة عندهم بالاعتقاد، فإن كانت المظاهرةُ دينيةً بقصد نصرة دين الكفار فهي كفر، وإن كانت دنيويةً فليست كفرًا.
وليته -هداه الله- وقف عند الحد، بل زعم أن ابن تيمية له مذهبٌ آخر يختلف، وأن مِن مذهبه أن مظاهرة الكفار على المسلمين لا تكون كفرًا إذا كانت بالقتال فقط، وزعم أن هذا القول اذلي قاله ابن تيمية لم يُسبق إليه، هكذا يُطلق الدعاوى عفا الله عنا وعنه.
وهذا في الحقيقة جهلٌ منه، وضعفٌ في تصور المسألة، وقلةُ خبرة بأقوال السلف وأقوال ابن تيمية وأقوال ابن عبد الوهاب، وهو هداه الله يخلط بين المسائل، ويُدخل صورةً في أخرى مغايرةٍ لها، ويحسبُ أن الجميع مسألةٌ واحدة، وصورةٌ واحدة، ولم يكلف نفسه بتنقيح المناط في المسألة التي ذكرها وعمَّمَ الكلام فيها، وجعل المناطَ مطلقًا هو القلب والقصد.
أقول: لا بد أن نعلم أولاً أنَّ مظاهرة المشركين: هي أن يكون المسلمُ ظهرًا للكافرين وسندًا لهم يعينهم على المسلمين بما يحقق لهم الظهور والغلبة.
وقولُ الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة هو قولُ ابن تيمية وهو قولُ السلف، وهو قولٌ واحد، لا كما يزعمه باحميد ثلاثةَ أقوال.
والإمام محمد بن عبد الوهاب لم يقل أنَّ أيَّ مساعدة لكافرٍ مهما كانت تكون كفرًا، وإنما خصًّها بالمظاهرةَ التي تستلزمُ إظهارَ دينِهم، ونصرةَ كفرهم، وإعزازَ عقيدتهم، وتستلزم طمسَ التوحيد، وهدمَ أركانِ الإسلام وبنيانِه، مثلُ أن يظاهر المسلمُ الكفار والمشركين ويعينُهم على قتالِ أهل التوحيد ودعاتِه المجاهدين في سبيل تبليغه ونشره، يعينهم إما بنفسٍ أو مالٍ أو مشورةٍ، أو أن يذبَّ عنهم ويدافعَ عن عقيدتهم وشركهم، وهذا هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء قاطبة، وهو: أنَّ من ظاهر الكفار وأعانهم على قتال المسلمين مظاهرةً وإعانةً يظهر بها دينُهم ويعلو بها كفرُهم وترتفع بها شعاراتُهم وتعلو مناراتُهم فهو كافرٌ مثلهم، لأنَّ هذا النوع من المظاهرة نصرةٌ للكفر وتثبيتٌ للشرك، وطمسٌ للتوحيد، وهدمٌ لأركان الإسلام وبنيانه وثوابته.
فإن شئت فاقرأ قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}، والتولي هنا: هو توليهم في القتال والنصرةِ والذبِّ.
ولك أن تنظر في تفسير العلماء لهذه الآية، انظر ما قاله: الزجاج وابن جرير وأبو الليث السمرقندي ومكي بن أبي طالب وأبو منصور الماتريدي والواحدي والزمخشري وغيرُهم كثير من المتقدمين والمتأخرين.
وانظر أيضًا سبب نزول قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}، واقرأ ما قاله السدي وما ذكره المفسرون في تفسيرها.
وانظر سبب نزول قوله تعالى: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا} واقرأ ما ذكره ابن عباس في تفسيرها وما ذكره المفسرون في معناها.
وتأمَّل موقفَ الصحابة رضي الله عنهم من مانعي الزكاة الذين أقروا بوجوب الزكاة لكنهم امتنعوا من أدائها مع إقرارهم بها، كيف استقر إجماعهم على الحكم عليهم بالردة.
ومعلومٌ أن مانعي الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه كانوا أربعة طوائف: ثلاثٌ منها لم يختلف الصحابة في ردتهم، وواحدة اختلفوا فيها أولاً ثم أجمعوا بعد بيان أبي بكر لهم، كما في الصحيحين.
وقد نصَّ الإمام أحمد على ردة هذه الطائفة، أعني: من منعوا أداء الزكاة بخلًا لا جحودًا وقاتلوا على المنع، كما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام إجماعًا للصحابة كما في كتاب “الإيمان”. فهذه طائفةٌ لم تجحد وجوب الزكاة، بل أقرت بوجوبها، لكنهم امتنعوا من أدائها فقط، وقاتلوا على ذلك، ومع ذلك حَكَمَ الصحابة بردتهم بمجرد قتالهم على ترك هذه الشعيرة الواجبة الظاهرة. فكيف بمن أقرَّ بالتوحيد لكنه قاتل على منعِه وصدِّ أهله ونصرةِ خصومِه من المشركين، هل يُشكُّ في ردّته؟!
والدلائل في ذلك كثيرة قد بسطتُها بالخصوص في كتابي الأخير “حقيقة الصراع في تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب”.
وأما دعوى باحميد أنَّ السلف يربطون الحكمَ في مسألة المظاهرة بالقلب، فهذا كذبٌ عليهم، ولا يوجد للسلف قولٌ قط بتعليقِ الحكم في مسألة مظاهرة المشركين على المسلمين على القلب والقصد.
وإنما تكلم السابقون في مسألة التجسس خاصة، ومسألةُ التجسس غيرُ مسألة مظاهرة المشركين في القتال، فهما مسألتان مختلفتان صورةً وحكمًا. وفي كتابي “حقيقة الصراع” فصلٌ في ذكر الفروق بين مسألة التجسس والمظاهرة، من أراد التوسع فليرجع إليه.
ولولا أن المقصود من هذا التعليق الاختصار لبسطت القول في هذه المسألة بالخصوص.
وأما المسألة الثالثة التي ادعاها باحميد سببًا في خطأ الإمام محمد بن عبد الوهاب في التكفير: فهي مسألة إقامة الحجة، فقد ادعى أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يُكفِّرُ إلا بعد إقامة الحجة، لكنَّ إقامتَها في الأمور الظاهرة تكون بمجرد البلاغ، وأما في الأمور الخفية فلا بد من الفهم، وادعى أن هذا التقسيم لم يُسبق إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب، وزعم أنه إنما أخذه عن ابن تيمية، لكن ليس هذا مرادَ ابن تيمية.
وهذا من عجائب الشيخ باحميد -هداه الله-، أولاً لأنَّ التفريق بين مسائل الدين باعتبار الظهورِ والخفاء أمرٌ قد تواترت فيه نصوصُ العلماء قديمًا وحديثًا، ويُعبر عن المسائل الظاهرة غالبًا في كتب أهل العلم بالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة، والأخرى بما ليس كذلك.
وكلُّ من له أدنى اطلاع على كتب الفقه، وأبواب الردة بالخصوص علم ذلك قطعًا.
من ذلك مثلًا قول الشافعي في “الرسالة”: (العلمُ علمان: علمُ عامة لا يسع بالغًا غيرَ مغلوب على عقله جهلُه… ومثَّل بالصلوات الخمس وقتل المرتد وغيرها، قال: الثاني: ما ينوبُ العباد من فروع الفرائض وما يخصّ به من الأحكام وغيرها منا ليس فيه نصُّ كتاب ولا في أكثره نصُّ سنة، فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة).
وقال الخطابي في كلامه على جاحد الزكاة: (فقد شاع دينُ الإسلام واستفاض علمُ وجوب الزكاة، حتى عرفه الخاص والعام، واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يُتأوَّلُ في إنكارها. وكذلك الأمرُ في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان منتشراً كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم في نحوها من الأحكام، إلاّ أن يكون رجلٌ حديثَ عهد بالإسلام، لا يعرف حدوده، فإذا أنكر شيئا منه جهلًا به لم يكفر، وكان سبيله سبيلَ أولئك القوم في تبقية اسم الدين عليه).
وقال النووي: (من جحد ما يُعلَمُ من دينِ الإسلامِ ضَرورةً، حُكِمَ برِدَّتِه وكُفرِه، … وكذا حُكمُ من استحَلَّ الزِّنا، أو الخَمرَ، أو القَتلَ، أو غيرَ ذلك من المحرَّماتِ التي يُعلَمُ تحريمُها ضرورةً).
ولا أحبُّ أن أطيل في تقرير هذه المسألة، فإنها أظهر من أن تُبيّن.
وهذه المسائلُ المعلومةُ من الدين بالضرورة لا يقبل العلماء الاعتذارَ فيها بالجهل أو التأويل، لكنّهم يستثنون من ذلك وصفًا يكررونه كثيرًا: وهو: مَن نشأ ببادية بعيدة، أو كان حديث عهد بإسلام، فتراهم إذا ذكروا البادية قَيَّدوها بالبعيدة، لأنَّ القريبة لا يُقبل الاعتذار فيها بالجهل وإن كانت بادية لا حاضرة، لأنَّ إقامة الحجة عند العلماء تقوم بالتمكن من العلم لا ببلوغه. فكلُّ من تمكن من العلم لكنه فرّط إما تعصبًا أو إعراضًا، أو لغير ذلك من الأسباب، فقد قامت عليه الحجة، ونصوصُ العلماء في هذا كثيرة.
قال ابن تيمية: (الحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به).
وقال ابن القيم: (فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول، وإنزال الكتاب، وبلوغ ذلك إليه، وتمكنه من العلم به، سواءٌ علم أم جهل، فكلُّ من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه، فقصَّر عنه ولم يعرفه، فقد قامت عليه الحجة، والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه).
وقال القرافي: (القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعُه لا يكون حجة للجاهل، فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله، وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها، فالعلم والعمل بها واجبان، فمن ترك التعلم والعمل، وبقي جاهلا، فقد عصى معصيتين لتركه واجبين، وإن علم ولم يعمل، فقد عصى معصية واحدة بترك العمل ومن علم وعمل فقد نجا).
ومسائل الدين الظاهرة أيضًا متفاوتة في الظهور، ولا ريب أن أظهر هذه المسائل: هي مسألة توحيد العبادة، لأن الدلائل عليها فطريةٌ وعقليةٌ قبل أن تكون شرعية ببلاغ الرسل، كما في الحديث: (خلقت عبادي حنفاء) أي: على التوحيد الخالص، وكذلك قوله: (كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)، والمراد بالفطرة: فطرةُ التوحيد والإسلام، وليس فطرةَ الإقرار بالخالق، لأنه لم يقل في الحديث: ويأسلمانه، فدل على أنه يولد مسلمًا موحدًا. ولابن تيمية وابن القيم في تفسير هذا الحديث ونحوه كلام كثير يُطلب من مظانه.
وعلى هذا، فتوحيدُ الله وإفرادُه بالعبادة أمرٌ فطري وعقلي، لكنَّ الله تعالى من رحمته لا يُعذب بمجرد الفطرة والعقل، حتى تقوم الحجة الرسالية، ببلاغ الرسل ووصول العلم، مصداقاً لقوله: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)، وهذا النوع من العلم يكفي فيه البلاغُ والتنبيه، لأن في خِلقة الإنسان ما يدل على التوحيد، لكنْ قد تُغطَّى هذه الفطرة بالتربية والتنشئة، فإذا جاء ما يذكرُ بها قامت الحجة على العبد، كما في الحديث: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار)، فعلق إقامة الحجة بمجرد السماع، ولم يشترط الفهمَ الخاص، مع العلم بأن اليهود والنصارى لهم تأويلاتٌ على صحة ما هم عليه من الدين، ومعلومٌ أن أكثرهم يجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم مُبشرٌ به في كتبهم، وإنما قامت الحجة عليهم بما يدعوهم إليه الإسلام من التوحيدِ الذي تدل عليهم فطرُهم وعقولُهم، كما دلت فطرهم أيضًا على بطلان ما هم عليه من الشرك والكفر.
والإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب ماضٍ على ما عليه العلماء، فإنه لم يحكم بكفر الواقعين في الشرك في بداية دعوته، بل نصَّ في أكثر من موضع على أنه لا يَحكُمُ بكفرهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فحكمُهم عنده هو حكمُ أهل الفترة ممن لم تبلغهم الرسالة، ولم تقم عليهم الحجة، لكن لما انتشرت دعوته، وقامت الحجة وذاعت في أوساط نجد وما جاورها، حكمَ بكفر من أصرَّ على الشرك، لأنَّ الحجة عليهم قد قامت، والعلمَ قد بلغ. ولا عذر لأحد في الإصرار على الشرك حينئذٍ.
والعلماء مجمعون على أن التأويل لا يُقبل في أصلِ الدين والتوحيد، وإنما يُقبل فيما دون ذلك من مسائل الدين بحسب الحال والمقام.
فهذه هي المسائل الثلاث التي زعم الشيخ باحميد -هدانا الله وإياه- أنها مستندُ التكفير الخاطئ عن الإمام محمد بن عبد الوهاب.
ثم قال باحميد في ختام كلامه مؤكدًا هذا المنهج الخاطئ عند الإمام محمد بن عبد الوهاب: (ولهذا كفَّر الشيخ أكثر المسلمين في زمانه). ولا أدري من أين جاء بهذا التعميم، وممن أخذه، وهذه فريةٌ أخرى على الإمام رحمه الله، فإنَّ كل من قرأ كتبه، وعلم تاريخَه ومنهجه يقطع ببطلان ذلك، بل هذا من جملة الافتراءات القديمة التي افتراها عليه خصومه.
فقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في رسالته إلى عبد الرحمن السويدي عالم العراق: (وأما التكفير فأنَا أُكُفِّرُ من عَرَفَ دين الرسول، ثم بعدما عَرَفَه سَبَّهُ، ونهى الناس عنه، وعادى من فعله، فهذا هو الذي أُكَفِّرُهُ، وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك).
وقال -رحمه الله- في رسالته إلى فاضل آل مزيد مُبَيِّنًا أنَّه لو عُرضت دعوته على علماء الشام واليمن لأقرُّوا بها: (والأمر الثاني: أنَّ هذا الذي أنكروا عليَّ، وأبغضوني من أجله، إذا سألوا عنه كلَّ عالمٍ في الشام واليمن أو غيرهم، يقول: هذا هو الحق وهو دين الله ورسوله، ولكنْ ما أَقْدِرُ أن ْأُظهره في مكاني لأجل أنَّ الدولة ما يَرْضَوْن، وابن عبد الوهاب أظهره لأنَّ الحاكم في بلده ما أنكره).
وقال -رحمه الله- في رسالته لعبد الله بن سحيم: (فإنْ عَرَفْتَ أنَّ الصواب معي، وأنَّ دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء؛ أعني دينَ الإسلام الصرف الذي لا يُمزج بالشرك والبدع، وأمَّا الإسلام الذي ضدُّه الكفر، فلا شك أنَّ أمَّة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم، وعليها تقوم الساعة) فهو هنا يؤكد أن الغربة التي يعنيها ليست غربة أصل الإسلام الذي ضدُّه الكفر، بل غربةَ الإسلام الخالص الصافي الذي ضدُّه البدعة والضلالة.
على أننا لو فرضنا جدلًا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب حكم على أكثر الأمة بالشرك كما يزعم باحميد لأجل وقوعهم في دعاء الموتى وصرفِ العبادة لهم، فهذا مما غضاضة فيه على الإمام -لو حصل- لأنه حكمٌ على قوم من يستحقون هذا الحكمَ، مع أنه لم يقع من الشيخ أصلا، لكن لو فرضنا وقوعَه لهذا السبب، لم يكن مستنكرًا.
ولذلك أجاب العلامة المعلمي بمثل هذا الجواب على من ادعوا مثل هذه الدعوى على الإمام محمد بن عبد الوهاب. فقال:(فلا يَحْسُنُ بالمنصف أنْ يلوم من قال بتكفير الداعي والمستغيث والمعتقد على الوجه المذكور -مراده: دعاء الغائب والميت والاستغاثة به وبالحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله واعتقاد مقتضى ذلك-، وإنْ لزم على قولهم تكفيرَ أكثرِ الأمة، كما أنه لا يجترئ مسلمٌ على القدح في الإمام أحمد بن حنبل في قوله: إنَّ مَنْ تَرَكَ صلاةً من الفرائض فقد ارتدَّ، وإنْ كان يعترف بوجوبها، مع أنه يلزم على هذا القول أنَّ أكثر الأمة مرتدُّون؛ لأنه ما مِن مدينة من المدن التي يسكنها المسلمون إلَّا وتاركوا الصلاة أكثر من المصلِّين، وإذا عطفت النظر إلى المصلين وَجَدْتَ كثيرًا منهم لا يُصَحِّحُونَ صلاتهم مع إمكان التعلُّم، فهم مع ذلك غير معذورين، فيلتحقون بالتاركين…).
وقول الشيخ باحميد في آخر كلامه: إن الإمام محمد بن عبد الوهاب حَكَم بكفر أكثر الناس لأن كثيراً منهم يدعون الأموات، فهم كفارٌ عنده بهذا الاعتبار، وآخرون لا يدعون الأموات لكنهم يساعدون وينصرون من يدعو الأموات، فهم كفار عنده أيضًا بهذا الاعتبار. فالجواب عليه يُعرف مما سبق، فإنَّ الداعي للأموات والعابدَ لهم بعد قيام الحجة مشركٌ بلا ريب، والمناصرُ لهذا المشرك والمظاهرُ له على أهل التوحيد كافرٌ مثله، لأنه مناصرٌ للشرك ومقرٌ له وساعٍ في تثبيته وتمكينه، وهذا مما لا يُشكُّ في كفره وردته على ما مر، لأنه في حقيقته مؤمنٌ بالطاغوت بفعله هذا ونصرتِه للشرك على التوحيد، غيرُ كافر بالطاغوت بل مؤمنٌ به بفعله، وحالُ هذا كحال من يسبُّ الله ورسوله طمعًا في مالٍ، وإن كان كارهًا له في قلبه، أو من يستهزئ بالشريعة بقصد الضحك لا بقصد الكفر والجحود والإنكار للشريعة.
وأما ما زعمه الشيخ باحميد أن الدولة السعودية الأولى كَفَّرت العثمانيين والجنود الغازين، فالجواب عليه يتبيّن مما سبق، لأنَّ هذه الجنود جاءت لنصرةِ الشرك وأهله، وقمعِ التوحيد وطمسه، ولم تأتِ لأمر سياسي فقط، وأنا قد ذكرت الدلائل الكثيرة والشواهدَ التاريخية على أن القوات الغازية لنجد في صراعها الأول مع الدولة السعودية الأولى كان دينيًا عقديًا، ولم يكن سياسيًا، وكانوا يُكفرون الشيخ بدعوتِه إلى التوحيد، ويسبون التوحيد الذي يدعو إليه، ويقولون عن التوحيد: هو كفرٌ وشركٌ وإلحاد وزندقة، ولا يخفى أن من أنكر الصلاة أو الزكاة، بل من أنكر ركعة من صلاة ٍكفر بإجماع المسلمين، فكيف بمن ينكر التوحيدَ، ويسبُّه ويُكفِّرُ أهلَه، ويعتبرهم ملاحدةً زنادقةً بسبب التوحيد لا غير، ويمدحُ الشركَ ودعوةَ الأموات، ويقول: هي الحق وهي الدين، ولا يكتفي بذلك أيضًا، بل يقاتل لنصرةِ الشرك وتثبيته وإعزازه، ولقمعِ التوحيد وطمسِ أركانه وهدم بنيانه. هل يُتصور أن يكون مثلُ هذا مسلمًا؟ من قال هذا: فإنه لم يعرف الإسلام.
والحكم في تلك الفترة إنما كان على تلك القوات الغازية بهذا الاعتبار ولأجل هذا الفعل المكفِّر، ولم يكن كما يزعم باحميد لأن الدولة السعودية لم تكن ترى أحدًا مسلمًا إلا هم، فهذا محض افتراء.
ولذلك نحن نطالبه بإثبات هذه الدعوى، أين في كلامِ علماء الدعوة والدولة السعودية الأولى، أنهم الدولةُ المسلمة فقط، وأنَّ مَن سواهم من الدول دولُ كفر؟ سبحانك هذا بهتان عظيم.
وقد ختم باحميد هذه الافتراءات بدعوى أن ما يحصل من داعش اليوم هو عينُ ما حصل من الدولة السعودية الأولى، فأقول: هذا إنما يقوله بسبب جهله وقلةِ علمه وجرأتِه، فإن التباين بين دعوة الشيخ والدولة السعودية الأولى وبين داعش كالفرق بين الليل والنهار، والنور والظلمة.
وقد كتبت كتابًا في هذه المسألة بالخصوص بعنوان “الإعلام ببطلان نسبة جماعات الغلو والتكفير لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب” ذكرت فيه الدلائل الواضحة على شدة التباين بين الدعوتين، وأنَّ دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب على النقيض من دعوة داعش وكل الجماعات الخارجية كالقاعد وفروعها.
ومن عجيب تناقضات الشيخ باحميد استغرابَه ممن يصف داعش بالخوارج ولا يصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعَه الأوائل بذلك، على اعتبار تساويهما. ثم قال: وهذا أيضًا من العجائب: (أنا لا أصفهم بالخوارج، ولكن أقول: هناك أخطاء ومخالفات للسلف، لكن الأصل أنهم أهل سنة)، سبحان الله! كيف يكون منهجهم تكفيرَ المسلمين وأنهم كداعش ومع ذلك هم من أهل السنة، وهل تكفيرُ المسلمين إلا مذهبُ الخوارج، وهل الخوارج من أهل السنةّ؟! هذا من التناقض، وهو في الحقيقة دليلٌ على عدم ضبط الشيخ باحميد لمسائل العلم، والعقيدة بالخصوص.
وفي الختام أسأل الله لي وللشيخ باحميد الهداية للصواب، وأدعوه إلى مراجعة كلامه الذي قاله، والرجوع عنه صراحة وعلانية.
والله أعلم