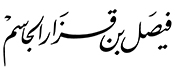لتحميل البحث على صيغة pdf
ومضات في فقه التعامل مع منكرات الولاة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
فهذا بحثٌ مختصر في مسألةٍ من المسائل المتعلقة بالإمامة والجماعة من جهة، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة أخرى، وهي فقه التعامل مع المنكرات إذا صَدَرت من الحكام والولاة، سواء المنكرات القاصرة الخاصَّة أو المتعدّية العامَّة، وبحثِ النظر في المنهجية الصحيحة في التعامل مع هذه المنكرات، من خلال النظر في نصوص الشرع، وآثار السلف، واعتبار متغيّرات الواقع، واختلاف الأحوال، والبلدان، والأزمان.
وما هذا البحث المختصر إلا مساهمةٌ متواضعة، ومشاركةٌ مني في ميدان العلم والبحث، وهو لبنةٌ من لبنات إثراء هذا النوع من المسائل المهمة، أضعه بين يدي أهل العلم والتخصص، للبحث والنظر، وتقويم ما قد يكون فيه من خلل وزلل، إذ إنني لا أدَّعي العصمة والصواب على الدوام، بل أجتهد رأيي مستعينًا بالله تعالى، متحرِّيًا طريق السلف ومنهجهم، مع إعمال النظر في نصوص العلماء، والاستضاءة بأفهامهم، دون أن أضع أقوالهم واجتهاداتهم موضع النصوص الشرعية.
وقد كثر الحديث حول المنهج الصحيح في التعامل مع منكرات الولاة، وتعددت الكتابات في ذلك، وعلى الرغم من تعدد الكتابات، فإنَّ بعض من خاض غمار الحديث حول هذه المسألة بالخصوص، لم يميز بين مواضع الاتفاق والاختلاف، ولم يحرر قول المخالف، ولا موطن النزاع، وربما أطلق لسانه باتّهام مخالفه بالخروج عن منهج السلف، بل ورَمْيِ بعضهم بالبدعة والضلالة جزافًا.
ولا ريب أنَّ هذه المسألة بالخصوص، تُعدُّ من عظيم المسائل، لارتباطها بحقِّ الجماعة، ومعرفة سبل المحافظة عليها، ومن هنا فإنَّ البحث فيها ينبغي أن يكون بعلم وعدل، وأن يكون نظر الباحث فيها إلى النصوص، ومقاصد الشريعة، مع تتبع كلام العلماء، وجمعه مقرونًا بأفعالهم، حتى يوضع في موضعه.
وللناس في هذه المسألة توجهات مختلفة، ومنطلقات متعدِّدة، فمنهم من يريد الإنكار على الحاكم علنًا، على كلِّ منكر وقع في ولايته، أيًّا كان نوع المنكر، ولو لم يأمر به الحاكم ولم يباشره، ويريد أن يعامل الحاكم في ذلك معاملة آحاد الرعية، من غير اعتبار لما يحفظ هيبتَه، ويُعزّز سلطانه، ويَوقّر منزلته في قلوب الرعية، مُهملًا بذلك ما جاءت به النصوص، وعَمِلَ به السلف، ونصَّ عليه العلماء، من النصيحة للحاكم، ووعظِه وتذكيرِه برفق ولين، بل تراه يسلك هذا الطريق ويتخذه سبيلًا لإيغار الصدور، وإثارة الفتنة، وشحن القلوب، وفتح باب الشرِّ والثورة والعصيان.
ويقابله طرفٌ آخر يمنع من الإنكار على الحاكم علنًا مطلقًا، حتى لو حرَّف الدين، وغيَّر الشرائع، وبدَّل السنن، ويرى وجوب إسرار النصيحة للحاكم بكل حال، وفي كلِّ منكرٍ، ويخصُّ الإنكار عليه بين يديه في كلِّ الأحوال، من دون تمييز بين أنواع المنكرات، وأحوالها، بل جاوز بعضهم ذلك، حتى مَنَعَ من التلميح والتعريض مطلقًا، كما مَنَع من التصريح.
ومنهم من سلك مسلط التوسَّط بين هذين التوجهين، فجوَّز الإنكار علنًا على الحاكم، في أحوال مخصوصة، أو في منكرات محدودة، على اختلاف بين أصحاب هذا القول في هذه الأحوال، وفي أنواع المنكرات.
فأقول مستعينًا بالله: إنَّ أهل السنَّة والجماعة لم يُهملوا بيان أصل هذه المسألة في جوامعهم المصنّفة، وفي كتب العقائد المسندة والمختصرة، المتقدمة والمتأخرة.
ولا يخفى على كل طالب علم ومعتنٍ أنَّ كتب السنَّة والاعتقاد، متقدّمها ومتأخرها، مبسوطها ومختصرها، قد تتابعت على بيان أصول أهل السنَّة والجماعة في أبواب الإمامة والجماعة، وفي أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إنَّه لا يخلو منها كتاب.
ومما ذكروا في أصل الإمامة والجماعة: وجوب السمع والطاعة بالمعروف، وتحريم نزع اليد من طاعة، ووجوب الجُمَع والجماعات خلف الأئمة، والحج والجهاد معهم، أبرارًا كانوا أو فجارًا، ونصُّوا على ثبوت إمامة من تأمَّر منهم، واجتمع الناس عليه، أو اختاره أهل الحل والعقد، أو وُلِّيَ بعهد مَنْ قَبْلَه.
كما اتفقت كتب السنَّة والاعتقاد على تحريم الخروج على الأئمة بالسيف، وإنْ جاروا وظلموا، ووجوب الصبر على ظلمهم وجورهم، مع بذل النصيحة والدعاء لهم.
وهذه هي الأصولُ المحكمةُ التي يُرجع إليها عند الاختلاف، وتردُّ إليها الفرعيات، وتُحاكم إليها الوقائع والأحداث.
ومع حرص أهل السنَّة والجماعة على بيان هذا الباب، والتأكيد على أصوله المأخوذة من الكتاب والسنَّة، وصيانته مِن مسالك الفرقة والشقاق، بالتنصيص فيه على ما يحفظ الجماعة، ويَصُون الإمامة، ويُوحِّد الكلمة، ويحفظ الشريعة، فإنَّهم لم يُحدِّدوا في مصنفاتهم طريقًة معيَّنة، ووسيلة محددة، تُسلك في إنكار جميع منكرات الولاة، على اختلاف الأحوال، وتنوِّع المنكرات، وتغيِّر الأزمان والأعراف، كتخصيص الإنكار بالإسرار في كلِّ الأحوال، أو الجهر بالإنكار في مطلق الأزمان، أو حصرِ الإنكار بين يدي الحكّام، ونحو ذلك، سوى التنصيصِ على مَنْعِ الإنكار باليدِ والسيف، والنهيِ عن كلِّ ما يؤدي إلى ذلك من الوسائل والأسباب كالسبِّ والعيبِ والقدحِ وذكرِ المثالب، على ما سيأتي بيانه.
إلا إنَّهم بيَّنوا المنهجية العامة في إنكار المنكرات عمومًا، وهي: أن يكون الإنكارُ بعلمٍ، وحلمٍ، وصبرٍ، ورفقٍ، ما لم يقتض الحال والمقام الشدّة، وأن لا يؤدي الإنكار إلى منكرٍ أعظم منه، دون أن ينصُّوا على طريقة معينة في الإنكار تُسلك في كل الأحوال، وعلى تغيِّر الأزمان، ومع اختلاف الأشخاص، وسواءٌ في ذلك منكرات الحاكم، أو المحكوم، بل أطلقوا وجوب إنكار المنكر بهذه الضوابط في الجملة.
قال سفيان الثوري -رحمه الله-: (لا يَأمُرُ السلطانَ بالمعروف إلا رجلٌ عالمٌ بما يأمر، عالمٌ بما ينهى، رفيقٌ فيما يأمر، رفيقٌ فيما ينهى، عدلٌ فيما يأمر، عدلٌ فيما ينهى))[1](.
ومن المعلوم أن بعض هذه الضوابط تختلف باختلاف الأزمان، والأشخاص، والأحوال، والأعراف.
فإن قال قائل: قد عقد ابن أبي عاصم -رحمه الله- في كتاب >السنّة<، وهو من كتب العقائد، بابًا بعنوان (كيف نصيحة الرعية للولاة)، أورد فيه حديث عياض بن غنم ÷، أن النبَّي × قال: >من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبده علانية، ولكن، يأخذ بيده فيخلو به، فإن قَبِلَ منه فذاك، وإلا قد أدَّى الذي عليه<)[2](.
فالجواب أنْ يُقال: إنَّ هذا الحديث إنما هو في النصيحة للسلطان، وليس في إنكار المنكر إذا صَدَر منه، والنصيحةُ أخصُّ من الإنكار مِن وجه، وأعمُّ من وجه، ومنْ لم يهتدِ إلى الفروق بين الإنكار والنصيحة وقع في الوهم، وعامَّة مَن يَمْنعُ من إنكار المنكر إذا صَدَر من الولاة علنًا يستند إلى حديث النصيحة هذا، وما شابهه من الآثار.
ومن هنا كان من المهم قبل بحث المسألة أن يُميّز بين أمرين:
الأمر الأول: التمييز بين النصيحة والإنكار.
والأمر الثاني: التمييز بين الإنكار من جهة وبين العيب والقدح والسبِّ والنقد والتشهير وتعداد المساوئ وتلمس الهفوات والزلات من جهة أخرى
وهو مدار البحث في الفصل الأول.
وقد جعلتُ هذه الرسالة والبحث في ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في التمييز بين المصطلحات المعتبرة في هذا باب التعامل مع الولاة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في التمييز بين النصيحة والإنكار
والمبحث الثاني: في التمييز بين الإنكار من جهة وبين العيب والقدح والنقد والسبِّ والتشهير من جهة أخرى
والفصل الثاني: في ذِكر أنواع المنكرات الصادرة من الحاكم أو في ولايته، وفِقْهِ التعامل مع كلِّ منها
والفصل الثالث: جعلته في مبحثين:
المبحث الأول: في ذكر بعض الاعتراضات والردود عليها
والمبحث الثاني: في ذكر بعض التنبيهات المهمة
ثم ختمت ذلك بخاتمة تشمل زبدة البحث.
والله أسأل أن يُوفّقني للصواب، وأن يُجنّبني الخطأ والزلل، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب.
كُتب في الكويت
في ٢٥ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
٢٨ يناير ٢٠٢٢م
التمييز بين المصطلحات المعتبرة في باب التعامل مع الولاة
من المهم التمييزُ بين المصطلحات المستخدمة في باب التعامل مع الولاة، فإنَّ بعض مَنْ خاض في بحث هذه المسائل وَقَع في خلطٍ بين المصطلحات، مما أدَّى به إلى تفسيرِ النصوص بغير معناها، وتنزيلها في غير مواضعها، وصَرْفِ كلام العلماء عن مراده، فكان من المهم بحث هذه المصطلحات والتمييز بينها، وتوضيح ما تجتمع فيه وتفترق
قد صحَّ عن النبي × في أحاديث كثيرة، الحثُّ والترغيب في بذل النصيحة للمسلمين، حكامهم ومحكوميهم.
ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري ÷ أن النبي × قال: >الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم<)[3](.
وروى الشيخان أيضًا عن جرير بن عبد الله ÷ قال: (بايعتُ النبيَّ × على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنُّصحِ لكل مسلم) )[4](.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ÷، عن النبي × قال: >إنَّ الله يرضى لكم ثلاثًا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم<)[5](.
وفي المسند وغيره عن جبير بن مطعم ÷ أنَّ النبي × قال في خطبته بالخيف من منى: >ثلاث لا يَغِلُّ عليهن قلب امرئ مسلم؛ إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين>.)[6](
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: (وقد أخبر النبي × أنَّ الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل))[7](.
وقال الخطابي -رحمه الله-: (النصيحة كلمة يُعبَّر بها عن جملة، هي إرادة الخير للمنصوح له))[8](.
وقال محمد بن نصر المروزي -رحمه الله-: (وأما النصيحة لأئمة المسلمين، فحبُّ صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحبُّ اجتماع الأمة عليهم، وكراهةُ افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل))[9](.
ومن هنا اتفق العلماء على أنَّ النصيحة تكون فيما بين الناصح والمنصوح، حاكمًا كان أو محكومًا.
قال ابن رجب -رحمه الله-: (وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد، وَعَظوه سرًّا، حتى قال بعضهم: مَن وَعَظ أخاه فيما بينه وبينه، فهي نصيحة، ومَن وَعَظه على رؤوس الناس فإنَّما وَبَّخه. وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويُعيِّر. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: كان مَن كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئًا يأمرُه في رفق، فيُؤجرُ في أَمْرِه ونَهْيِه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره))[10](.
وفي ذلك يقول الشافعي -رحمه الله-:
تَعَمَّدني بِنُصحِكَ في اِنفِرادي وَجَنِّبني النَصيحَةَ في الجَماعَه
فَإِنَّ النُصحَ بَينَ الناسِ نَوعٌ مِنَ التَوبيخِ لا أَرضى اِستِماعَه
وَإِن خالَفتَني وَعَصِيتَ قَولي فَلا تَجزَع إِذا لَم تُعطَ طاعَه
وقال أيضًا -رحمه الله-: (مَنْ وَعَظَ أخاهُ سِرًّا فقَدْ نَصَحَه وَزَانَه، ومَنْ وَعَظَه عَلَانِيَةً فقَدْ فَضَحَه وشانَهُ))[11](.
وعلى هذا، فحديث >مَنْ أراد أنْ ينصح لذي سلطان فلا يُبْدِه علانية<، لم يأت لتخصيص السلطان بهذا الحُكم، ألا وهو إسرار النصيحة، وإنما جاء لتأكيد حقِّ السلطان في ذلك، من باب التنبيه والتذكير، وذلك لعدة أمور:
منها: أنَّ المفاسد المترتبة على إعلان النصيحة للسلطان أعظم من المفاسد المترتبة على إعلان النصيحة لآحاد المسلمين.
ومنها: أنه من باب التأكيد على حقِّ السلطان على الرعية، ووجوب توقيره وإكرامه، والبعد عن كل ما يشينه ويُهوِّن من سلطانه، ويُضعف مكانته في القلوب.
ومثلُه تخصيصُ النَّصح لولاة الأمور بالذِّكْر في حديث: >الدين النصيحة<، مع دخول الولاة وشمولهم في عموم المسلمين.
فالنصيحة موعظةٌ وتذكير، وهي من هذه الجهة أعمُّ من إنكار المنكر، فإنَّ النصيحة لا تختص بما هو منكرٌ، وهو ما جاء إنكاره في الشريعة نصًّا أو إجماعًا، بل تشمل مسائل الاجتهاد، سواء الاجتهاد في مسائل الشرع، أو الاجتهاد في الاختيار والتعامل والتصرّف ومعالجة الأمور، ومن هنا قال العلماء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، حيث جعلوا فيها التناصح والتذاكر والتباحث.
وأما المنكر، وهو كلُّ ما خالف النصَّ الصريح أو الإجماع، فلا يدخل فيه بهذا الاعتبار مسائل الاجتهاد والاختيار التي تُشرع فيها النصيحة لا الإنكار.
قال النووي -رحمه الله-: (أمّا المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأنَّ كلَّ مجتهد مصيب، أو المصيبُ واحدٌ ولا نعلمه، ولا إثم على المخطئ، لكنْ إنْ نَدَبَه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف، فهو حسن محبوب))[12](.
فما اختُلف فيه من المسائل شُرع فيه النصيحة، وما لم يُختلف فيه شُرع فيه الإنكار.
وقال ابن القيّم -رحمه الله-: (وقولهم: >إنَّ مسائل الخلاف لا إنكار فيها< ليس بصحيح؛ فإنَّ الإنكار إما أنْ يتوجَّه إلى القول والفتوى أو العمل. أما الأول؛ فإذا كان القول يخالف سنَّة أو إجماعًا شائعًا وجب إنكاره اتفاقًا، وإن لم يكن كذلك فإنَّ بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. وأما العمل؛ فإذا كان على خلاف سنَّة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار… وأما إذا لم يكن في المسألة سنَّة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ، لم ينكر على من عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أنَّ القائل يعتقد أنَّ مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم))[13](.
ومِن أوجه الاختلاف بين بابي النصيحة والإنكار: أنَّ الإنكار -كما في الحديث- يعمُّ اليد واللسان والقلب، فهو من هذه الجهة أعمُّ من النصيحة.
قال أبو حامد الغزالي -رحمه الله- في تعريف المنكر الذي يجب إنكاره: (كونه منكرًا، ونعني به أن يكون محذورَ الوقوع في الشرع، وعَدَلْنا عن لفظ المعصية إلى هذا؛ لأنَّ المنكر أعمُّ من المعصية؛ إذ من رأى صبيًّا أو مجنونًا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه، وكذا إن رأى مجنونًا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه. وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهوره بين الناس، بل لو صادف هذا المنكر في خلوة لوجب المنع منه، وهذا لا يُسمَّى معصية في حقِّ المجنون؛ إذ معصيةٌ لا عاصِيَ بها محال، فلفظ المنكر أدلُّ عليه وأعمُّ من لفظ المعصية، وقد أدرجنا في عموم هذا: الصغيرة والكبيرة، فلا تختص الحسبة بالكبائر، بل كشفُ العورة في الحمام، والخلوة بالأجنبية، وإتباع النظر للنسوة الأجنبيات، كلُّ ذلك من الصغائر، ويجب النهي عنها))[14](.
والآيات والأحاديث جاءت عامة في وجوب التآمر بين المسلمين بالمعروف، والتناهي عن المنكر، دون تفريق بين المسلمين في ذلك، لا باعتبار المناصب، ولا باعتبار المنزلة والمكانة والجنس والطبقة، كقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}، وقوله: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}.
وأصلُ وجوبِ إنكار المنكر مِن السنَّة قوله صلى الله عليه وسلم: >مَنْ رأى منكم منكرًا فَلْيُغَيّرْه بيده، فإنْ لم يستطع فبلسانه، فإنْ لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان<.
وفي هذا الحديث عمومات من عدة جهات: عمومٌ في المُنكِر، وعمومٌ في المُنكَر، وعمومٌ في المُنكَرِ عليه، فهو يعمُّ كلَّ مُنكِر، لأنَّ >مَنْ< من ألفاظ العموم، ويعمُّ كلَّ مُنْكَر، لأنَّ قوله: >منكرًا< نكرة في سياق الشرط، كما أنه يعمُّ كلَّ صاحبِ منكر، من جهة عمومه في المُنكَر.
وما سيأتي من الأدلة يؤكد فَهْمَ السلف لهذه العمومات، كصنيع أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وعمارة بن رؤيبة وأنس رضي الله عنهم أجمعين، وسيأتي ذكرها.
ومع عموم الأدلة السابقة في إنكار المنكر، وشمولها لأنواع المُنكَرِ عليهم، فقد جاءت الشريعة بأدلة خاصة فيما يخص منكرات الولاة، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله × قال: >ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عَرَفَ بَرِئ، ومن أنكر سَلِم، ولكنْ مَنْ رضي وتابع<. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: >لا ما صلوا<.
فقسَّم النبي × الناس تجاه مُنكرات الأمراء إلى ثلاثة أصناف: مَن رضي وتابع فقد أثم، ومَن عرَف المنكر بقلبه وعَجَزَ عن الإنكار فقد برئ من الإثم، ومَن أنكر بلسانه فقد سَلِمَ ونجا من المداهنة والنفاق.
ومِن العلماء مَن عَكَس، ففسَّر قوله >مَن عَرَف< بالإنكار باللسان، وقوله: >مَن أنكر< بالإنكار بالقلب.
قال المناوي -رحمه الله- في شرح الحديث: (>سَتَكُون أُمَرَاء تعرفُون وتنكرون< أَي تعرفُون بعض أفعالهم لموافقتها للشَّرْع وتنكرون بَعْضهَا لمخالفتها لَهُ >فَمن كره< ذَلِك الْمُنكر بِلِسَانِهِ بِأَن أمكنه تَغْيِيره بالْقَوْل فَقَالَ فقد >برِئ< من النِّفَاق والمداهنة >وَمن أنكر< بِقَلْبِه فَقَط وَمنعه الضعْف عَن إِظْهَار النكير فقد >سَلِم< من الْعقُوبَة على تَركه النكير ظَاهرا >وَلَكِن من رضى< بالمنكر >وتابع< عَلَيْهِ فِي الْعَمَل فَهُوَ الَّذِي لم يبرأ من الْعقُوبَة أَو هُوَ الَّذِي شاركهم فِي الْإِثْم))[15](.
ومنهم من فسَّر المعرفة والإنكار في الحديث بالقلب.
قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-: (وقوله >فمَن عَرَف برئ< أي: مَن عَرَف المنكر وكرهه بقلبه، بدليل الرواية الأخرى، فتُقيَّدُ إحداهما بالأخرى؛ يعني: أنَّ مَن كان كذلك فقد برئ – أي تَبَرَّأ مِن فِعْلِ المنكر ومِن فاعِله. وقوله >ومَن أنكر فقد سَلِم< أي: بقلبه، بدليل تقييده بذلك في الرواية الأخرى، أي: اعتقد الإنكارَ بقلبه، وجَزَم عليه، بحيث لو تمكن مِن إظهار الإنكار لأنكره، ومَن كان كذلك فقد سَلِم من مؤاخذة الله تعالى على الإقرار على المنكر، وهذه المرتبة هي رتبة مَن لم يقدر على تغيير المنكر لا باللسان ولا باليد، وهي التي قال فيها ×: >وذلك أضعف الإيمان. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل<).)[16](
وقال الشيخ عبد المحسن العباد البدر -حفظه الله-: (قال قتادة: يعني: مَن أنكر بقلبه ومَن كره بقلبه. هذا كما هو معلوم عند من لا يتمكن من الإنكار باللسان، وإلا فإنه إذا حصل الإنكار باللسان على الوجه المشروع، والذي لا تترتب عليه مضرة فإنَّ هذا هو المطلوب، كما في قوله ×: >من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه>، فإنه إذا تمكن من الإنكار باللسان لم يَكْفِ الإنكار بالقلب، ولا بد مِنَ الإنكار بالقلب لمن لا يتمكن مِنَ الإنكار باللسان).)[17](
وقد جاء الحديث مُفسَّرًا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظ: >سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمَنْ نابَذهم نجا، ومَن اعتزلهم سَلِم، ومَن خالطهم هَلَك<.)[18](
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في تفسير الحديث: (المقصود بالمنابذة في الحديث: الإنكارُ باللسان، كما بيَّنه شرَّاح الحديث، يعني: أنكر بلسانه ما لا يوافق الشرع >نجا< من النفاق والمداهنة، >ومَن اعتزلهم< مُنكِرًا بقلبه >سَلِم< من العقوبة على ترك إنكار المنكر).)[19](
وقال الألباني -رحمه الله-: (تأويلُ قوله >نابذهم< أي: بالقول والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لا بالسيف؛ توفيقًا بينه وبين حديث عوف كما تقتضيه الأصول العلمية والقواعد الشرعية))[20](.
قلت: وحديث أم سلمة رضي الله عنها يؤكَّد أنَّ الصحابة رضي الله عنهم فهموا من الحديث وجوب الإنكار على الأمراء، ولذلك سألوا عن حُكْمِ الإنكار عليهم بالقتال، فَمَنَعهم النبي × ما بقي الأمراء على إسلامهم مقيمين للصلاة، فمفهوم الحديث: جواز الإنكار عليهم باللسان.
ولذلك بوَّب له النووي -رحمه الله- بقوله: (باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وتَرْكِ قتالهم ما صلوا).
وقال القاضي عياض -رحمه الله-: (وفيه حجةٌ على لزوم قول الحق وإنكار المنكر). )[21](
وقال ابن الملقَّن -رحمه الله-: (وفيه: الأدبُ مع الأمراء، واللطف بهم، ووعظهم سرًّا، وتبليغهم قولَ الناس فيهم؛ ليكفُّوا عنه، وهذا كلّه إذا أمكن، فإنْ لم يمكن الوعظ سرًّا فليفعله علانية؛ لئلا يضيع الحق… وقال آخرون: الواجب على مَن رأى منكرًا من ذي سلطان أنْ ينكره علانية، وكيف أمكنه، رُوي ذلك عن عمر وأبي بن كعب، احتجا بقوله -عليه السلام-: >من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده< الحديث، وبقوله: >إذا هابت أمتي أنْ تقول للظالم يا ظالم فقد تُودَّع منهم> ذكره البزار من طريق منقطعة. وقال آخرون: الواجب أنْ يُنكِر بقلبه بحديث أم سلمة مرفوعًا: >يُستعمل عليكم أمراء بعدي، تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا يقاتلون؟ قال: لا ما صلوا>).)[22](
وقال الشيخ العثيمين -رحمه الله- في شرح الحديث: (فدلَّ هذا على أنَّهم – أي الأمراء- إذا رأينا منهم ما نُنْكِر، فإننا نكره ذلك، ونُنكِر عليهم، فإن اهتدوا فَلَنا ولهم، وإنْ لم يهتدوا فَلَنا وعليهم، وأنه لا يجوز أنْ نقاتل الأمراء الذين نَرَى منهم المنكر؛ لأنَّ مقاتلتهم فيها شرٌّ كثير، ويفوت بها خيرٌ كثير؛ لأنهم إذا قُوتلوا أو نُوبذوا لم يَزِدْهم ذلك إلا شرًّا، فإنهم أمراء يَرَوْن أنفسهم فوق الناس، فإذا نابذهم الناس أو قاتلوهم؛ ازداد شرُّهم، إلا أنَّ النبي × شَرَطَ ذلك بشرط، قال: >ما أقاموا فيكم الصلاة>. فدلَّ على أنه إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم).)[23](
ومن الأحاديث الدالة على وجوب الإنكار على الولاة: ما ثبت عن مُعاويةَ رضي الله عنه أنَّه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ × يَقُولُ: >سَتَكُونُ أَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي يَقُولُونَ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ، يَتَقَاحَمُونَ فِي النَّارِ كَمَا تَقَاحَمُ القِرَدَةُ>.)[24](
قال الصَّنعانِيُّ-رحمه الله-: >سَتَكُونُ أَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِي يَقُولُون< أي: المُنْكَرَ مِنَ القَوْلِ، بدليل قوله: >فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ< مهابةً لهم وخوفًا مِن بطشهِم، <يَتَقَاحَمُونَ فِي النَّارِ>، أي: يقعونَ فيها كما يَقتحِمُ الإنسانُ الأمرَ العظيمَ ويرمي نفسَهُ فيه بلا رَوِيَّةٍ، <كَمَا تَقَاحَمُ القِردةُ> أي: في الأمرِ الذي تثبت عليه، هذا ويحتملُ أنَّ الضَّميرَ في قوله: >يتَقَاحَمُونَ> للأئمَّةِ ولِمَن لم يَرُدَّ عليهِم مُداهنَةً وتهاوُنًا في الدِّينِ).)[25](
ومنها ما صحَّ عن أبي سعيد الخدري ÷، عن النبي × قال: >لا يمنعَنَّ أحدَكم هيبةُ الناس، أنْ يتكلم بحقٍّ إذا رآه أو شَهِده أو سمعه<. فقال أبو سعيد: وددت أني لم أكن سمعته. وقال أبو نضرة: وددت أني لم أكن سمعته.)[26](
وقد اتفق العلماء على وجوب إنكار المنكر، وأنَّ ما ظَهَرَ منه علانية أُنكر علانية، وما استتر منه شُرع فيه النصيحة والستر.
فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: >ومَنْ سَتَر مسلماً سَتَره الله يوم القيامة<.)[27](
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في شرح هذا الحديث: (والذي يظهر أنَّ السَّتر مَحَلُّه في معصية قد انقضت، والإنكارَ في معصية قد حصل التلبُّس بها، فيجب الإنكار عليه، وإلا رفعه إلى الحاكم، وليس من الغِيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة).)[28](
وقال ابن حزم -رحمه الله-: (المجاهرة بالصغائر جُرحةٌ للإجماع المتيقَّن على ذلك، والنصِّ الوارد مِن الأمرِ بإنكار المنكر، والصغائرُ مِن المنكر، لأنَّ الله تعالى أنكرها وحرَّمها، ونهى عنها، فمَنْ أعلن بها فهو مِن أهل المنكر، فقد استحقَّ التغييرَ عليه بقول رسول الله ×: >من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان<، ومَنْ كان مِن أهل المنكر في الدين فهو فاسق، لأنَّ المنكر فسقٌ، والفاسقُ لا يُقبل خبرُه، وصحَّ بما قدمنا أنَّ المستتر بالصغائر ليس صاحبه فاسقًا، ولا يجب التغييرُ عليه، ولا الإنكارُ عليه، لأنَّه لم يُرَ منه ما يلزمنا فيه تغييرٌ، ولا إنكارٌ، ولا تعزيرٌ).)[29](
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: (وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وَجَبَ الإنكار عليه علانيةً، لم يَبْقَ له غِيبة، ووَجَبَ أنْ يُعاقب علانيةً بما يردعه عن ذلك مِن هجرٍ وغيره))[30](.
وعلى هذا أفعال الصحابة رضي الله عنهم والسلف، حيث أظهروا الإنكار على ما ظَهَرَ مِن منكرات الولاة، ولم يخصُّوا ما ظهر منها بالنصيحة السرّية، إذ لكلِّ منها باب يخصُّه. وإليك بعض هذه الآثار:
الآثار الواردة عن السلف في الإنكار على الولاة
الأثر الأول: إنكارُ أبي سعيد الخدري ÷ على مروان بن الحكم
فعن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه قال: أوَّلُ مَن أخرج المنبر يوم العيد مروان، وأوَّلُ مَن بدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجلٌ فقال: يا مروان، خَالَفْتَ السنَّة، أَخْرَجْتَ المنبر ولم يكُ يُخرج، وبَدَأْتَ بالخطبة قبل الصلاة، قال أبو سعيد: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان، قال: أما هذا، فقد قَضَى ما عليه، سمعت رسول الله × يقول: >مَن رأى منكرًا، فإن استطاع أنْ يُغَيّرَه بيده، فإنْ لم يستطع فبلسانه، فإنْ لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان<.)[31](
ففيه إقرارُ أبي سعيد ÷ فِعلَ مَن أظهر الإنكار على مروان في البداءة بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة، وإخراجِ المنبر، ولم يُسرَّ له بالنصيحة.
الأثر الثاني: إنكارُ عبادة بن الصامت على معاوية رضي الله عنهما
فقد أنكر عبادة بن الصامت ÷ على معاوية ÷ في ربا الفضل، وقد ذكر عبادةُ ÷ معاوية ÷ تصريحًا فقال: (لنُحَدِّثَنَّ بما سمعنا من رسول الله × وإِنْ كره معاوية، ما أبالي أنْ لا أصحبه في جنده ليلة سوداء).
وهو بهذا قد عمل بحديثه: >بايَعْنَا رسول الله × على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأنْ لا ننازع الأمر أهلَه، وأنْ نقوم، أو: نقولَ بالحقِّ حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم<.)[32](
فعبادة ÷ أظهر الإنكار على ما رآه ظاهرًا من المنكر، ولم يختلِ بمعاوية ÷ لنصيحته سرًّا.
الأثر الثالث: إنكار أنس ÷ على الحجَّاج بن يوسف
فعن موسى بن أنس، قال: (خَطَب الحجَّاج بن يوسف النَّاس، فقال: اغسلوا وجوهَكم وأيديَكم وأرجلَكم، فاغسلوا ظاهِرَهما وباطِنَهما وعراقيبَهما، فإنَّ ذلك أقربُ إلى جَنَّتكم، فقال أنس: صَدَقَ الله، وكَذَب الحجَّاج؛ ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾، قال: قرأها جرًّا))[33](.
ففيه التصريح بالإنكار وردِّ مقالة الحجّاج.
الأثر الرابع: إنكارُ كعب بنِ عُجرةَ ÷ علنًا على عبد الرحمن بنِ أمِّ الحَكَم
فقد أنكر كعبُ بنِ عُجرةَ ÷ علنًا على عبد الرحمن بنِ أمِّ الحَكَم، حين دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، فَقَالَ: (انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾))[34](.
قال النووي-رحمه الله- في شرح الحديث: (هذا الكلام يتضمَّن إنكارَ المنكر، والإنكارَ على ولاة الأمور إذا خالفوا السنَّة))[35](.
الأثر الخامس: إنكارُ عمارة بن رؤيبة ÷ على بِشر بن مروان
فقد رأى عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ ÷ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: (قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا)، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ)[36](.
وفيه تصريحُ عمارة ÷ بالإنكار على بشر بن مروان لما خالف السنَّة.
وقد قال النووي في شرح أثر أسامة بن زيد ÷ عندما قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: >أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه<: (فيه الأدبُ مع الأمراء، واللطف بهم، ووعظهم سرًّا، وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفُّوا عنه، وهذا كله إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن الوعظ سرًّا والإنكار، فليفعله علانية، لئلا يضيع أصل الحق))[37](.
الأثر السادس: إنكار أبي سعيد الخدري ÷ على معاوية ÷ في أخذه مُدَّيْن من الحنطة في زكاة الفطر بدلًا من صاع
فعن عياض بنِ عبد الله، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه قال: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ × زَكَاةَ الْفِطْرِ -عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ- صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ؛ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ؛ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا مَا عِشْتُ)[38](.
الأثر السادس والسابع والثامن: إنكارُ ابن عمر رضي الله عنهما على الحجَّاج بن يوسف
قال الحافظ الذهبي -رحمه الله- في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أحمد بن يعقوب المسعودي: حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو الأموي، عن أبيه، عن ابن عمر: أنه قام إلى الحجَّاج، وهو يخطُب، فقال: يا عدوَّ الله! استحلَّ حرم الله، وخَرَّب بيت الله. فقال: يا شيخًا قد خَرِف. فلما صَدَر الناس، أَمَرَ الحجَّاج بعض مُسوّدته، فأخذ حربةً مسمومةً، وضَرَب بها رِجلَ ابن عمر، فمرض، ومات منها. ودخل عليه الحجَّاج عائدًا، فسلَّم، فلم يردَّ عليه، وكلَّمه، فلم يُجِبْه)[39](.
هشام، عن ابن سيرين؛ أن الحجَّاج خَطَب، فقال: إنَّ ابن الزّبير بَدَّل كلام الله. فعلم ابنُ عمر، فقال: كَذَبَ، لم يكن ابنُ الزّبير يستطيع أنْ يُبَدِّل كلام الله ولا أنت، قال: إنك شيخٌ قد خَرِفْتَ الغد. قال: أما إنك لو عُدْتَ، عُدْتُ.
قال الأسود بن شيبان: حدثنا خالد بن سُمَيْر، قال: خَطَب الحجَّاج، فقال: إن ابن الزُّبير حَرَّف كتاب الله. فقال ابن عمر: كَذَبْتَ كَذَبْتَ، ما يستطيع ذلك ولا أنت معه. قال: اسكتْ، فقد خَرِفْت، وذهب عقلُك، يُوشك شيخٌ أن يضرب عنقه، فَيَخِرَّ قد انتفخت خِصْيَتاه، يطوف به صبيان البقيع)[40]() )[41](.
ورى ابن أبي شيبة عن يعلى بن حرملة قال: تكلم الحجَّاج يوم عرفة بعرفات، فأطال الكلام، فقال عبد الله بن عمر: ألا إنَّ اليوم يومُ ذِكْر، فمضى الحجَّاج. قال: فأعادها عبد الله مرتين أو ثلاثًا، ثم قال: يا نافع نادِ بالصلاة، فنزل الحجَّاج)[42](.
ورى ابن سعد في >الطبقات< أنَّ الحجَّاج كان يخطب الناس، وابن عمر في المسجد، فخطب الناس حتى أمسى، فناداه ابن عمر: أيها الرجل الصلاة فاقعد، ثم ناداه الثانية: فاقعد، ثم ناداه الثالثة: فاقعد، فقال لهم في الرابعة: أرأيتم إن نَهَضت أتنهضون؟ قالوا: نعم، فنهض فقال: الصلاة، فإني لا أرى لك فيها حاجة، فنزل الحجَّاج، فصلّى، ثم دعا به، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنما نجيء للصلاة، فإذا حضرت الصلاة فصلِّ بالصلاة لوقتها، ثم بَقْبِقْ بعد ذلك ما شئت من بقبقة)[43](.
الأثر التاسع: إنكارُ ابن عمر على خالد بن الوليد رضي الله عنهم
فقد روى البخاري عن ابنِ عمر رضي الله عنهما، قال: بعث النبي × خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يُحسِنوا أنْ يقولوا: أسلمنا، فَجَعَلُوا يقولون: صَبَأْنا صَبَأْنا، فَجَعَل خالد يَقتُلُ منهم ويَأْسِر، ودَفَعَ إلى كلِّ رجلٍ منَّا أسيره، حتى إذا كان يومٌ، أَمَرَ خالد أنْ يَقْتُلَ كلُّ رجل منّا أسيره، فقلتُ: والله لا أقتلُ أسيري، ولا يَقتلُ رجلٌ مِنْ أصحابي أسيره، حتى قَدِمْنا على النبي × فذكرناه، فَرَفَعَ النبي × يديه فقال: >اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد< مرتين)[44](.
فها هو ابن عمر رضي الله عنهما قد جاهر بالإنكار على خالد ÷، بل وَأَمَرَ أصحابه بذلك، ومع ذلك لم يُنكِرْ النبي × على ابن عمر فعله.
الأثر العاشر: إنكارُ عائشة رضي الله عنها على مروان بن الحكم، وإنكارُ أخيها على معاوية ÷ ومروان
عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز، استعمله معاوية، فخطب فجعل يذكرُ يزيد بن معاوية لكي يُبِايَع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئًا، فقال: خذوه، فدخل بيت عائشة، فلم يقدروا، فقال مروان: إنَّ هذا الذي أنزل الله فيه: {والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني}. فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئًا من القرآن إلا أنَّ الله أنزل عذري)[45](.
ورواه الحاكم عن محمد بن زياد، قال: لما بايع معاوية لابنه يزيد، قال مروان: سُنَّةُ أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سُنَّةُ هرقل وقيصر. فقال: أنزل الله فيك: {والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني}. قال: فبلغ عائشة رضي الله عنها، فقالت: كَذَبَ والله ما هو به، ولكنَّ رسول الله × لَعَنَ أبا مروان، ومروانُ في صلبه، فمروان قَصَصٌ مِن لعنة الله عز وجل)[46](.
فعائشة رضي الله عنها أنكرت على مروان قوله وهو أمير المدينة، وأنكر أخوها عبد الرحمن على معاوية ÷ أَخْذَ البيعة لابنه يزيد، مع غَيْبة معاوية، ولم تُنكر عائشة على أخيها عبد الرحمن.
الأثر الحادي عشر: إنكارُ ابن مسعود على عثمان رضي الله عنهم
فقد روى الشيخان عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلَّى بنا عثمان بمنى أربع ركعات. فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود، فاسترجع، ثم قال: صلَّيْتُ مع رسول الله × بمنى ركعتين، وصلَّيْتُ مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصلَّيْتُ مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حَظِّي مِنْ أربع ركعات، ركعتان متقبلتان)[47](.
زاد أبو داود في سننه: قال الأعمش، فحدثني معاوية بن قرة، عن أشياخه، أنَّ عبد الله صَلَّى أربعًا، قال: فقيل له: عِبْتَ على عثمان ثم صلَّيْتَ أربعًا، قال: >الخلاف شر<)[48](.
وهذا إنكارٌ من ابن مسعود على عثمان رضي الله عنهما تغيير شيءٍ من السنَّة في الحجِّ، مع كون عثمان ÷ كان متأوِّلًا. والحديث ظاهرٌ في أنَّ إنكار ابن مسعود كان في غَيْبة عثمان، لا في محضره.
وهكذا كان السلف رحمهم الله يُنكرون على الولاة، فضلًا عن غيرهم.
قال النووي -رحمه الله-: (ولا يختصُّ الأمرُ والنهي بأصحاب الولايات والمراتب، بل ذلك ثابتٌ لآحاد المسلمين، وواجبٌ عليهم، قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإنَّ غَيْرَ الولاة في الصدر الأول كانوا يأمرون الولاةَ، وينهونهم، مع تقرير المسلمين إياهم وتَرْكِ توبيخهم على التشاغل بذلك بغير ولاية، ويدلُّ عليه قولُ النبي × في صحيح مسلم: >من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه<))[49](.
وقال ابنُ القيِّمِ-رحمه الله ـ: (فقد أنكر أبو سعيدٍ على مروانَ وهو أميرٌ على المَدينةِ، وأنكر عُبادةُ بنُ الصَّامِتِ على معاويةَ وهو خليفَةٌ، وأنكر ابنُ عمرَ على الحَجَّاج مع سَطوتِهِ وبأسِهِ، وأنكرَ على عمرٍو بنِ سعيدٍ وهو أميرٌ على المَدينةِ، وهذا كثيرٌ جِدًّا مِن إنكارِهم على الأمراءِ والولاةِ إذا خرجوا عن العَدلِ لم يخافوا سَوْطَهُم ولا عقوبتَهم))[50](.
وعلى هذا، فباب الإنكار يختلف عن باب النصيحة، وإنْ كان الإنكار معدودًا من النصيحة في الجملة.
قال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-: (إنَّ الإنكار أضيقُ من النصيحة، فالنصيحةُ اسم عامٌّ يشمل أشياء كثيرة كما مر معنا في حديث >الدين النصيحة<، ومنها الإنكار، فالإنكارُ حالٌ مِن أحوال النصيحة، ولهذا كان مقيَّدًا بقيود، وله ضوابط، فمِنْ ضوابطه: أنَّ الإنكار الأصلُ فيه أنْ يكون علنًا، لقوله<من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه>، وهذا بشرط رؤية المنكر))[51](.
وقال في موضع آخر: (إنَّ النصوص جاء فيها لفظُ النصيحة، وجاء فيها لفظ الإنكار، وفرقٌ بين النصيحة والإنكار، فقد روى ابن أبي عاصم وغيرُه من قوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ: >من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية<، وروى أبو سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عنْهُ عن النبي × أنه قال: >من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان<.
ففي حديث أبي سعيد ÷ جَعَلَ مراتب الإنكار ثلاثة، وقيَّد الإنكار برؤية المنكر، وجَعَل الإنكار على المنكر نفسه.
والذي دَرَج عليه سلفنا الصالح -من الصحابة فمن بعدهم- أنَّ الواقِعَ في المُنكَر إذا كان مُظهرًا له أمام الناس فإنه يُنكرُ عليه، فإذا وَقَع أيُّ مسلم في مُنكر وأظهره، فإنَّ على مَن رآه الإنكار عليه علنًا، باليد إذا كان المنكر من أهل اليد، أو باللسان إن لم يكن من أهل اليد، أو بالقلب إن لم يستطع المرتبتين الأوليين.
وقد قيّد النبي × الإنكار بقوله >مَن رأى منكم منكرا< وهذا الوصف مقصود بالحكم؛ إذْ الرؤية مختلفةٌ عن السَّمْع، فلا يصحُّ أنَّ مَن سمع منك منكرًا فليغيره بيده أو بلسانه، فتحرّر بهذا أنَّ المنكر إذا ظَهَر يُنكرُ بما جاء في حديث أبي سعيد.
أما إذا لم يَظهَر، أو لم يُرَ صاحبُه يواقِعُه، أو كان المنكر فاشيًا ولم يكن الواقِعُ فيه معيّنًا، فإنَّ بابه يكون باب النصيحة، فمثلًا رأيتَ فلانًا من الناس يواقع منكرًا في الشارع، أو كنَّا حضورًا عند أميرٍ، وذَكَرَ مخالفة شرعية ظاهرة سمعناها منه ورأيناها، فإننا ننكر عليه ما لم يترتَّب على هذا الإنكار مفسدة.
وأما إذا كان الأمر خفيًّا، أو كان مما يتعلق بوِلايته، ولم يكن هو الواقع فيه، وإنما الواقع في الأمر ما تحت ولايته، فإننا لا نقول إنَّ المنكر وَقَعَ منه ورأيناه منه، فلا يكون البابُ إنكار، وإنما يكون الباب بابَ نصيحة؛ لأنَّ الأمر لم يقع فيه هو علانية، وإنما هو منتشرٌ، ويُراد مِن الوالي أنْ يُصلِحَ هذا، فيكون الأمر بنصيحته وأنَّها تكون سرًّا وليست بِعَلَن.
وقد روى البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد ÷ أنه خوطب بقوله: ألا تنصح لعثمان؟ حينما وقع منه بعض ما وقع في أواخر خلافته، ألا تنصح لعثمان؛ يعني لبعض الفتن التي بدأت تظهر في أواخر أيامه، قال أسامة: أمَا إني لم أُبْدِ ذلك علانية، وقد بذلته له سرًّا، ولن أكون فاتحًا لباب فتنة.
وقد عَلَّق الحافظ ابن حجر على هذا الأثر بقوله: إنَّ النصيحة للوالي إذا خرجت إلى العَلَن صار مبلغها ومؤداها إلى الخروج على الولاة.
وهذا الأمر -وهو الخروج على الولاة- جاءت الشريعة بِوَصْدِه؛ بل كان مما يميز أهل السنَّة والجماعة أنهم يرون الطاعة، ولا ينزعون يدًا من طاعة ولاة الأمر، وأنهم يبذلون لهم الدعاء في السرِّ والعلن، والنصيحة العلنيّة هذه هي مِن نوعِ التشهير الذي يوغر الصدور، ويُخرجُ الناس عن طاعته، ويؤدي بهم إلى الخروج على ولاة الأمور، هذا ملخص كلام الحافظ ابن حجر على كلام أسامة))[52](.
وبهذا يتبيَّن أن الإنكار يكون لما عُلِم وقوعه مِن صاحب المنكر، كما لو رُؤي، أو سُمع، كما جاء في الحديث: >من رأى منكم منكرًا< فقيَّده بالرؤية، والمرادُ بها العلم لا خصوص الرؤية، فيشملُ السماع والعلم المتحقق كالاشتهار والذيوع، وسواءٌ وقع المنكر في حضرةِ المنكِر أو في غَيْبَتِه، أما في حضرته فظاهرٌ، وأما في غَيْبَتِه فكما لو نُقل المنكرُ مصوَّرًا أو مسموعًا أو مكتوبًا عبر وسائل البث والإعلان والنقل ووسائل التواصل، إما بتغريدة، أو مقالة، أو محاضرة، أو لقاءٍ ونحو ذلك.
وأما النصيحة فتكون لما خَفِيَ، أو كان شائعًا لكنَّ الواقع فيه ليس معيَّنًا، وكذلك ما يحصل في ولاية السلطان مما لم يقع من السلطان نفسه، بل في وزارات الدولة وهيئاتها، أو من بعض المسؤولين ونحو ذلك، فيُنصح السلطان ليغير ما في ولايته من المنكرات.
وللشيخ عبد المحسن العباد البدر -حفظه الله- مقالٌ بعنوان: >حقوق ولاة الأمر المسلمين: النصحُ والدعاءُ لهم والسمعُ والطاعةُ بالمعروف<)[53](، فرَّق فيه بين النصيحة والإنكار، حيث ذكر النصيحة في حقوق الولاة بقوله: (ومِن حقوق ولاة الأمر المسلمين على الرعية النصحُ لهم سرًّا وبرفق ولين، والسمع والطاعة لهم في المعروف) مستدلًّا بأحاديث النصيحة، ثم ذَكَر وجوب إنكار المنكر إذا صدر من الولاة بقوله: (وإذا ظهرت أمورٌ منكرة من مسئولين في الدولة أو غير مسئولين، سواء في الصحف أو في غيرها، فإنَّ الواجب إنكارُ المنكر علانية كما كان ظهوره علانية) مستدلًّا بأحاديث وجوب إنكار المنكر.
فَجَعَل الشيخ لكلٍّ منهما بابًا يَخُصُّه، ودليلًا يَخُصُّه.
وسرُّ الاختلاف بين النصيحة والإنكار: أنَّ النظر في النصيحة هو باعتبار المنصوح ذاته، بقصد إصلاحه، وتكميله، وتقويمه، وأما إنكار المنكر فإنَّ النظر فيه باعتبار المُنْكَرِ ذاته لا باعتبار صاحبه، حيث يُقصد به التحذير من المُنْكَر، والنَّهي عنه، ومِن هنا جاء الأمرُ بتغييرِه وإعدامِه، ولأجل هذا المعنى اختصت النصيحةُ بالإسرار، لأنَّ المقصود منها إصلاحُ المنصوح، وتقويمُه، لا فضيحته، وهتك ستره، وكشف عيوبه، وأما المُنْكَر فالمقصود من إنكاره اجتنابُه وإعدامُه، والتحذير منه، وبيان نكارته، والنهي عن ارتكابه، أو اعتقاده، فما كان ظاهرًا وجب إنكاره ظاهرًا، بالنهي عنه، وتغييره حسب القدرة.
وقد تكلّم الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في الفَرْقِ بين ما يجب إظهاره من الإنكار أو النصيحة، وما يجب إسرارُه منها بكلامٍ نفيس أسوقه بطوله، حيث قال:
(اعلم أنَّ ذِكْرَ الإنسان بما يكره محرَّم إذا كان المقصود منه مجرَّدَ الذمِّ والعيب والنقص. فأمَّا إنْ كان فيه مصلحةٌ لعامَّة المسلمين، أو خاصَّة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرّم، بل مندوب إليه.
وقد قرَّرَ علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جَرْحِ الرواة وبين الغِيبة، وردُّوا على من سوَّى بينهما من المتعبَّدين وغيرهم ممن لا يتَّسع علمُه.
ولا فَرقَ بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بَيْن من تُقبلُ روايته منهم ومن لا تُقبل، وبَيْنَ تَبْيين خطأ من أخطأ منهم في فهمِ معاني الكتاب والسنة وتأوَّل شيئًا منها على غير تأويله، وتمسَّك بما لا يتمسَّك به، ليُحِذِّر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضًا…
ولم يُنْكِر ذلك أحدٌ مِن أهل العلم، ولا ادَّعى فيه طعنًا على مَن ردَّ عليه قوله، ولا ذمًّا ولا نقصًا، اللهم إلا أن يكون المصَنِّفُ ممن يُفحش في الكلام، ويُسيء الأدب في العبارة، فيُنكر عليه فحاشتُه وإساءتُه دون أصل ردِّه ومخالفتِه إقامة الحجج الشرعية والأدلةِ المعتبرة.
وسببُ ذلك أنَّ علماء الدين كلَّهم مُجمعون على قَصدِ إظهار الحقِّ الذي بعث الله به رسوله ×، وأنْ يكون الدين كلُّه لله، وأنْ تكون كلمته هي العليا…
فحينئذ، فردُّ المقالات الضعيفة، وتبيينُ الحقِّ في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله، ويُثنون عليه. فلا يكون داخلًا في باب الغِيبة بالكلية، فلو فُرض أنَّ أحدًا يكره إظهارَ خطئه المخالف للحقّ، فلا عبرة بكراهته لذلك…
ثم ذكر ابن رجب أمثلة من ردود العلماء على بعضهم في بعض المسائل، ثم قال: ولم يَعُدّ أحدٌ منهم مُخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنًا في هؤلاء الأئمة ولا عيبًا لهم. وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها…
ومن عُرف منه أنه أراد بردِّه على العلماء النصيحة لله ورسوله، فإنه يجب أن يُعامَل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان.
ومن عُرف منه أنه أراد بردِّه عليهم التنقص والذمّ، وإظهار العيب، فإنه يستحق أن يُقابَل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة) )[54](.
ومما ورد في السنَّة في بيان المعنى والمقصود الأصلي مِن إنكار المنكرات ما رواه البخاري عن النعمان بن بشير ÷ أنَّ النبي × قال: >مثلُ القائمِ على حدود الله والواقعِ فيها، كَمَثَلِ قومٍ استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مَرُّوا على مَنْ فوقهم، فقالوا: لو أنَّا خَرَقْنا في نصيبنا خَرْقًا، ولم نُؤْذِ مَنْ فَوْقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإنْ أَخَذُوا على أيديهم نَجَوا ونَجَوا جميعًا<)[55](.
قال القاضي أبو يعلى -رحمه الله- مفرِّقًا بين ما كان خاصًّا من المنكرات وما كان عامًّا منها: (إنَّ منفعةَ تلك الأشياء تخصُّه، ومنفعةَ الأمر بالمعروف تعمُّ، فهي كإظهار الشهادتين، وكلمة حقٍّ عند سلطان جائر))[56](.
وقال -رحمه الله-في موضع آخر مبيِّنًا أنَّ المقصدَ من إنكار الشيء إعدامُه وإزالتُه: (إنَّ قَصْدَ التعرُّضِ بالإنكار أن لا يقع المنكر))[57](.
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: (إنَّ الناهي إنما نهى عن الشيء لما فيه من الفساد، فالمقصود عَدَمُه، كما يُنهى عن قتل النفس وشرب الخمر))[58](.
فالمقصود من إنكار المنكر، عَدَمُه وإزالته، وصيانةُ المجتمع، وحفظُ الشريعة، واجتنابُ أسباب الهلاك والفساد، أمَّا النصيحة فيُقصد بها ذاتُ المنصوح.
ومِن هنا كانت النصيحةُ سرًّا، لأنها أدعى للقبول، ولأنَّ إشهارها فضيحة، وكان الإنكارُ علنًا لما ظَهَرَ من المنكرات للزجر عنها، واجتنباها، وتغييرها.
فإذا علمنا الفرق بين النصيحة والإنكار، وما الذي يجتمعان فيه ويفترقان، تبيَّن لنا خطأ من استدلَّ بحديث عياض بن غنم ÷ في إسرار النصيحة للحاكم، على ما يقع منهم من منكرات.
يؤكده أنَّ حديث النصيحة قد نُصَّ فيه على الخلوة بالسلطان عند إبداء النصيحة، وعدمِ نُصحِه في مَحْضِرِ أحدٍ من الناس في مجلسه، فضلًا عن غير مجلسه في حال بعده وغَيْبته، فقد جاء فيه: >ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإنْ قبل منه فذاك، وإلا قد أدَّى الذي عليه<.
ومثلُه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن جبير، قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: آمر أميري بالمعروف؟ قال: إنْ خفت أنْ يقتلك فلا تؤنِّب الإمام، فإنْ كنتَ لا بد فاعلًا فيما بينك وبينه)[59](.
فالنصيحةُ المأمور بها للسلطان، لا تكون في محضر أحدٍ من الناس، بل تكون بالخلوة به، أو الكتابة الخاصة له، ونحو ذلك، وهذا أدعى للقبول.
وأما الإنكارُ على السلطان، فيكون عند وقوع السلطان في منكرٍ بحضرة من رآه، على ما دلَّت عليه الأحاديث، وفَعَلَه الصحابة ~، وقرَّره العلماء.
وبهذا يتبيَّن أنَّ باب النصيحة يختلف عن باب الإنكار، وإنَّ لكلِّ منهما وجه لا يجتمع معه فيه الآخر، مع اشتراكهما في بعض المعاني، ويبقى البحث بعد ذلك في طريقة الإنكار، هل يُشرع الجهر به في غَيْبَةِ الحاكم، أم يُقتصر فيه على ما يكون في حضرته ومجلسه، أم يجوز هذا في حال، وذاك في حال؟
التمييز بين الإنكار مِن جهة وبين العيب والقدح والسبِّ والنقد والتشهير وتعداد المساوئ وتلمس الهفوات والزلات من جهة أخرى
أما الإنكار، فإنَّ المنكر إما أنْ يقع خاصًّا بين المُنكِر والمُنْكَرِ عليه، بحيث لا يشهده غيرهما، وإما أنْ يقع علنًا بحيث يراه الناس، قلُّوا أو كثروا، إما في مجلس، أو في محفلٍ عام، أو في وسائل التواصل والإعلام، أو في كتاب، أو مقال، ونحو ذلك.
فأَمَّا إنْ وقع المنكر خاصًّا، فالمقصودُ من إنكاره حينئذٍ نصحُ الواقع فيه، ونهيُه عنه، ومنعُه منه، حسب الاستطاعة والقدرة، إما باليد لذوي اليد، أو باللسان، أو بالقلب لمن عجز عنه اللسان.
وأما إن وقع علنًا، فيزيدُ على قَصْدِ نُصحِ الواقع فيه: قَصْد نصحِ الناس، وتحذيرهم من المنكر، وبيان مخالفته للشريعة لئلا يقع فيه آخرون، صيانة المجتمع الذي أُعلن فيه المنكر، أو المجلس.
وعلى هذا فالكلامُ في إنكار المنكر يتوجَّه على ذاتِ المنكر، وإنْ كان يتضمن نَهْيَ صاحبه، وزَجْرَه، والتغليظَ عليه إن اقتضى المقام، وعقوبةَ من يستحق العقوبة من قِبَل ذوي اليد والسلطان، لكنَّ المقصدَ الأصلي هو: الزجرُ عن المنكر، وإزالتُه، وإعدامُه، والنهي عن مثله.
ولذلك عَرَّفَ العلماء الحدَّ الشرعي، وهي العقوبات المقدرة، كجلد القاذف وشارب الخمر وقطع يد السارق، ونحو ذلك، بقولهم: عقوبةٌ مقدَّرةٌ شرعًا في معصية لِتَمْنَعَ مِن الوقوع في مثلها.
وصورة الإنكار: أنْ يُقال لمن وقع في منكرٍ فِعْلِيٍّ، كما لو شرب الخمر مثلًا: اتق الله، وهذا محرمٌ لا يجوز، ونحو ذلك، ويُقال لمن قال مقالة باطلة: هذا قول باطل مخالف للنص أو الإجماع، وكذلك الحال مثلًا فيما إذا سُنَّ قانونٌ محرم، يتضمن ربًا مثلًا، فيُقال: هذا القانون محرم وربا، ونحو ذلك.
وأما التشهيرُ والعيبُ والنقدُ والقدحُ، فضلًا عن السبَّ ونحوه، فهو الوقيعة في صاحبِ المنكر، وذِكْرُ معايبه، وتعدادُ مساوئه، كأن يُقال في حق الشخص: فاسق، فاجرٌ، مبتدعٌ، ضالٌ، ونحو ذلك، وفي حق السلطان: ظلوم غشوم، فاسقٌ فاجرٌ، لا يرعى حرمة ولا عهدًا، يُقرِّبُ الفسقة ويُبعد أهل الطاعة، يستأثر بالدنيا، ويمنع الحقوق، لا يُحسن التدبير ولا الحكم، ونحو ذلك.
فالتشهيرُ والعيبُ والنقدُ والقدحُ يُقصد به صاحبُ المنكر نفسُه وشخصُه وذاتُه، للتنفيرِ عنه، والتحذير منه، ودعوة الناس إلى مجانبته والبعدِ عنه، وإذا كان في حقِّ السلطان قُصد به ذاتُ السلطان، بإهانته، والتزهيدِ فيه، وتحقيرِ شأنه، وتهوينِ سلطانه، وتبغيضه عند الناس، ولا يُقصد به ذاتُ المنكر، وعلى هذا، فأثَرُ النقد والعيب والتشهير والقدح وعاقبتُه بالنسبة للحاكم: بغضُه، وشحنُ القلوب عليه، وإيغارُ الصدور، والتنفيرُ عنه.
فالتشهيرُ مصدر شَهَّرَ، وهو فَضْحُ المُشَهَّر به وإظهارُ مساوئه.
جاء في >معجم اللغة العربية المعاصرة<: (شهَّر بفلان: فضحه، عابه، وأذاع عنه السوء))[60](.
والنَّقْدُ، مِن نَقَدَ ينقد نقدًا، فهو ناقد، وهو كَشْفُ العيوب والمحاسن وعَرْضُها.
جاء في >معجم اللغة العربية المعاصرة<: (نَقَدَ الشيء: بيَّن حَسَنَه ورديئه، أظهر عيوبه ومحاسنه… نَقَدَ الناس: أظهر ما بهم من عيوب))[61](.
والقَدْحُ: مِن قَدَحَ يقدح قدحًا، وهو التشكيك في الشيء، وإبطاله، وإخراج مساوئه.
فالقادح: يُشكك في المقدوح فيه، ويُبطل صلاحيته إمَّا عمومًا، أو في شيء مخصوص.
جاء في >معجم اللغة العربية المعاصرة<: (قَدَحَ في شهادته: شكَّك فيها، أو اعتبرها باطلة))[62](.
وفي موضع آخر من المعجم: (تعايب القوم: قَدَح بعضهم بعضًا أو ذَكَر كلٌّ منهم نقائص الآخر))[63](.
والعَيْبُ: مِن عاب عيب عيبًا، وهو شَيْنُ الشيء، وَوَصْمُه بالنَّقْص.
جاء في >معجم اللغة العربية المعاصرة<: (عاب العمل: صار ذا نقيصةٍ أو وَصَمةٍ أو شَيْنٍ… عاب الشيء: جَعَلَه مَعِيبًا… أعاب الشخص: عابه، ذَمَّه))[64](.
والسبُّ: مِن سبَّ يسبُّ سبًّا، وهو الشتم والعيب والإهانة.
جاء في >معجم اللغة العربية المعاصرة<: (سبَّ المقصِّرَ في عمله: شتمه وعابه، أهانه بكلام جارح… استبَّ الخصوم: شتم بعضهم بعضًا، أهان بعضهم بعضًا بكلام جارح))[65](.
والتشنيع: مِن شنَّع بـ أو على، يُشنِّعُ، تشنيعًا، وهو الفضحُ وتشويهُ السمعة.
جاء في >معجم اللغة العربية المعاصرة<: (شنَّع بفلان/ شنَّع على فلان: فضحه، وشوَّه ذِكْره وسمعته بين الناس))[66](.
فالسبُّ والقدحُ والعيبُ والتشهيرُ والتشنيع بالشخص، يُقصد به ذات الشخص، ويُراد به: عيبه وتنقيصه وتشويه سمعته وكشف عيوبه.
وهذا بخلاف إنكار المنكر الذي يُقصد بإنكاره ذاتُ المنكر، بالتحذير من المنكر نفسه، إما بالتحذير من العمل به إن كان عمليًّا، أو اعتقاده إن كان علميًّا.
ومن هنا فرّق العلماء بين التحذير من البدعة، والتحذير من المبتدع، فأوجبوا التحذير من البدعة بإنكارها، والردِّ على قائلها، إذ قد يكون مخطئًا لا مبتدعًا، بينما أوجبوا التحذير من الداعية إلى البدعة، فأوجبوا هجره، والتشهير به، والتحذيرَ من شخصه وعينه.
فالمقصد من التحذير من البدعة: التنفيرُ من البدعة ونصحُ من صدرت منه، ومن التشهير بالمبتدع: التنفيرُ من صاحب البدعة.
فالتشهيرُ بالحاكم وعيبُه ونقدُه في المحافل العامة محرمٌ ومنهيٌ عنه، لما يدعو إليه من الفُرقة، والشقاق، والعصيان، وهو نوعٌ من الخروج، وأَوَّلُ مبادئه.
وقد عقد أئمة السنّة أبوابًا في كتبهم في وجوب توقير السلطان، والنهي عن سبّه، وعيبه، والطعن فيه، ففي >السُّنة< لابن أبي عاصم -رحمه الله-: (باب: ما ذُكر عن النبي × من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته))[67](.
وفي كتاب >الحُجة في بيان المحجة< لأبي القاسم الأصبهاني -رحمه الله- فصل في: (النهي عن سبِّ الأمراء والولاة وعصيانهم) )[68](.
وروى الطبراني في الكبير من حديث عمرو البكالي ÷ قال: سمعت رسول الله × يقول: >إذا كان عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاةِ والزكاة، فقد حرَّمَ اللهُ عليكم سبَّهم، وحلَّ لكم الصلاةُ خلفَهم<)[69](. ورُوي موقوفًا على عمرو البكالي ÷.
وروى ابن أبي عاصم عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: نهانا كبراءُنا من أصحاب رسول الله × قال: (لا تسبُّوا أمراءَكم، ولا تغشُّوهم، ولا تُبغضوهم، واتقوا اللهَ واصبروا، فإنَّ الأمرَ قريب))[70](.
وقال أبو الدرداء ÷: (إنَّ أولَّ نفاقِ المرِء طعنهُ على إمامه))[71](.
وقال أبو إدريس الخولاني -رحمه الله-: (إياكم والطعنَ على الأئمة، فإنَّ الطعنَ عليهم هي الحالقة؛ حالقةُ الدين ليس حالقةَ الشَّعرِ، ألا إنَّ الطعانين الذين يطعنون في الأئمة، ألا إنَّ الطعانين: هم الخائبون وشِرارُ الأشرار))[72](
وعن عقبة بن وساج قال: كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطَعْنِهِم في أمرائهم، فحججتُ فلقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول الله ×، وقد جَعَل الله عندك علمًا، وأناسٌ بهذا العراق يطعنون على أمرائهم، ويشهدون عليهم بالضلالة؟ فقال لي: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ثم حَدَّث بحديث ذمِّ الخوارج)[73](.
من صور ذلك: ما يسلكه بعض أهل السياسة وغيرهم من الدعاة في عمل الندوات والتجمعات العامة التي تُسلط فيها سهام النقد للحاكم وولاته، ويجتمع فيها الدهماء.
وقد أخرج ابن سعد في >الطبقات الكبرى< عن هلال بن أبي حميد قال: سمعت عبد الله بن عكيم يقول: لا أُعين على دم خليفة أبدًا بعد عثمان. فيقال له: يا أبا معبد أَوَأَعَنْتَ على دمه؟ فيقول: إني أَعُدُّ ذِكرَ مساويه عونًا على دمه)[74](.
فتعدادُ المساوئ والمعايب يوغر الصدور على الحاكم، ويُجرئ على الوقيعة فيه، حتى يُفضي إلى الخروج والثورة.
وأما إنكار المنكر فهو من النصيحة الواجبة للمسلمين وأئمتهم، وليست من إهانة صاحب المنكر أو السلطان، فضلًا عن أن تكون داخلة في سبِّ السلطان، أو التأليب عليه، أو إهانته، أو عيبه، ونحو ذلك.
ولذلك جاءت الشريعة بالنصيحة والإنكار، كلٌّ في موضعه، ولم تأت بالعيب، والسبِّ والتشهير، وعلى هذا سار العلماء قديمًا وحديثًا.
أنواع المنكرات المتعلقة بالسلطان وفِقْهُ التعامل معها
المنكرات الصادرة في ولاية السلطان أنواع، وهي تختلف بعدة اعتبارات؛ باعتبار مَنْ صدرت منه، وباعتبار نوعِها، من جهة قصورها على ذات الشخص أو تعدِّيها، وباعتبار ما تضمَّنته من تعدٍّ إن كانت متعدِّية.
وعلى هذا أقول: إنَّ الحالات المتعلقة بالمنكر المتعلق بالسلطان وولايته، أنواع:
أنْ يكون المنكر عامًّا صادرًا في ولاية السلطان دون أن يباشره بنفسه، كما يكون مِن مؤسسات الدولة وهيئاتها، في أيٍّ من السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، كتشريعِ قانون مالي محرم في إحدى هيئات ومؤسسات الدولة، يتضمن ربًا، أو ميسرًا، أو غررًا ونحو ذلك، أو أنْ تُرخِّصَ مؤسسةٌ أمرًا محرمًا، أو تَأْذَنَ بمحرم، كالإِذْن بحفلات الرقص والغناء، أو بيع الخمر، أو استيراد أمورٍ محرمة، أو تولّي المرأة القضاء، أو الإذن بالاختلاط في المدارس، ونحو ذلك من المحرمات والمنكرات.
فما كان هذا سبيله، لم يُوجّه فيه الإنكار على شخص الحاكم، لكونه غير صادرٍ منه، بل صادرٌ في ولايته، فمثلُ هذا بابُه النصيحة للسلطان، وأما المنكرُ نفسه فيُنكرُ على العموم، فيُنكرُ الربا، والخمر، والاختلاط، ويُنكر القانون الربوي، ويُنكر تَولِّي المرأة للقضاء، ويُنكرُ الاختلاط، دون الحاجة إلى التعرض لفاعله.
ويدلُّ عليه عموم أحاديث النصيحة التي سبق ذكرها.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: (ليس من منهج السلف التشهيرُ بعيوب الولاة، وذِكرُ ذلك على المنابر؛ لأنَّ ذلك يُفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضرُّ ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحةُ فيما بينهم وبين السلطان، والكتابةُ إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير.
أمَّا إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فيُنكرُ الزنا، ويُنكرُ الخمر، ويُنكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة. ويكفي إنكارُ المعاصي والتحذير منها من غير أن يُذكر من فعلها لا حاكمًا ولا غير حاكم))[75](.
مع التنبيه عند الإنكار العامِّ في هذا النوع ألا يتضمَّن تحريضًا على الحاكم، وتشهيرًا به، كما لو قيل: الحاكمُ رخَّص محلات الخمور، أو سنَّ القانون الربوي الفلاني، أو ما يتضمن ذلك، مثلُ قول: هذه بيوت الربا منتشرة، وهذه حوانيت الخمر مفتوحة ونحو ذلك، لأنَّ هذا النوع من الإنكار يتضمن التهييج والإثارة، ولا يتحقق به المقصود من تحذير الناس من المحرم، ومنعهم منه. هذا هو الأولى والأقرب إلى تحقيق المصلحة، وهو أبعد عن مبادئ الفتنة وأسباب الشقاق.
قال العثيمين -رحمه الله-: (أنا أريد مثلا أنْ أقول للناس: اجتنبوا الربا، ويأتي ويقول: هذه بيوت الربا معلنة ورافعة البناء، فلا يقول هكذا، يعني: هذا إنكارٌ ضِمْنِيٌّ على الولاة، لكن يقول: تجنَّبوا الربا، والربا محرم، وإنْ كَثُرَ بين الناس، الميسرُ حرام وإن أُقِرَّ، وما أشبه ذلك))[76](.
أن يكون المنكر صادرًا من السلطان نفسه، فهذا نوعان:
النوع الأول: منكرٌ قاصرٌ غير متعدٍّ.
كشرب الخمر، أو الزنا، وغير ذلك من أنواع الفسق والمحرمات.
النوع الثاني: منكرٌ عامٌّ متعدٍّ، وله صورتان:
الصورة الأولى: أن يأمر بمحرّم أو ينهى عن واجب، غير مستحلٍّ لذلك
كما لو أَمَرَ النساء بخلع الحجاب، أو مَنَعَ من صوت الأذان في الفجر، ونحو ذلك.
والصورة الثانية: أن يتضمّن تحريف شيءٍ من الدين، أو التشكيك في بعض أصوله وثوابته
ويكون قد صدر على لسان الحاكم، فأعلنه وصرّح به في مقالة، أو خطابٍ، أو لقاءٍ، أو كتابٍ، ونحو ذلك، كما لو حرّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا، أو سوَّغ بدعة وضلالة، كأن يصرّح بِخَلْقِ القرآن، أو نَفيِ الصفات، أو إنكارِ القدر، أو أن ينفي حُجِّيَة السنَّة، أو يُحسَّنَ بناء الأضرحة والمقامات، أو يُجوِّزَ بناء معابد الوثنيين في بلاد الإسلام ويُحسِّنه، ونحوِ ذلك، أو يصرَّح بحلِّ المعازف، أو الاختلاط، أو حِلِّ بيع الخمر لغير المسلمين مثلًا، أو يُجوِّز الحكم بالقوانين الوضعية متأوّلًا بذلك.
ويدخل في الصورة الثانية أيضًا: أن يفعل ما يتضمن تغيير الشرائع وتحريف السُّنن، كما لو قدَّم الخطبة في العيد على الصلاة، أو قدَّم الصلاة على الخطبة يوم الجمعة، أو قدّم امرأة لتؤمه في صلاة الجماعة من باب المساواة بين الرجال والنساء، أو أن يخطب خطبة واحدة في الجمعة، ونحو ذلك.
فما كان من المنكرات قاصرًا بالحاكم غير متعدٍّ، فضرره عليه، ولا يتعدى أثره إلى الرعية، ولا يترتب عليه تحريف شيء من الدين، فالواجب فيه النصيحة للحاكم، والكتابة له، ووعظه وتذكيره، فإنْ فعله الحاكم علنًا في مجلسه وجب على من قَدَرَ من الحاضرين الإنكار عليه، على ما سبق بيانه.
والدليل على ذلك عموم أحاديث النهي عن المنكر، كحديث: >مَنْ رأى منكم منكرًا فَلْيُغَيِّرْه< الحديث، ونحوه، وفعلِ الصحابة كأنس وعبادة رضي اللهم عنهما، وقد سبق الإشارة إليهما.
ويؤكده أيضًا ما سبق من نصوص العلماء التي سبق ذِكرها.
وأما ما كان عامًّا متعدِّيًا مُعلَنًا، فإنْ كان مِن الصورة الأولى، وهي أنْ يَأْمر السلطان بمحرم أو ينهى عن واجب، غير مستحلٍّ لذلك، فإنَّ الأحسن فيه والأولى: إنكارُ المنكر بدون ذكر الحاكم، مع بذل النصيحة له وتذكيره وموعظته، بالتواصل معه، أو الكتابة إليه، أو عبر من يصل إليه، ونحو ذلك.
ودليله ما سبق أيضًا من أحاديث النصيحة للحاكم، وأحاديث النهي عن المنكر، وأفعال الصحابة رضي الله عنهم التي سبق ذِكرها، وبالنظر أيضًا إلى المقاصد الكلية في الشريعة، وتحقيق المصلحة العامة، بحفظ هيبة الإمام، وصون مكانته، وتعظيم سلطانه، وتَركِ كلِّ ما قد يوهن سلطانه، ويُجرِّئُ على الوقيعة فيه، ويفتح باب الشرِّ.
وإن كان من الصورة الثانية، وهي أن يصدر من السلطان قولٌ باطلٌ يتضمّن تحريفًا للدين، وتشكيكًا في ثوابته، إما على لسانه أو في كتابته، فهذا يجب ردُّه وإبطاله وإنكاره، صيانةً للدين من التحريف، ومنعًا للناس عن فعل الحرام، أو اعتقاده، فإن قاله في مجلسٍ وجب ردُّه وإبطاله في المجلس، وإن قاله علانية في مؤتمرٍ، أو لقاءٍ تلفزيوني، أو في ثنايا خطابٍ مُلقى، أو كَتَبَه في كتاب، أو نشره في مقالة، أو صرَّح به في صحيفة، وجب إنكاره مطلقًا؛ أمامَه أو في غَيْبَتِه، تعظيمًا لحقِّ الله، وتقديمًا له على حقِّ المخلوق، فالنظرُ فيه باعتبار المصلحة العامة بحفظ الدين من التحريف والتغيير، ومنعِ وقوع الناس في الحرام.
ويدلُّ عليه عموم الآيات والأحاديث الآمرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وآثار الصحابة رضي الله عنهم وأفعالهم، كأثر أبي سعيد الخدري ÷ في إنكاره على مروان في تغيير السنَّة بتقديم الخطبة على الصلاة، وإخراج المنبر، وأثر ابن مسعود ÷ في إنكاره على عثمان ÷ الصلاة في منى أربعًا، وأثر عائشة رضي الله عنها وأخيها في الإنكار على معاوية أخذه البيعة لابنه، وأثر عمارة بن رؤيبة ÷ في إنكار رفع اليد في الدعاء يوم الجمعة على المنبر، وغيرها من الآثار التي سبق ذكرها.
وقد قال القرطبي -رحمه الله- في شرح حديث إنكار أبي سعيد ÷ على مروان إخراج المنبر يوم الجمعة وتقديم الخطبة على الصلاة: (وفيه من الفقه: أنَّ سنن الإسلام لا يجوز تغييرُ شيء منها، ولا مِن ترتيبها، وأنَّ تغيير ذلك منكرٌ يجب تغييرُه، وَلَو على الملوك إذا قَدَر على ذلك، ولم يَدْعُ إلى منكر أكبر من ذلك))[77](.
كما قال ابن حجر -رحمه الله- في شرحه للحديث أيضًا: (وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنَّة))[78](.
فإذا كان هذا في السنن الفعلية، فكيف بتغيير السنن في أصول الدين، والتشكيك بقواعد الإسلام، وثوابته؟
قال أبو حامد الغزالي -رحمه الله-: (الحُسبة في البدعة أهمُّ من الحُسبة في كلِّ المنكرات))[79](.
ومواقف السلف في هذا كثيرة، منها موقفهم من فتنة القول بخلق القرآن، وإنكارهم على الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، وصبرُ الإمام أحمد على ذلك، وقد كان المأمون يُضمرُ نفي الصفات والقول بخلق القرآن -قبل أن يُظهر ما يُظهر-، لكنه خاف أنْ يظهره أول الأمر فينكره عليه علماء وقته، لا سيما يزيد بن هارون.
فقد روى عبد الغني المقدسي وغيره عن المأمون أنه قال: لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرتُ القول بخلق القرآن. فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين، وَمَنْ يزيدُ حتى يُتَّقى؟ فقال: ويحك! إني أخاف إنْ أظهرتُه فيردّ عليَّ، فيختلف الناس، فتكون فتنة، وإني أكره الفتنة)[80](.
ومعلوم أنَّ الذي خافه المأمون مِن ردّة فعل يزيد بن هارون وإنكارِه، لم يكن إنكار ذات المقالة وإبطالها، فإنَّ المقالة قد ظهرت قبل تولِّي المأمون، بل قبل حُكْمِ العباسيين، فقد أظهرها الجعدُ بن درهم والجهمُ بن صفوان في أواخر عهد بني أمية، وقد أبطلها السلف وأنكروها في حينها، وصرَّحوا بذلك، واشتهرت مقالتهم، فقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومَنْ قال بخلق القرآن فقد كفر، وإنما خشي المأمون إنكار يزيد بن هارون عليه مقالته علنًا لا سرًّا، فتقع بسبب ذلك فتنة باضطراب الناس عليه، ونفورِ قلوبهم منه، إذ لو كان المعهودُ عن علماء السلف إسرار النصيحة للولاة مطلقًا، وإنْ تضمَّن مُنْكَرُ الولاة تحريفَ الدين، وتغييرَ الشرائع، وتسويغَ البدعة والضلالة، كما فعله المأمون، لما خَشِيَ المأمون الفتنة، وأيُّ فتنة تُخشى في إسرار النصيحة للحاكم؟ بل ما شُرع إسرار النصيحة للحاكم في موضعها إلا لدرء للفتنة.
وهذا يؤكد أنَّ المعهود عن أئمة السلف إنكار المقالات الباطلة التي تتضمن تحريف الدين وتسويغ البدعة والضلالة، أو تحريم حلال، أو تحليل حرام، سواء صدرت من السلطان، أو من دونه.
فإن قال قائل: بل الفتنةُ التي خشيها المأمون هي: أن يقوم يزيد بن هارون بالإنكار عليه في مجلسه لا في غَيْبته، فتنفر منه قلوب مَن حوله من وزرائه وحاشيته.
فالجواب أن يُقال: إنَّ هذا بعيد، إذ المعهود من حاشية الخلفاء تزيينهم أفعال الخلفاء والملوك، وتحسين أقوالهم، ومما يؤكد بُعْدَ هذا الإيراد، أنَّ المعتصم قد دعا إلى القول بخلق القرآن)[81](، وامتحن العلماء، ولم يصبر منهم إلا الإمام أحمد، فأنكر مقالة المعتصم بين يديه، وأمام حاشيته ووزرائه ومستشاريه وقُوّاده، واشتهر ذلك في الآفاق، ومع كلِّ هذا لم ينفضَّ عن المعتصم أحدٌ من حاشيته ووزرائه وجلسائه، بل أيّدوه فيما دعا إليه من الفتنة، ووافقوه عليها.
وكلُّ من تأمَّل وقائع وأحداث فتنة القول بخلق القرآن، وموقف الإمام أحمد -رحمه الله- منها، يجزم أنَّ السلف رحمهم الله لم يكونوا يسكتون عن إنكار منكرات الولاة إذا تضمّنت تحريف الدين، وتبديل الشرائع، وتسويغ البدعة والضلالة والعماية، فإنَّ الإمام أحمد أنكر على المأمون ومَنْ بعده مقالتهم، وصبر على ذلك، وقد ابتُلي بلاءً عظيمًا فصبر، ولم يتأوَّل كما تأوَّل غيره، ولم يُثنِه عن الإنكار والصبر على ذلك اضطراب الناس وقتها، ولا ما ترتب على صبره من الفتنة، وضعفِ هيبة الخليفة، وزعزعةِ مكانته في قلوب الناس، حتى هَمَّ الناسُ بالخروج عليه، فأنكر عليهم الإمام أحمد ذلك، وأَمَرَهُم بالصبر، مع ثباته على موقفه وإنكاره، وهذا يؤكد أنَّ الفتنة بتغيير الدين، وتحريف الشريعة أعظم من فتنة اضطرابِ الناس، وضعفِ هيبة السلطان، وأنَّ الإنكار على المنكر المتضمن لتحريفِ الدين لا يستلزم الثورةَ والخروجَ والتأليبَ والتحريض، بل يمكن الجمعُ بين الإنكار، وصيانةِ الدين من التغيير، وحفظِ الشريعة من التبديل، والقيامِ بحقِّ الله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، مع المحافظة على الجماعة، وَصَوْنِ الإمامة، كما فعله الإمام أحمد.
قال حنبل -رحمه الله-: (اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله، وقالوا له: إنَّ الأمر قد تفاقم وفشا -يَعنُون إظهارَ القول بخلق القرآن وغير ذلك- ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه، فناظَرَهم في ذلك، وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدًا من طاعة، ولا تشقُّوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح برٌّ أو يُستراح مِن فاجر. وقال: ليس هذا صوابًا، هذا خلافُ الآثار))[82](.
فَمَعَ غضبِ الناس مِنْ تَوَلِّي الخليفة للفتنة، ودعوتِه إليها، وبغضِهم لصنيعه فيها، وهمِّهم بالخروج عليه، لم يُغيّر الإمام أحمد موقفَه مِن فتنة الخليفة، مَع وُسْعِهِ أنْ يتأوّل كما تأوَّل غيرُه، فيدرأ بذلك الفتنة، لكنَّه صبر وأنكر، مَع نَهيه الناس في نفس الوقت عن الخروجِ والثورة، فَجَمَعَ بذلك بين حقِّ الله تعالى، وحقِّ الجماعة، وحقِّ الإمامة.
فإنْ قال قائل: إنَّ الإمام أحمد لم يُنكر على الخليفة، وإنما طَلَبَ الخليفة منه الموافقة على القول بخلق القرآن فامتنع، وصبر على ذلك، ولم يُظهر الإنكار على الخليفة في الملأ، وهو بذلك قد دُعي إلى معصية، ومعلومٌ أنه لا طاعة للحاكم إذا أمر بمعصية كما جاءت بذلك الأحاديث.
فالجواب أن يُقال: إنَّ المعنى الذي مِن أجله مُنع من الإنكار على الحاكم علنًا، حتى لو حرَّف الدين، وغيَّر الشرائع، عند من يقول بهذا القول، موجودٌ وأبلغ منه في موقف الإمام أحمد من الفتنة، فإنّ أصحاب هذا القول إنما مَنَعُوا من الجهر بالإنكار في غَيْبَةِ الحاكم، مع تحريفه للدين، لما يترتب عليه عندهم من إضعاف هيبةِ السلطان، وفتحِ باب الشر والفتنة، وإيغارِ الصدور به، فيكون ذلك سببًا في التأليبِ على الحاكم، وهذا المعنى وأبلغُ منه حاصلٌ في موقف الإمام أحمد من الخليفة المعتصم العباسي، بل إنَّ موقفه هذا قد استمرَّ على مدى حكم ثلاثةٍ من الخلفاء: المأمون والمعتصم والواثق، فإنكارُ الإمام أحمد مقالةَ القول بخلق القرآن، إنما كان إنكارًا لما دعا إليه الخليفة علنًا، وصرَّح به، وآذى من خالف فيه، والناس كلهم يعلمون هذا، وقد اشتهر ذلك وذاع في الآفاق، فكان إنكاره للمقالة، هو إنكارٌ على الخليفة وما دعا إليه، وفي صبره على ذلك وعدمِ استجابته لما أريد منه معاندةٌ للخليفة فيما يريد ويطلب، ومخالفةٌ له، ولا شكَّ أنَّ أثر هذا الموقف في زعزعةِ مكانةِ الخليفة، وإضعافِ هيبته في النفوس وعند الناس، أشدُّ وأبلغ من مجرد الإنكار عليه في غَيْبته، لما في موقف الإمام أحمد من نوعِ التحدي والإصرار على مخالفة مراد الخليفة. فأين هذا الموقف العظيم، والإنكار الكبير، وأثره في ضعضعة هيبة السلطان، وإضعاف مكانته، ومنزلته، وتوهين سلطانه، مِن مجرد إنكارٍ قد يُكتب اليوم إما في مقالةٍ أو بيانٍ، أو يُقال في محاضرةٍ، أو يُنشر في تغريدةٍ، ونحو ذلك، ويكون الإنكار على تحريفٍ للدين صدر على لسان الحاكم، دون أن يكون الحاكم قد أعلن الإصرارَ على هذا التحريف، أو أطلق التحدِّي فيه، أو توعَّد من خالفه، كما حصل من المأمون ومن بعده، فشتَّانٌ بين الصورتين والحالين والإنكارين!
ولما كان موقف الإمام أحمد يتضمّن نوعًا من التحدّي للخليفة، ويستلزم إضعاف هيبته وسلطانه، أشار على المعتصم بعضُ خَواصِّه وقُوَّاده بعدم إطلاق الإمام أحمد حتى يوافق على ما يُراد منه.
فقد قال الإمام أحمد: (لولا الخبيث ابن أبي دؤاد كان أبو إسحاق -أي: المعتصم- قد خلَّاني، ولكن هو وإسحاق بن إبراهيم -وهو قائد الشرطة- قالا له: يا أمير المؤمنين، ليس من تدبير الخلافة أنْ يخالف خليفتين وتخلي سبيله))[83](.
وقال ابن أبي دؤاد للمعتصم مرةً لما رأى منه رِقَّة ورأفة بالإمام أحمد: (يا أمير المؤمنين، إنْ تَرَكْتَه يُقال: غَلَبَ خليفتين) فهاجه ذلك)[84](.
وأمَّا دعوى أنَّ الإمام أحمد إنما دُعي إلى معصية، ولا طاعة للحكام في ذلك، وأنَّ ذلك سبب امتناعه عن الإجابة وصبره.
فيُقال جوابًا على ذلك: قد كان بوسع الإمام أحمد أن يتأوَّل كما تأوَّل غيره، والتأويل ليس معصية في مثل هذا الحال، فكان يُمكنه أن يدرأ بتأويله الفتنة، ويكون بذلك قد جمع بين درء الفتنة، وعدم المعصية، ولكنَّه لم يفعل، نظرًا لما يترتب على ذلك من تحريف الدين، وتغيير الشرائع.
ثم إنَّ المعصية التي لا طاعة فيها لمخلوق، هي ما لا يمكن التخلص منها بتأويل، كما لو أُمر بشرب الخمر، أو الزنا، أو بقتل من لا يجوز قتله ونحو ذلك، وأما ما يدخله التأويل، وتحصل به النجاة، وتُدرأ به الفتنة، فليس بمعصية.
قال القاضي أبو يعلى -رحمه الله- في التمثيل بما لا طاعة فيه للحاكم: (إذا أُمروا بفعل ما لا يجوز فعله، مثل أن يُأمروا بالقتل لمن لا يجوز قتله، أو قطع يده، أو أخذ ماله، فههنا لا يجوز طاعته، ويجب الامتناع عليه بجميع ما يقدر عليه))[85](.
وهذا الموقف يؤكد أنَّ كلَّ ما يترتب عليه تحريف الدين، وتغيير الشرائع والسنن، لا يجوز السكوت عنه، وأنَّ السكوت عنه هو الفتنة، وقد كان الإمام أحمد يعلم ما سيترتب على إجابته، ولو متأوِّلًا، فإنَّ المقالة لو صدرت منه وقتها لَلَقِيَتْ انتشارًا واسعًا، يترتب عليه ضياع الحق، وذيوع الضلالة، ولا يُمكن ضبط الأمور بعد انتشار المقالة وذيوعها في الآفاق.
ولذلك قال المرُّوذي -رحمه الله-: جئتُ إلى الإمام أحمد وهو بَيْن الهُنْبازَيْن! فقلت: يا أستاذ! قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} قال: يا مرُّوذي، اخرج، وانظر أيَّ شيء ترى. قال: فخرجتُ إلى رَحْبةِ دار الخلافة، فرأيتُ خلقًا من الناس لا يُحصي عددهم إلا الله، والصُّحُف في أيديهم، والأقلام والمحابر في أذرعتهم. فقال لهم المرُّوذي: أيُّ شيءٍ تعملون؟ قالوا: ننتظر ما يقول أحمد فنكتبه. فقال المرُّوذي: مكانكم، فدخل إلى الإمام أحمد وهو قائم بَيْن الهُنْبازَيْن، فقال: لقد رأيتُ قومًا بأيديهم الصُحُف والأقلام ينتظرون ما تقول فيكتبونه. فقال: يا مرُّوذي، أُضِلُّ هؤلاء كلهم؟ أقتلُ نفسي ولا أُضِلُّ هؤلاء)[86](.
وقال إسحاق بن حنبل -رحمه الله-: (قال أبي: -وهو عمُّ الإمام أحمد- دخلتُ على أبي عبد الله مع حاجب إسحاق الذي يقال له: البخاري، فقلتُ له: يا أبا عبد الله، قد أجاب أصحابك، وقد أعذرت فيما بينك وبين الله عز وجل، وقد أجاب القوم وبقيت أنت -يعني بقيت في الحبس والضيق-. فقال لي: يا عم، إذا أجاب العالم تَقِيَّة، والجاهلُ يَجْهَل، فمتى يَتَبَيَّنُ الحقُّ؟!))[87](
فالسكوتُ على مقالةٍ تتضمن تحريف الدين، وتغيير الشرائع والسنن، مع ذيوعها وانتشارها وإعلانها، وتبنّي الولاة لها، أمرٌ يُؤذن بشرٍّ عظيم، ومن هنا كان المتعيّن والواجب رَدَّ المقالة، وإبطال الضلالة، مع المحافظة على الجماعة، وَصَوْن الإمامة، والتلطف في العبارة، على نحو ما فعله الإمام أحمد -رحمه الله-.
وقد كان بعض الولاة يهابُ مِن بعض العلماء، بسبب ما عُرف عنهم من الإنكار على كل ما يتضمّنُ تحريفًا للدين، فقد قال عبد الحميد سبط ابن عبد العزيز: سمعتُ أميراً كان بالساحل من دمشق، وقد دَفَنَّا الأوزاعي ثمَّة، ونحن عند القبر يقول: رحمك الله أبا عمرو قد كنتُ أخافك أكثر مِمَّن وَلَّاني)[88](.
وقد نصَّ العلماء على أنَّ الإمام إذا أعلن بفسقه، لا سيما إنْ كان في تحريف الدين وتزييفه، فلا غِيبة له.
فقد قال يحيى بن أبي كثير: (ثلاثة لا غِيبة فيهم: إمام جائر، وصاحب بدعة، وفاسق))[89](.
ونُقل مثله عن عيسى بن دينار، والحسن البصري.
قال ابن رشد الجدّ -رحمه الله- معلِّقًا: (والإمامُ الجائر، والفاسق المعلنُ، قد اشتهر أمرهما عند الناس، فلا غِيبة في أنْ يُذكر مِن جَوْرِ الجائر، وفِسْقِ الفاسق، ما هو معلومٌ مِن كلِّ واحد منهما))[90](.
وقد اشتهر عن السلف كلامُهم في الحجَّاج بن يوسف في غَيْبَتِهِ، بسبب ما اشتهر عنه من الفسق، والفجور، والجور، والظلم)[91](.
وقيل للحسن البصري: إنَّ الحجَّاج قد قتل سعيد بن جبير، فقال: اللهم أنت على فاسقِ ثقيف، والله لو أنَّ ما بين المشرق والمغرب اشتركوا في قتل سعيد لَكَبَّهم الله تعالى في النار)[92](.
وقال حرب الكرماني: (سألتُ إسحاق -أي: ابن راهويه- عن غِيبة السلطان الجائر، قال: لا يكون فيهم إلا ما يُكرَهُ للإنسان أنْ يُعَوِّدَ لسانه.
حدثنا الأخضر، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا خالد، سمعت عبيد الله يقول في غِيبة الخوارج والسلطان الذي قد أعلن لم يَرَ لهم غِيبة، فأمَّا مَنْ يَعلمُ أنه مذنب، وهو يُحبُّ أن يَستتر، فرأى ذلك منهم غِيبة))[93](.
فإن قال قائل: هذه الآثار أعمُّ من إنكار تحريفٍ الدين خاصّة، أو تغيير الشرائع، فإنها تعمُّ كل فاسقٍ وفاجرٍ وظالمٍ من السلاطين، وهذا أعمُّ من موضع النزاع.
فالجواب أن يُقال:
إما أن تكون هذ الآثار محمولةً على من كَثُر فسقه وفجوره من السلاطين، وتمادى في خروجه عن حدِّ الشريعة، وعلى هذا فيكون تحريفُ الدين، وتغييرُ الشرائع أعظم أنواع الفسق والفجور.
أو يُقال: إنها محمولةٌ على مَنْ غَيَّر الشرائع، واستحلَّ المحرمات، وحرَّف الدين ليوافق هواه، وهو موضعُ النزاع، كما ذُكر ذلك عن الحجاج بن يوسف، وصَحَّت به الآثار عنه، والتي تدلُّ على تغييره للشرائع، وتحريفِه للدين.
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: (وأمَّا المبير فهو الحجَّاج بن يوسف هذا، وقد كان ناصبيًّا يبغض عليًّا وشيعته في هوى آل مروان بني أمية، وكان جبارًا عنيدًا مقدامًا على سفك الدماء بأدنى شبهة. وقد رُوي عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرُها الكفر كما قدَّمنا. فإنْ كان قد تاب منها وأقلع عنها، وإلا فهو باقٍ في عهدتها…))[94](.
وقال القاضي عياض -رحمه الله-: (وحُجَّةُ الآخرين أنَّ قيامهم على الحجَّاج ليس لمجرد الفسق، بل لما غَيَّرَ من الشرع، وظاهَرَ الكفر، لبيعهِ الأحرار، وتفضيلِه الخليفة على النبي، وقولِه المشهور المنكر في ذلك…))[95](.
ومِن الناس مَنْ مَنَعَ الاستدلال بهذه الآثار على جواز الإنكار على الحاكم علنًا، حتى فيما لو صرَّح الحاكم بما يتضمن تحريف الدين، وتغيير الشرائع، وخصَّ هؤلاء هذه الآثار الواردة بما يكون بين الاثنين والثلاثة ونحو ذلك، لا ما يكون عامًّا، وهذا التوجيه فيه بعدٌ عند التأمل، وذلك أنَّ كلام الناس فيما بينهم في ظلم الحاكم وفسقه، سواء كان بين اثنين أو أكثر، سيؤدي إلى بغض الحاكم، والنفرة عنه، مما يُضعف هيبته وسلطانه، ويحمل الناس على التجرؤ على مخالفة أمره، وهي المفسدة التي يَذْكُرُها مَن يَمنع الإنكار على الحاكم علنًا، ومعلومٌ أنَّ هذا النوع من الكلام في الحاكم والسلطان إن جاز، فإنه سيمتد وينتشر، ولن يقف الناس فيه على حدٍّ.
أمَّا إذا حملنا هذه الآثار على إنكار المنكر فيما إذا أظهره الحاكم وأعلنه، وقد تضمَّن تغيير الشرائع، وتحريف الدين، فإنَّ الإنكار حينئذٍ يتوجه إلى المُنكَرِ نفسه، بتحذير الناس منه، والمحافظة على الشريعة من التغيير والتبديل، مع مراعاة حفظ هيبة الحاكم ومنزلته في قلوب الناس، من خلال التلطف في الإنكار، والتذكير بحقِّه ومكانته، وبهذا ينتفي المحذور، أمَّا إذا قيل بجواز غِيبة الحاكم، ووصفه بالفسوق والظلم والطغيان في مجالس الناس الخاصة، وفيما يكون بين العدد القليل، وفي أحاديثهم، فلا شكَّ أن المحذور حينئذٍ باقٍ.
وآخرون تكلَّفوا تضعيف هذه الآثار في غِيبة السلطان الفاجر، وعاملوها معاملة الأحاديث النبوية، فأعملوا فيها قواعد النقد كما لو كانت من أحاديث الأحكام المرفوعة -على تكلِّفٍ ظاهرٍ أيضًا في إعمالهم لهذه القواعد في نقدها- وهو خلاف طريقة العلماء في الحكم على هذا النوع من الآثار. بل، حتى لو أعملنا قواعد نقد الأحاديث المرفوعة على هذه الآثار، وأحاديث الأحكام منها خاصة، لاندرجت قطعًا في الآثار الحسنة باعتبار كثرة الشواهد. بل لو سلَّمنا جدلًا وقلنا بضعفها كلِّها، وحَكَمْنا بعدم تقويةِ بعضها بعضًا، لكان إيرادُ أهل العلم لها من غير نكير ولا إبطالٍ علامةً على صحةِ معناها في الجملة، وقَبولهم لما دلَّت عليه.
وعلى كلِّ حال، فإنَّ الأحاديث والآثار ظاهرةٌ ومتضافرةٌ في وجوب إنكار منكر الولاة وغيرهم إذا تضمَّن المُنكَرُ تحريفًا للدين، وتغييرًا للشرائع والسنن، ونصوصُ العلماء وأفعالُهم في هذا الباب كثيرة.
قال ابنُ القيِّمِ-رحمه الله ـ: (ما قاله عبادةُ بنُ الصَّامِتِ وغيرُه: بايعنا رسولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم على أن نقولَ بالحقِّ حيث كُنَّا، ولا نخافَ في اللهِ لومةَ لائمٍ ونحن نشهدُ بالله أنَّهم وَفَّوْا بهذه البَيعةِ، وقالوا بالحقِّ، وصَدعوا به، ولم تأخذهم في اللهِ لومةُ لائمٍ، ولم يكتموا شيئًا منه مخافةَ سوطٍ ولا عصًا ولا أميرٍ ولا والٍ كما هو معلومٌ لِمَن تأمَّلَهُ مِنْ هديهِم وسيرتِهم، فقد أنكر أبو سعيدٍ على مروانَ وهو أميرٌ على المَدينةِ، وأنكر عُبادةُ بنُ الصَّامِتِ على معاويةَ وهو خليفَةٌ، وأنكر ابنُ عمرَ على الحَجَّاج مع سَطوتِهِ وبأسِهِ، وأنكرَ على عمرٍو بنِ سعيدٍ وهو أميرٌ على المَدينةِ، وهذا كثيرٌ جِدًّا مِن إنكارِهم على الأمراءِ والولاةِ إذا خرجوا عن العَدلِ لم يخافوا سَوْطَهُم ولا عقوبتَهم، ومَن بعدَهم لم تكن لهم هذه المَنزلةُ، بل كانوا يتركون كثيرًا مِنَ الحقِّ خوفًا مِنْ وُلاةِ الظُّلم وأمراءِ الجَوْرِ، فمِنَ المُحالِ أن يُوفَّق هؤلاءِ للصَّوابِ ويُحرَمَهُ أصحابُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم))[96](.
والشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- له قدم صدق في هذا الباب:
فقد وجه بيانًا من الرئاسة العامة للمجلس الأعلى العالمي للمساجد حول ما دار مع العقيد معمر القذافي حول إنكاره للسنَّة النبوية كمصدر للتشريع كما تناقلتها الصحف والأنباء، يحثه فيها على إعلان التوبة والتبرُّؤ مما نُسب إليه من إنكاره للسنَّة:
قال فيه: (فالواجب على فخامة العقيد أن يعلن في وسائل الإعلام تكذيبه لما زعمته هذه الإيطالية، وأنه يبرأ إلى الله من ذلك إن كان ذلك لم يقع منه، فإن كان قد وقع منه فالواجب عليه إعلان التوبة النصوح من ذلك، ومن تاب تاب الله عليه …))[97](.
كما شارك الشيخ رحمه الله في بيانات عدة تستنكر ما افتراه الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، منها:
بيان المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بتاريخ ١١/١٢/١٤٠٠هـ، الموافق ٢٠/٢٠/١٩٨٠م.
ومنها: بيان من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
ومنها: بيان من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بتاريخ ١١/٥/١٤٠٢هـ)[98](.
وكان الشيخ -رحمه الله- يُمثِّل أحيانًا بالقذافي في محاضراته عند الحديث على مُنْكِرِي السنَّة، كما في المجلد الخامس صفحة ١٨٧ من فتاواه.
كما أنّه كتب ردَّا على رئيس تونس السابق الحبيب بو رقيبة بشأن ما نُسب إليه من كلام يتضمن الطعن في القرآن والسنَّة، وبعض الخرافات المتعلقة بالرسول ×، وطلب في خطابه من الدول الإسلامية مقاطعة تونس، جاء فيه: (لأنَّ ما نُسب إليه مِنْ أَنْكَرِ المنكرات التي يجب إِنكارُها على مَن وَقَعَتْ منه – حسب القدرة -. ولا شك أنَّ قَطْعَ العلاقات معه مِن إنكار المنكر المستطاع))[99](.
والشيخ ابن باز -رحمه الله- قد ردَّ على القذافي بحسب ما نُقل عنه في الصحف، لا بما سمعه منه، فكيف لو كان الحاكم قد نطق بهذا الباطل علنًا، وصرَّح به جهارًا؟ وهذا يدل على وجوب صيانة الشريعة وحماية حوزة الدين.
ونصوصُ العلماء التي تؤكّد مشروعية الإنكار علنًا على الحاكم فيما إذا صدر منه علنًا تحريفٌ للدين، وتغييرٌ للسنن والشرائع كثيرة:
فقد سُئِل ابن باز -رحمه الله-: ما ضابط الإنكار مِنْ حيث الإسرارِ والجهرِ به، وإذا لم يُجْدِ الإسرارُ فهل يُجهَرُ بالإنكار؟ وهل هنالك فرقٌ بين الحاكم والمحكوم في هذه المسألة؟ وكيف نوجِّه قصَّةَ أبي سعيدٍ الخُدريِّ ÷ مع الخليفة في تقديم الخُطبة على الصلاة، وقصَّةَ سلمان مع عمر رضي الله عنهما في قصَّةِ القميص، وغيرَها مِنَ الوقائع؟ فأجاب-رحمه الله ـ: (الأصلُ أنَّ المُنكِر يتحرَّى ما هو الأصلحُ والأقربُ إلى النجاح، فقَدْ ينجح في مسألةٍ مع أميرٍ ولا ينجح مع الأمير الثاني، فالمسلم الناصح يتحرَّى الأمورَ التي يرجو فيها النجاح، فإذا كان جهرُه بالنصيحة في موضعٍ يفوت الأمرُ فيه، مِثل قصَّةِ أبي سعيدٍ، والرَّجلِ الذي أَنكرَ على مروانَ إخراجَ المِنبَر وتقديمَ الصلاة، فهذا لا بأسَ لأنه يفوت؛ أمَّا إذا كان الإنكار على أمورٍ واقعةٍ، ويَخشى أنه إِنْ أَنكرَ لا يُقبَل منه أو تكون العاقبةُ سيِّئةً، فيفعل ما هو الأصلحُ، فإذا كان في مكانٍ أو في بلدٍ مع أيِّ شخصٍ، ويظهر له ويرتاح إلى أنَّ الأصلحَ مُباشَرةُ الإنكار باللسان والجهرُ معه، فلْيَفعل ذلك ويتحرَّى الأصلحَ؛ لأنَّ الناس يختلفون في هذه المسائل: فإذا رأى المصلحةَ ألَّا يجهر، وأَنْ يتَّصِل به كتابةً أو مشافهةً فَعَل ذلك؛ لأنَّ هذه الأمورَ تختلف بحسَبِ أحوال الناس؛ وكذلك الشخص المُعين يحرص على السَّتر مهما أَمكنَ، ويزوره، أو يكاتبه، وإذا كان يرى مِنَ المصلحة أنه إذا جَهَر، قال: فلانٌ فَعَل كذا، ولم تنفع فيه النصيحة السرِّيَّة، ورأى مِنَ المصلحة أنه ينفع فيه هذا الشيء فيفعل الأصلحَ، فالناس يختلفون في هذا، والإنسان إذا جَهَر بالمُنكَر فليس له حرمةٌ إذا جَهَر به بين الناس، فليس لمجاهرٍ بالفسق حرمةٌ في عدم الإنكار عليه، وقد ذكروا أنَّ الغِيبة في حقِّ مَنْ أَظهرَ الفسقَ لا تكون غِيبةً إذا أَظهرَه ولم يستحِ))[100](.
والشيخ في هذا الموضع لم يُفرِّق بين الحاكم والمحكوم في هذا الباب، مع أنَّ السؤال صريحٌ في ذلك، فإنَّ السائل سأل: هل يوجد فرقٌ بين الحاكم والمحكوم في الجهر بالإنكار، ومع ذلك أحال الشيخ المسألة إلى تقدير المصالح والمفاسد.
وقال العثيمين-رحمه الله-: (كذلك-أيضًا-في مسألةِ مناصحة الوُلَاة: مِنَ الناس مَنْ يريد أَنْ يأخذ بجانبٍ مِنَ النصوص وهو إعلانُ النكير على وُلَاة الأمور مهما تَمخَّض عنه مِنَ المفاسد، ومنهم مَنْ يقول: لا يمكن أَنْ نُعلِن مُطلَقًا، والواجب أَنْ نناصح ولاةَ الأمور سِرًّا كما جاء في النصِّ الذي ذَكَره السائل، ونحن نقول: النصوص لا يكذِّب بعضُها بعضًا، ولا يصادم بعضُها بعضًا، فيكون الإنكار مُعلَنًا عند المصلحة، والمصلحة هي أَنْ يزول الشرُّ ويحلَّ الخيرُ، ويكون سرًّا إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحةَ، لا يزول به الشرُّ ولا يحلُّ به الخير))[101](.
وقال في نفس جواب السؤال-رحمه الله-: (فإذا رأينا أنَّ الإنكار علنًا يزولُ به المُنكَرُ ويحصلُ به الخيرُ فلنُنْكِرْ عَلَنًا، وإذا رأينا أنَّ الإنكارَ عَلَنًا لا يزول به الشَّرُّ، ولا يحصل به الخيرُ بل يزدادُ ضغطُ الوُلاةِ على المُنكِرينَ وأهلِ الخيرِ، فإنَّ الخيرَ أَنْ نُنكرَ سِرًّا، وبهذا تجتمعُ الأدلَّة، فتكونُ الأدلَّةُ الدَّالَّةُ على أنَّ الإنكارَ يكون علنًا: فيما إذا كُنَّا نتوقَّعُ فيه المَصلحةَ، وهي حصولُ الخيرِ وزوالُ الشَّرِّ، والنُّصوصُ الدَّالَّةُ على أنَّ الإنكارَ يكونُ سِرًّا: فيما إذا كان إعلانُ الإنكارِ يزدادُ به الشَّرُّ ولا يحصلُ به الخيرُ))[102](.
وقال الألباني -رحمه الله-: (إذا خالف الحاكم الشريعة علنًا، فالإنكار عليه علنًا لا مخالفة للشرع في ذلك))[103](.
وقال الشيخ عبد المحسن العباد البدر -حفظه الله- في مقال بعنوان: >حقوق ولاة الأمر المسلمين: النصحُ والدعاءُ لهم والسمعُ والطاعة بالمعروف<: (وإذا ظهرت أمورٌ منكرةٌ من مسؤولين في الدولة أو غير مسؤولين، سواء في الصحف أو في غيرها، فإنَّ الواجب إنكارُ المنكر علانية كما كان ظهوره علانية))[104](.
والشيخ عبد المحسن -حفظه الله- له مقالات في الإنكار على بعض الولاة، وما حصل في ولايتهم من المنكرات، فمنها على سبيل المثال لا الحصر:
مقال: (ليس هذا من العدل يا عادلة).
ومقال: (كارثة أخلاقية عظمى تحل بالشعب السعودي بقرار جائر من وزير التعليم).
ومقال: (بيان جناية التغريبيين على العهد السلماني والعهد الذي قبله).
ومقال: (اتباع بلاد الحرمين ملة الغربيين يرضيهم وما سواه يعجبهم ولا يكفيهم)
ومقال: (احذروا تدمير أخلاق الشعب السعودي أيها المسؤولون في الهيئة العامة للترفيه).
ومقال: (وزير الإعلام والتغريبيون يقررون إحداث دور السينما في بلاد الحرمين).
ومقال: (استنوق الجمل واسْتَدْيَكَت الدجاجة بمكر التغريبيين للبلاد السعودية).
مع أن الشيخ عبد المحسن البدر -حفظه الله- قد قَرَّرَ في مقاله المشار إليه آنفًا، وفي كتبه الأخرى أنَّ النصيحة للولاة تكون سرًّا.
فقال في مقاله: (ومن حقوق ولاة الأمر المسلمين على الرعية: النصح لهم سرًّا، وبرفق ولين، والسمع والطاعة لهم في المعروف).
وقال في >قطف الجنى الداني< وفي >الردّ على الرفاعي والبوطي<: (إنَّ النَّصيحةَ لوُلاة الأمور وغيرِهم تكون سرًّا وبرفقٍ ولينٍ… وإذا خلا النُّصحُ من الرِّفق واللِّين وكان علانيةً فإنَّه يضرُّ ولا ينفعُ، ومِن المعلوم أنَّ أيَّ إنسانٍ إذا كان عنده نقصٌ يحبُّ أن يُنصح برفقٍ ولينٍ، وأن يكون ذلك سرًّا، فعليه أن يعامل النَّاسَ بمثل ما يحبُّ أن يعاملوه به))[105](.
وهذا يؤكد التفريق بين النصيحة والإنكار على ما سَبَق الإشارة إليه.
وقال الشيخ عبد الله القعود -رحمه الله-: (أسلوب المناصحة: أنا أرى أنَّ الأمر يـختلف باختلاف الأحوال، يـختلف باختلاف وضع الحاكم وتسلّطه، ويـختلف باختلاف قوةِ الناصح ومكانتِه ومواجهتِه وتـَحَصُّنِه من الحاكم، ويختلف باختلاف الأَمْرِ الذي سينصح به، فأنا أرى إنْ كان هذا الأمر الذي سيُنصحُ به أمرٌ ظاهرٌ ومُعلَن وواضحٌ، فالمُنكَرُ المُعلَن الواضحُ الظاهر أرى أنّه لا حرج في أنْ يُناصَح الحاكم مِنْ مواجهةٍ، أو من عمودِ صحيفةٍ، أو مِن منبرٍ، أو بأيِّ أسلوبٍ من الأساليب، إذا كان المنكرُ واضحًا وواقعًا في الناس وعَلَنِيًّا، فالقاعدة ُالسّليمة أنَّ ما يُنكَرُ إذا كان عَلَنًا عولج ونُصِح به علنًا. أمّا إذا كان المنكر لم يَظْهَر، ولم يُعلَم للناس، ولا يزال في مثلِ هذه الأمور خفيًّا، فهنا لا، المفروضُ أنْ تكون المناصحةً به سرًّا. فأنا لستُ مع مَنْ يقول: انصحوا سرًّا أو فرادى، ولا مَع مَنْ يقول: لا، انصحوا علنًا وجماعة، فالكلُّ مطلوب، لكن باختلاف الأحوال))[106](.
وسُئل الشيخ صالح اللحيدان -رحمه الله- قبل أشهر قليلة من وفاته -رحمه الله- عن ضوابط الإنكار العلني على المدير أو على المسؤول أو على ولي الأمر، وضابط قوله في الحديث: >كلمة حق عند سلطان جائر<، فأجاب: (أولًا ينبغي للواحد أنْ يعرف معنى الحديث، النبي × قال: >من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان<… الإنسانُ إذا كان يمكنه أنْ يُغَيِّر المنكر بدون أن يُغضبَ وَلِيَّ الأمر، يجبُ عليه أن يسلك المسلك الذي يَحصلُ به المراد مِن دون إغضاب وِلِيِّ الأمر، لكن إذا كان وَلِيُّ الأمر ما يَقبل، فليكن الإنسان كما فعل أبو سعيد الخدري ÷… وقوله: >أما هذا فقد أدى ما عليه<، فهذا أوَّلُ شخص خالف السنّة فيما يتعلق بصلاة العيد، فالإنكارُ عليه إذا كان في مسألة يُخشى من الفوات يُنكر، فلا بد طالب العلم يُحسنُ تكييفَ إنكار المنكر… ثم ذكر الشيخ قصة ابن عمر مع الحجاج في الحج عندما قال له: إنْ أردت السنَّة فاقصر في الخطبة وأَطِل الصلاة…))[107](.
وهذه النقولات عن العلماء يُستنار بها في فهم النصوص، وهي تدلُّ على أنَّ الجهر بالإنكار على الحكام في أحوالٍ مخصوصة له أصلٌ في كلام العلماء، وأنَّ القول بجوازه في تلك الأحوال لا يُعدُّ خروجًا عن منهج السلف، ولا تنكَّبًا عن طريقة العلماء وفتاواهم.
ولقائل أن يقول: إنَّ بعض هذه النصوص أعمُّ من صورة النزاع، لكون ظاهرها يشمل كلَّ ما أعلنه الحاكم من المنكرات، وأذاعه، وصرَّح به، ولا تخصُّ موضع النزاع، ألا وهو: تصريح الحاكم بما يتضمن تحريف الدين وتغيير الشرائع.
فالجواب أن يُقال: إنْ كانت بعض النصوص أعمَّ من المطلوب، فإنَّ صورة النزاع داخلة فيها دخولًا أولويًّا، وهذا هو المطلوب، ويكون ما عداها من الصور من مسائل الاجتهاد عند من قال بها.
ومع كل هذا أقول: إنَّ الأصل في إنكار منكر الحاكم والسلطان أن يكون بدون ذكر الحاكم، لكونه أبعد في الجملة عن أسباب الفتنة والشقاق، لكنَّ هذا مشروطٌ بتحقق المقصود من الإنكار، وتحصيل المصلحة، فإن كان المقصود لا يتحقق إلا بذكر صاحب المنكر، لا سيما إن كانت مقالة الحاكم قد ذاعت وانتشرت، أو اتُّخذ بفعله قدوة وأسوة، وقد لا يتفطّن بعض الناس إلى أنَّ مقالته أو فعله هو المقصود بالإنكار، وربما أدى السكوت عن التصريح بالإنكار إلى رواج تلك المقالة، أو الفعل بين الناس، مع ما يتضمنه من تحريف الدين، وتغيير الشرائع، كان الواجب والمتعيّن دفع هذه المفسدة، باحتمال أدناها، وهي مفسدة التصريح بالإنكار على الحاكم علنًا.
وجرت عادة العلماء في مؤلفاتهم وعقائدهم، عند ذِكر حقوق الولاة، النصّ على تحريم الإنكار عليهم بالخروج والثورة بالخصوص، وكذلك كلُّ ما فيه نزعٌ ليد الطاعة، دون غيرها من الوسائل، وذلك لمجيء النصوص الصريحة بذلك.
فقد قال القاضي أبو يعلى -رحمه الله-: (فصلٌ في وجوب الإنكار على السلطان إذا غَصَبَ، وعطَّل الحدود، وضرب الأبشار، واستأثر بأموال الفيء والغنائم والأعشار، فإنه يجب وعظه، وتخويفه بالله تعالى، أما بالقتال وشَهْرِ السلاح عليه فلا يجوز ذلك))[108](.
وقال ابنُ القيّم في كتاب >إعلامُ الموقِّعين<: (إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم شرع لأمَّته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره مِن المعروف ما يحبُّه اللهُ ورسولُه، فإذا كان إنكارُ المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنَّه لا يسوغ إنكارُه، وإن كان اللهُ يُبغضُه ويمقتُ أهلَه، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنَّه أساسُ كلِّ شرٍّ وفتنةٍ إلى آخر الدهر))[109](.
وقال ابن الأزرق -رحمه الله- معدِّدًا ما لا يجوز في حقِّ السلطان: (جملة مخالفات:
المخالفة الأولى: الخروج عليه، لما سبق أنَّ الصبر عليه إذا جار من فروض الدين وأمهات واجباته…
المخالفة الثانية: الطعنُ عليه، وذلك لأمرين:
أحدها: أنَّه خلاف ما يجب له من التَجِلَّة والتعظيم، فقد قيل: من إجلال الله إجلال السلطان عادلًا كان أو جائرًا…
الثاني: أنَّ الاشتغال به سبب تسليط السلطان به جزاء على المخالفة بذلك…
المخالفة الثالثة: الافتيات عليه في التعرّض لكل ما هو مَنُوطٌ به، ومن أعظمه فسادًا تغييرُ المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان…
المخالفة الرابعة: كتمُ ما يجب أنْ يَعْلَمَ به مما فيه مصلحة…
المخالفة الخامسة: الدعاء عليه بما فيه مضرة للمسلمين…))[110](.
وهكذا كلُّ من تتَّبع كلامهم، ونظر في عقائدهم المكتوبة، ومؤلفاتهم في هذا الباب، يجد هذا ظاهرًا، فتراهم ينصُّون على حرمة الإنكار بالخروج خاصة، ويدخل فيه ضمنًا ما يؤدي إليه كالتحريض، والتشهير، والعيب، والسبِّ، والقدح، وتعداد المساوئ، والافتيات، وأمَّا المنع من إظهار الانكار على مقالةٍ باطلة تتضمن تحريف الدين، أو فعلٍ يتضمن تغيير الشرائع، وتحريم إعلانه والجهر به، فليس له ذكرٌ في كلامهم، ولا في منصوص عقائدهم، ولا في جملة تحذيراتهم وتنبيهاتهم في هذا الباب.
ويدخل في الممنوع من وسائل الإنكار: المظاهرات والتجمهرات، لكونها من الوسائل المخالفة لعمل السلف، وفيها مشابهة للكفار، كما أنها من وسائل التحريض والتأليب وشحن القلوب على الولاة، ولا يمكن ضبطها، ولذلك نصَّ عامة العلماء المعاصرين على تحريمها والمنع منها.
بناءً على ما سبق أقول: إنَّ الأصل في إنكارِ المنكر عدمُ تسمية صاحب المنكر، لا سيما إن كان صاحب ولاية، لأنَّ المقصود من الإنكار ذاتُ المُنْكَر وطلب تغييره، لا شخص صاحب المنكر، فيُنكر الربا، وتُبيَّن حرمتُه، وحرمةُ التعامل مع البنوك الربوية، أما ذِكرُ المسؤول الذي سنَّ هذا القانون الربوي أو أَمَر به، فهذا قد تكون مفسدته أكثر من مصلحته، هذا هو الأصل.
لكن قد تقتضي المصلحة الإنكارَ على صاحب الولاية علنًا، كما لو أعلنَ بالمنكر وحرَّفَ الدين ونَسَبَ إليه ما ليس منه، على نحو ما ذكرنا سابقًا، وهو خلاف الأصل، وهذا على نحو ما نقول: الأصل الرفق، لكن تجوز الشدة عند الحاجة والمصلحة.
والمصلحة العامة أو الضرورة قد تقتضي في أحوال ترك بعض الأصول في أبواب الإمامة والجماعة، دفعًا لمفسدة أكبر، ولا يُعدُّ ترك تلك الأصول في تلك الأحوال خروجًا عن الشريعة، ولهذا صور:
منها: أن الأصل وجوب إقامة الحدود، وأنَّ إقامتها منوطةٌ بالسلطان، ومع ذلك يجوز عند الحاجة والضرورة ترك إقامتها في أحوال، كحال المجاعة، أو إذا ترتب على إقامتها ضرر أكبر، كما تَرَكَ النبي × إقامة الحدِّ على عبد الله بن أُبَيْ وغيره في حادثة الإفك، دفعًا لمفسدة تَحَدُّثِ الناس أنَّ محمدًا يقتل أصحابه، فيكون في إقامة الحدِّ على بعض من استحقَّه صدًّا عن الإسلام، وتنفيرًا عنه في ذلك الوقت بالخصوص.
ومن ذلك أيضًا أنَّ إقامة الحدود قد تجوز من غير السلطان في أحوال، كما لو بَعُدَ السلطان عن بعض نواحي ولايته عند توسَّع الولاية، وضَعُفَ سلطانه ونفوذه على تلك النواحي، ولم يمكن تركُ الناس بلا رادعٍ يردعهم، فقد نصَّ العلماء في مثل هذه الحال على جواز أن يُقيم أهل تلك الناحية منهم طائفة تقيم الحدود، وتعاقب الجناة والمفسدين)[111](.
وهاتان الحالتان لا تنافيان أنَّ الأصل: وجوب إقامة الحدود، وأنَّ إقامتها منوطة بالسلطان.
ومن الصور أيضًا: أَنَّ الأصل وجوب السمع والطاعة على جميع من تحت ولاية السلطان؛ أهلِ الحلِّ والعَقْدِ وغيرِهم، ومع ذلك يجوزُ لأهل الحلِّ والعَقْدِ عزلُ الإمام بغير قتال، ولو مِنْ غير معصية، وذلك حيث تقتضي المصلحة العامة ذلك، كأنْ يتبيّن من حاله أنه ليس أهلًا للولاية، أو أنْ يطرأ عليه ما يقتضي ذلك، أو أنْ يُخشى من ضياع الدولة وتَسِلُّطِ الأعداء، إما لجبنه عن الحفاظ على مصالح الدولة والقيام بما يحقق ذلك، أو لضعفه في نفسه وعدم قدرته، أو لغير ذلك)[112](.
والعزلُ في هذه الحال لا ينافي أنَّ الأصل: السمع والطاعة.
وعلى كل حال: المنكراتُ العامة التي تعمُّ الناس، ولا تختصُّ بشخص الحاكم، يجبُ إنكارها، والتحذيرُ منها، كالقوانين والتشريعات المحرمة، وكالغناء والحفلات، وغير ذلك، وكالظلم والتعدي على الناس، وكالفساد ونهب أموال الدولة، ولا يجوز السكوت عنها، فضلًا عن البدع والمحدثات، ومقالات التشكيك في ثوابت الدين وأصوله وقواعده.
ومن المهم أنْ نَعرف أنَّ بعض هذه الأمور قد يكون مردُّها إلى الأعراف أو إلى أنظمة الحكم المعمول بها، وإلى اعتبار المصالح والمفاسد، فتكون داخلة في جملة التقديرات المبنية على العلم بالشرع وبالواقع.
وقد سُئل الشيخ العثيمين -رحمه الله- عن المعارضة في الحكومات التي فيها أحزاب، فقال: (المعارضةُ لا أدري هل تنطبق عليها وصف الخوارج أو لا، لأنَّ المعارضة حسب الحكومات الحزبية تُعتبر شرعية، ليست خروجًا، نعم لو أنهم خرجوا على الإمام بالسلاح، صحيح ربما نقول إنهم خوارج، فإنْ قاتلوا فهم بغاة فيجب أن نساعد الإمام فيهم، وهم مسلمون… كما قلتُ لك: المعارضةُ مِهِي بْخِروج بَيِّن، لأنَّ حزب المعارضة في الحكومات التي فيها أحزاب تعتبر شرعية، له أن يُثبت نفسه ويعارض))[113](.
فالشيخ -رحمه الله- راعى في حُكمِه على هذه المسألة الأعرافَ وأنظمة الحُكم، وهذ يُؤكد على أنَّ بعض المسائل المتعلّقة بالسياسة الشرعية لا بد فيها من مراعاة البلدان والأنظمة والأعراف والأزمان، ما لم يوجد في المسألة نصٌّ صريح أو إجماع.
وبعض هذه المسائل، ونحوها من مسائل السياسة الشرعية، كما أنَّها تختلف باختلاف الأزمان والبلدان، فإنَّها تختلف أيضًا باختلاف صلاحِ الحاكم من فساده، وانتشارِ السنَّة من عدمها، ووجودِ العلماء من عدمه، وقوةِ الحق من ضعفه، ومن جهة النظر إلى القرائن والأمارات، ومن تلمح العواقب والآثار.
فالموقفُ من المنكرات، وطرقُ التصدِّي لها تختلف باختلاف الأحوال، فقد يُرفق في وقت، ويُشدد في آخر، وقد يُسرُّ في وقت، ويُجهر في آخر.
فمتى كانت السنّةُ ظاهرةً، والبدعةُ مقموعةً، وأهلُ الولاية فيهم صلاحٌ واستقامة، والعلماء متوافرون، ولهم نفوذٌ وكلمة مسموعةٌ ومكانة، فالتعامل مع منكرات الحاكم أو المنكرات العامة، يكون على نحو ألطف وأرفق وألين، لأنَّ الحال تقتضي ذلك.
أما إذا انتشرت البدعة، وذاع صيت أهلها، وارتفعت أصواتُهم، وقلَّ الصلاح في أهل الولاية، وكثر الشرُّ فيهم، وقلَّ العلماء، وأطلت الفتن برأسها، وجب التصدِّي للمنكرات العامة، ولم يَجُزْ التساهل فيها، لأنَّ ترك ذلك يُؤذن بشرٍّ أكبر، لكن مع مراعاة الضوابط الشرعية، والموازنة بين المصالح والمفاسد، وحفظِ هيبة السلطان ومكانته، والتماس الرفق واللين والتلطّف في مخاطبته وموعظته.
وأما تخصيصُ الإنكار على الحاكم في حَضْرَتِه، فهذا هو الأصل، وهو أقرب إلى القبول وأبعدُ عن الرياء وإثارة الناس، لكنَّ هذا قد يكون متعذرًا أحيانًا، أو قد لا يتحقق به المقصود، كما لو قال الحاكم مقالةً باطلةً في الدين قد انتشرت وذاعت، وكان لا بد من بيان الحق الواجب فيها لئلا يظهر الباطل ويختفي الحق.
وينبغي التنبيه على أمر قد يُشكل على بعض الناس، فإنَّ بعض الخائضين في هذه المسائل قد أطلق لسانه في الكلام والوقيعة في بعض أعيان حكام المسلمين الآخرين، نقدًا وعيبًا وتشنيعًا، على اعتبار عدم دخول الناقد تحت ولايتهم، ومنهم من كتب في تقرير ذلك وتسويغه، وهو خطأٌ كبير، وانحراف خطير، وقد سبق أنْ نَبَّهتُ عليه في مقالة سابقة منشورة في موقعي في الشبكة العنكبوتية، بيَّنتُ فيه أنَّ الجائز مِن ذلك: هو الردُّ على مقالة باطلة في الدين صدرت من ذلك الحاكم، أو نُقلت عنه في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام، فهذه هي التي ينبغي ردُّها وإبطالها وإنكارها، ولا مانع من تسمية قائلها حينئذٍ إن اقتضت المصلحة ذلك، حاكمًا كان أو مسؤولًا حسب ما أشرنا إليه، كردود الشيخ ابن باز على مقالات بعض الحكام، فلا بد من التفريق بين الصورتين، وقد قلتُ نصًّا: (ولا يُعرف عن عالمٍ من علماء أهل السنّة والجماعة تجويز ذلك -أي: نقد الحكام المسلمين الآخرين على اعتبار عدم دخولنا في ولايتهم-، لا مطلقاً ولا مقيداً، لا من السابقين ولا من اللاحقين، على أنه قد ينتصب الواحد منهم للردّ على الخطأ في مسألة شرعية جاءت على لسان أو مقال إمام أو حاكم مسلم، انتصاراً للدين والشرع، لا قصدًا للعيب والذم والقدح، كما قد جرى من الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- غير مرة).
من خلال تتبّعِ ما كُتب وأُلَّف في هذا الموضوع بالخصوص، وتأمّلِ ما يُذكر ويُقال ويُورد خلال النقاشات العلمية، وفي الحوارات التي تجري بين أوساط الدعاة، وما يجري في وسائل التواصل من التجاذب، يُدرك الناظر أنَّ ثمَّة تساؤلات، واعتراضات يُعارَضُ بها ما تم تقريرُه وتفصيلُ الحكم فيه فيما سبق من الفصول، فكان لا بد من الإجابة عليها، وحلِّ إشكالها، إذ لا يسلم الاستدلال بالدليل حتى يُجاب عن المعارض، وهو ما تفتقده كثيرٌ من النقاشات والحوارات في هذا الموضوع، حيث ترى بعضهم يقرِّر أمرًا، ويختار قولًا، ويسردُ فيه الدلائل، لكنّه لا يُجيب عن دليلِ المُعارِض، ولا يَحلُّ ما أورده من إشكالات واعتراضات.
وسأورد أهم الاعتراضات والإيرادات التي قد تُورَدُ على القول الذي اخترتُهُ وأدَّاني إليه اجتهادي، وهو موضوع المبحث الأول.
ثم أذكر بعض التنبيهات المهمة التي تتضمن مزيدًا من إيضاح الحقِّ، وتقرِّب الصورة أكثر، كما أنَّها تشتمل على إيرادات قوية على المعارضين، وهو ما موضوع المبحث الثاني.
يُقال: قد جاءت أحاديث تدلُّ على تخصيص الإنكار على الحاكم في مجلسه دون غَيْبته، مثل أحاديث: >أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر<، وحديث: >ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله<.
فيُقال جوابًا على هذا الاعتراض: إنَّ هذين الحديثين يُعدّان من أحاديث الفضائل، وهذه الصورة المذكورة في الحديثين، وهي القيام بالإنكار بين يدي الحاكم، لم تُذكر على سبيل التقييد، أو على سبيل بيان الطريقة المشروعة، بل ذُكرت لبيان الفضيلة في هذه الصورة وهذا الموقف الشجاع، وهي صورةٌ تعبّر عن أبلغِ صور الشجاعة والإقدام والجهاد في سبيل الله وفي سبيل الدعوة، إذ من المعلوم أنَّ الإنكار على السلطان بحضرته لا يقوى عليه كل أحد، فإنَّ السلطان قد تأخذه العزة بالإثم، وهذه العزَّة قد تحمله على البطش بمن أنكر عليه، وهذا لا شك في احتمالِه وكثرةِ وقوعه، وحوادث التاريخ في هذا كثيرة جدًّا، وهذا بخلاف ما لو كان الإنكار في غيبة الحاكم، وبعيدًا عن يده، فإن هذا قد يتجرأ عليه كثيرون.
فقد يقوى على قول الحقِّ كثيرون في غَيْبَةِ السلطان، لكن يعجزون عن مواجهته به.
وبهذا اختصَّ الإمام أحمد عن أكثر أهل زمانه، ولذلك لم يَقْوَ على إنكار مقولة الخليفة الباطلة في القرآن والصفات أحدٌ ممن طُلب منه إلا أعلامٌ قليلون على رأسهم الإمام أحمد -رحمه الله-.
وقد قال الإمام أحمد -رحمه الله- عمَّن حُملوا إلى المأمون فأجابوا: (هؤلاء لو كانوا صبروا وقاموا لله لكان الأمر قد انقطع، وحَذِرَهُم الرَّجُل -يعني المأمون- ولكن لما أجابوا وهم عَيْنُ البلد اجترأ على غيرهم. وكان أبو عبد الله إذا ذَكَرَهم اغْتَمَّ لذلك ويقول: هم أوَّلُ مَنْ ثَلَمَ هذه الثُّلمة وأفسد هذا الأمر))[114](.
ولذلك قال الخطابي -رحمه الله-: (إنما صار ذلك أفضل الجهاد؛ لأنَّ مَنْ جاهد العدو وكان متردِّدًا بين رجاءٍ وخوفٍ لا يدري هل يَغلِب أو يُغلَب، وصاحب السلطان مقهورٌ في يده، فهو إذا قال الحقَّ وأَمَرَه بالمعروف فقد تعرَّضَ للتلف، وأهدفَ نفسه للهلاك، فصار ذلك أفضلَ أنواع الجهاد، من أجل غَلَبَةِ الخوف، والله أعلم))[115](.
وقال العز بن عبد السلام -رحمه الله-: (جَعَلَها أفضل الجهاد لأنَّ قائلها قد جاد بنفسه كلَّ الجود، بخلاف مَنْ يُلاقي قَرْنَه من القتال، فإنه يجوز أنْ يقهرَه ويقتلَه، فلا يكون بَذْلُهُ نفسه مع تجويز سلامتها، كبذلِ المُنْكِر نفسَه مع يأسه من السلامة))[116](.
وهكذا كلُّ من شَرَح هذين الحديثين من المتقدّمين يذكر هذا المعنى، ولو أفضنا في نقل كلامهم لطال بنا البحث.
وأمَّا ذِكرُ هذين الحديثين في أبواب الإمامة من كتب الأحاديث والسنَّة وغيرها، فلم يكن المقصودُ منه تخصيصَ الإنكار على الحاكم بما يكون بين يديه فقط، وإفادةَ هذا الحُكم، ولذلك لم يُبوِّب أحدٌ ممَّن خرَّج هذين الحديثين أو أحدهما بمثل هذا المعنى، وإنما قُصد به بيان هذه الفضيلة المختصة بهذا الباب بالخصوص.
يقول قائل: إنَّ الإنكارات الواردة عن السلف على الحكام كانت كلُّها في حضرتهم، لا في غَيْبَتهم
وقد يُستدلُّ لهذا الاعتراض بقول الشيخ العثيمين -رحمه الله-: (وهناك فرق بين أنْ يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أنْ تتكلم عليه بين يديك وبين أن يكون غائبًا؛ لأنَّ جميع الإنكارات الواردة عن السلف إنكاراتٌ حاصلةٌ بَيْن يَدَيْ الأمير أو الحاكم. وهناك فرق بين كون الأمير حاضرًا أو غائبًا. الفرق أنه إذا كان حاضرًا أمكنه أنْ يدافع عن نفسه، ويُبيِّنَ وجهة نظره، وقد يكون مصيبًا ونحن مخطئون، لكن إذا كان غائبًا وبَدَأْنا نحن نُفَصِّلُ الثوب عليه على ما نريد، هذا هو الذي فيه الخطورة، والذي ورد عن السلف كله في مقابلة الأمير أو الحاكم، ومعلوم أنَّ الإنسان لو وَقَفَ يتكلمُ في شخص من الناس وليس من ولاة الأمور وذَكَرَه في غَيْبَتِه، فسوف يقال: هذه غِيبة، إذا كان فيك خير فصارِحْه وقابله))[117](.
ومثله قول الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-: (وأهلُ العلم فَرَّقوا في هذا المقام – بما سبق بيانه- بين النصيحة فيما يقع في الولاية، وبين ما يكون منكرًا يفعله السلطان بحضرة الناس، وقد ورد كثير من الآثار والأحاديث أَنْكَرَ فيها الصحابة وأنكَر فيها التابعون على ذوي السلطان علنًا، وكلُّها بدون استثناء يكون فيها أن المُنكَر فُعل بحضرتهم، ورأوه أو سمعوه سماعًا محقّقًا))[118](.
أنَّ هذا غير مُسلّم به، بل قد ثبت عن بعض السلف الإنكار في غَيْبَة الحاكم، كما ثبت عن عبادة ÷ في إنكاره على معاوية ÷، حيث كان إنكاره في غَيْبة معاوية ÷، ولم يكن بحَضْرته.
قال الشيخ محمد فركوس -حفظه الله- عن إنكار عبادة على معاوية رضي الله عنهما: (ولم يَكن بحضرتهِ بل في غَيْبَته، وقد فَهِم الناسُ أنَّ المُرادَ به حكمُ المعاملةِ المأمورِ بها مِنْ قِبَلِ معاوية رضي الله عنه، فرَدَّ الناسُ ما أخَذُوا، ولذلك عرَّض معاويةُ بحديثه لمَّا بَلَغه مشكِّكًا فيه، بناءً على أنه لم يسمعه مِنَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مع أنه صَحِبه وكان كاتبًا له، ثمَّ أعاد عُبادةُ رضي الله عنه القصَّةَ وذَكَره تصريحًا، ثمَّ قال: >لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ ـ أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ ـ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ<))[119](.
ومثله إنكار عمارة بن رؤيبة ÷ على بِشْر بن مروان رَفْعَ اليدين على المنبر، وقوله: >قبح الله تلك اليدين< فإنما قاله عمارة لِمَنْ بجانبه، ولم يكن كلامًا موجَّهًا لبِشْرِ بن مروان، حيث كان بِشْر يخطبُ وقتها على المنبر، وهذا الإنكارٌ لم يكن عن مواجهة مع الوالي، بل مَعَ بُعْدِه عنه وعدم سماعه له، فهو بذلك في حُكم الإنكار عليه في غَيْبَته.
وهكذا إنكارُ أبي سعيد الخدري على معاوية رضي الله عنهما في زكاة الفِطر، كان في غَيْبة معاوية ÷.
ومثله يقال في إنكار عائشة رضي الله عنها على مروان بن الحكم، وإنكار أخيها عبد الرحمن على معاوية ÷، وإقرارها له.
ويُقال مثله في كثير مما ورد عن السلف من الإنكار على الحجَّاج، وذمّ أفعاله، إنما كان في غَيْبَتِه، لا في حضرته.
إنَّ هذه الحوادث المذكورة إنما هي وقائع أعيان، ووقائع الأعيان لا تدل على التخصيص من هذا الجهة، فكونُ الحوادث المأثورة عن السلف في الإنكار على بعض الولاة -إن سلمنا جدلًا- أنها كانت في حَضْرَتِهم، لم يصح الاستدلال بها على تخصيص الإنكار في مجلس السلطان، دون غَيْبَتِه، ما لم يَرِدْ دليلٌ خاصٌّ يدلُّ على ذلك، كأن يَرِدَ نصٌّ في المنع من الإنكار على الحاكم في غَيْبَتِه، أو أن يُعلِّلَ السلفُ الحُكْمَ بذلك، ونحو ذلك من الدلائل، وعلى هذا فليس من المناسب اعتبار تلك الوقائع تخصيصًا للحكم في نفسه، أو تقييداً له، بل غايتها الدلالة على جواز الإنكار على الحاكم في حضرته، ويبقى الإنكار عليه في غَيْبَتِه مسكوتًا عنه.
فإن قال قائل: قد جاء النصُّ بتخصيص الإنكار في حضرته، وهو حديث: >من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبْدِه علانية< الحديث، فالجواب أن يُقال: إنَّ هذا الحديث إنما هو في النصيحة، على ما سبق بيانه من التفريق بين النصيحة والإنكار، وليس في الإنكار.
إنَّ تخصيص الإنكار بين يدي الحاكم، قد جاء في كلام بعض مَن يُستدلُّ بكلامه من العلماء في هذه المسألة، أنَّ العلة فيه أنَّ الحاكم قد يُبدي عذرًا صحيحًا فيه.
فقد قال العثيمين -رحمه الله- معلِّلًا: (وهناك فَرْقٌ بين كون الأمير حاضرًا أو غائبًا. الفَرْقُ أنه إذا كان حاضرًا أمكنه أن يدافع عن نفسه، ويُبّيِّن وجهة نظره، وقد يكون مصيبًا ونحن مخطئون، لكن إذا كان غائبًا وبدأنا نحن نُفَصِّلُ الثوب عليه على ما نريد، هذا هو الذي فيه الخطورة).
وكلام الشيخ ظاهرٌ في أنَّ العلة عنده في تخصيص الإنكار بين يدي الحاكم، هو ما قد يحتمله قوله أو فعله من التأويل، فمفهوم كلامه أنَّ ما لا يحتمل التأويل من أفعال الحاكم وأقواله المنكرة لا يختصُّ بأن يكون بين يديه.
قد ذَكَر بعض من يخصُّ الإنكار على الحاكم في مجلسه أنَّ العِلّة فيه: فَوْتُ المصلحة من الإنكار، وذلك أنَّ الحاكم قد يقول قولًا منكراً أو يفعل أمرًا منكرًا، ثم يَخْرُجُ من المجلس بعضُ مَن سمعه من الحاكم أو رآه قبل إنكار المُنكِر، فيظنُّه حقًّا، فتفوتُ مصلحة الإنكار، أو قد يأمر الحاكم بمنكرٍ تفوتُ المصلحة بتأخيرٍ إنكاره، كما لو أَمَرَ بِقَتلِ مَنْ لا يجوز قتلُه، فقالوا: يتعيّن حينئذٍ الإنكار قبل خروج من شهده لئلا يثبت الباطل ويُعدمَ الحق، وقالوا: وهكذا في كلِّ منكر تفوت المصلحة بتأخير إنكاره.
واستدلُّوا بما روى المرُّوذي في >أخبار الشيوخ وأخلاقهم< عن الأوزاعي، أنه قال: (مَنْ حَضَرَ سلطانًا، فأَمَر بأمرٍ ليس بحقٍّ، ولا يَتَخَوَّفُ فيه الفَوْتَ، فلا يكلمه فيه عند تلك الحال، وليَخْلُ به، وإذا رأيته يأمرُ بِأَمْرٍ يخاف فيه الفَوْتَ، فلابد لك من كلامه، أصابك منه ما أصابك))[120](.
على أنَّ أثر الأوزاعي هذا إنما هو فيما إذا أَمَرَ السلطان بالمُنكَر وقتها، وفي ذلك المجلس بالخصوص، لا فيما صرَّح به الحاكم من المنكر المتضمّن تحريف الدين وقد أعلنه وأظهره، حتى ذاع واشتهر، فتأمَّل.
ومما يستشهدون به في هذا الصدد قول الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: (فالمسلم الناصح يتحرَّى الأمورَ التي يرجو فيها النجاح، فإذا كان جهرُه بالنصيحة في موضعٍ يفوت الأمرُ فيه، مِثل قصَّةِ أبي سعيدٍ، والرَّجلِ الذي أَنكرَ على مروانَ إخراجَ المِنبَر وتقديمَ الصلاة، فهذا لا بأسَ لأنه يَفُوت؛ أمَّا إذا كان الإنكار على أمورٍ واقعةٍ، ويخشى أنه إِنْ أَنكرَ لا يُقبَل منه أو تكون العاقبةُ سيِّئةً، فيفعل ما هو الأصلحُ))[121](.
قلت: وهذا المعنى الذي جعله أصحاب هذا القول علَّةً في تخصيص الإنكار بين يدي الحاكم فقط، وهو خوف الفَوْت، هو بعينه موجودٌ فيما إذا قال الحاكم المُنكَرُ علنًا أو فعله علنًا، فسمعه منه الناس أو رأوه، كما لو أظهره في وسائل الإعلام ونحوها، فإنَّ تَرْكَ الإنكار عليه علنًا حينها، يَفُوت به الحقّ، وتضيع به المصلحة.
فالفَرق بين الصورتين هو: أنَّ المجلس الذي أعلن فيه الحاكم المنكر المتضمّن لتحريف الدين، كما لو أعلنه في وسائل الإعلام ونحوها، هو أكبر وأوسع من المجلس الخاص الذي قيَّدوا به الحُكم، فالعلّة هي العلَّة، مع التباين في حجم المجلسين، فالذي أوجب الإنكارَ بين يَدَي الحاكم قبل خروجِ مَنْ بمجلسه مِنَ السامعين، هو نفسه الموجِبُ للإنكار على الحاكم علنًا لئلا يعتقد الناس صحةَّ الباطل الذي قاله، أو جواز الفعل الذي فعله مما يخالف السنّن والشرائع.
ومعلومٌ أنَّ الإنكار عليه سرًّا في مجلسه، مع كونه قد أعلن بالمنكر، لا يتحقق به المقصود، فيَفُوت به بيان الحق، وردُّ الباطل.
فإن قال قائل: يُمكن الإنكار عليه علنًا تعريضًا لا تصريحًا، بذِكْرِ المقالة أو الفعل، دون تعيين الحاكم.
فالجواب أن يُقال: إن تحققت المصلحة به فلا يُصار إلى غيره، وهذا هو الأصل، لكنَّ الغالب أنَّ الإعلام يحتفي بكلام الحاكم وفِعاله، لا سيما إنْ كان الحاكمُ مقبولًا عند الناس، ومحبوبًا، أو كان معظّمًا وقدوةً ورمزًا لكثير من الناس، وهذا يُسهم في ذيوع المنكر وقبوله وانتشاره، لا سيما أنَّ أهل الباطل والفساد يفرحون بهذا التحريف الصادر من الحاكم، فتراهم ينشرونه، ويُذيعونه، ويستدلون به على باطلهم، كما هو واقع الحال، وقد لا يَلْقَى الإنكارُ إذا خلا عن تعيينِ الحاكم مثلَ صَدَى المُنْكَر، وقد لا يَفْطِنُ إليه الناس، فلا يحصلُ به المقصود من صيانة الشريعة وحفظ دين الناس، فلا بد أنْ يكون الإنكارُ بقدر قوة المُنكَر، فاذا وقع الإنكارُ على منكر الحاكم علنًا، تصريحًا لا تلميحًا، لَفَتَ الانتباه، واسترعى الأسماع، فيبلغ الحقُّ ما بلغه الباطل، ويقطع الطريق على أهل الفساد والباطل.
ومع ذلك لا بد من التلطف في العبارة، وحفظِ هيبة السلطان، بتذكير الناس بحقَّه، وتعداد فضائله وسجاياه، ليكون أدعى إلى قبول الإنكار، ولئلا يَتَّخِذَ ضعاف النفوس الإنكار سببًا في التهييج والإثارة.
قد يُقال: إنَّ في إعلان الإنكار تهييجًا على الحاكم وتأليبًا وتحريضًا عليه
إنَّ التحريض والتأليب إنما هو في التشهيرِ بالحاكم، وتعدادِ مساوئه، والقدحِ في شخصه، وذمِّه وعيبه، وسبِّه، وأما ردُّ المنكر الذي وقع منه، وإبطال المقالة التي تضمّنت تحريفَ الدين وتغييرَ الشرائع، مع حفظ مكانته، وتعظيم حقّه، وصَوْنِ هيبته وسلطانه، فليس من التحريض في شيء، بل هي مِن بيان الحق ونُصْحِ الخلق.
وهذا هو صنيع الصحابة ~ فيما سبق ذِكره من الآثار عنهم، وهو صنيعُ مَنْ سمَّينا مِنَ السَّلف، فإنَّهم أنكروا المنكر على الوالي، وأعلنوا بذلك وجهروا، ولم يكن في إنكارهم تحريضٌ ولا تأليبٌ ولا تهييجٌ.
ويقال أيضًا:
إنه بإظهار الحاكم للمنكر، وإعلانِه به، والتصريحِ به بين الملأ، وتحريفِه للدين، وتغييرِه للشرائع والسنن، يكون هو الذي قد حرَّض على نفسه، وسلّط سهام النقد عليه، وليس من ردَّ عليه خطأه، وبَيَّن الصواب، ونَصَحَ للخلق، وهذه هي الفتنة التي تتغيَّر بها الشرائع، وتنحرف بها السنن. فإنَّ المنكر إذا كان ظاهرًا مُعلنًا، يَجْهَرُ به الحاكم، ويراه الناس منه، أو يسمعونه، لا سيما إنْ كان يُكرِّرُ إِتيانه له، وربما يفتخر به، أو يفتنُ الناس به، ويُكْرِهُهُم عليه مع بُغض الناس لهذا المنكر، وكراهيتهم لفعله، فإنه موجبٌ لنُفرة الناس عنه، وبُغضه له، وهو ما يفتح باب الفتنة، حتى يعجز العقلاء عن درئها إذا استفحل الأمر. والناس إذا لم يَرَوْا من العلماء القيامَ بما أوجب الله عليهم مِن إنكار المنكر وبيانِ الحقِّ بالطريقة الشرعية، وتحذير النّاس من الباطل، سقطت مكانتهم ومنزلتهم عند الناس، وربما وقعوا فيهم واتهموهم بالباطل، فيَعظُم بذلك الشر، ويعمُّ الفساد. فلا بد من اعتبار المصالح والمفاسد، والنظر في عواقب الأمور.
إنَّ عامة الآثار التي يَستدلُّ بها من يُخصِّصُ الإنكار بين يدي الحاكم، كأثر أسامة بن زيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وجواب ابن عباس رضي الله عنه لمن سأله: هل يأمر أميره بالمعروف، فقال: (إن خشيت أن يقتلك فلا، فإنْ كنت ولا بد فاعلًا ففيما بينك وبينه)، ونَهْيِ أبي بكرة على من قال عن أميره: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، ونحوها من الآثار، هي خارجة عن محل النزاع، ولا تدلُّ على المطلوب، إذ ليس فيها إنكارُ مقالةٍ صدرت على لسان الحاكم تضمَّنَت تحريفًا للدين، أو إنكار فعلٍ من أفعاله تضمَّن تغيير السنن والشرائع، بل بعضُها وَقَعَ فيما هو محتمل، وبعضُها فيما هو من قَبِيل مسائل الاجتهاد، وبعضُها بالنظر إلى مصلحة الآمر نفسه.
فأثر أسامة مع عثمان رضي الله عنهما، لا يدلُّ على المطلوب، لأنَّ عثمان ÷ لم يفعل منكرًا يُوجبُ الإنكار عليه، بل غاية ما نَقِمَه الناقمون عليه أمور محتملة، تُعدُّ من قبيل مسائل الاجتهاد في الولاية، ومع ذلك فهو فيها بارٌّ ÷، وهذه سبيلها النصيحة، لا الإنكار.
وقد علَّل ابن حجر -رحمه الله- فعلَ أسامة في ذلك بأنه كان تبعًا للمصلحة التي رآها ÷، حيث قال في شرح الحديث: (قوله >قد كلمته ما دون أن أفتح بابا< أي: كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السرِّ، بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها))[122](.
وأما أثرُ ابن عباس ÷، الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وقد سأله رجل: آمر أميري بالمعروف؟ قال: (إن خفت أن يقتلك فلا تؤنب الإمام، فإنْ كنت لا بد فاعًلا ففيما بينك وبينه).
فظاهرٌ أنَّ المنع منه إنما كان لمصلحة الآمر، لا لكون ذلك سنّة وشريعة على كل حال.
ومثله قول طاووس: ذُكرت الأمراء عند ابن عباس ÷، فانبرى فيهم رجل، فَتَطاوَلَ حتى ما أَرَى في البيت أطول منه، فسمعتُ ابن عباس ÷ يقول: (لا تَجْعَل نفسَك فتنةً للقوم الظالمين)، فَتَقاصَرَ حتى ما أرى في البيت أقصر منه)[123](.
فمراد ابن عباس ÷: ألا يتعرَّضَ الإنسان للأمراء، فيعذبونه أو يقتلونه، فيكون فتنةً لهم، كما في قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}، وقد روى نعيم بن حماد في >الفتن< عن مجاهد في تفسيرها أنه قال: (لا تسلِّطْهم علينا، حتى يفتنونا، فَيَفْتَتنوا بنا))[124](.
فالآثار الواردة عن ابن عباس ÷ في هذا إنما كان بالنظر إلى مصلحة الآمر، وحفظًا له من انتقام السلطان، لا على وجه بيان الطريقة الشرعية في الإنكار.
وهكذا عامة الآثار، إذا تأملتها وجدتها خارجة عن محل النزاع، إذ فيها: النهيُ عن السبِّ، والعيب، والقدح، واللعن، والإهانة، ونحو ذلك.
فمنها قول أنس ÷: (كان الأكابر من أصحاب النبي × ينهوننا عن سبِّ الأمراء))[125](.
وقول أبي مجلز: (سبُّ الإمام هي الحالقة))[126](.
وقول ابن عباس ÷ لرجل دخل عليه، فسبَّ الحجَّاج: (لا تكن عونًا للشيطان))[127](.
وقول أبي الدرداء ÷، وقد ذُكر الأمراء عنده: (لا تلعنوهم، فإنَّ لعنهم الحالقة، وبغضهم الفاقرة))[128](.
وما رواه أبو بكرة ÷ عن النبي × من قوله: (من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله))[129](.
وكلُّ هذه الأمور المنهي عنها في هذه الآثار خارجةٌ عن محل النزاع.
إنَّ إيجاب إسرار الإنكار على الحاكم مطلقًا، وتحريمَ الإنكار عليه علنًا في غير مجلسه، حتى مع العجز عن الوصول إليه، ولو حرَّف الدين، ونَسَبَ إليه ما ليس منه، وغيَّر الشرائع، وبدَّل السنن، مع قطع النظر عن اعتبار المصالح والمفاسد، وتقدير الأحوال والوقائع، قولٌ قد خَلَتْ عَن ذِكْرِه كتبُ السنَّة والآثار، الصحاح منها والسنن والمسانيد، وكتب العقائد، وكتب السياسة الشرعية، على اختلافها وتنوّعها، باستثناء ما سيأتي ذكره من النصيحة، ومعلومٌ أنَّه لو كان هذا أصلًا من أصول أهل السنَّة والجماعة، بحيث يتميّزون به عن أهل البدعة والفرقة، لما خلا عن ذِكْرِه، والتنبيه عليه، والإشارة إليه، كتابٌ من كتب المعتقد، فضلًا عن جميعها، ولما أهمله المحققون، كابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم، على كثرة كلامهم في هذه المسائل، وتنوع رسائلهم.
بل الثابتُ عنهم في مؤلفاتهم وكتبهم المختصّة والعامَّة: النهيُ عن الإنكار بالخروج والسيف، والنهيُ عن اللعن والسبِّ والطعن والعيب لما يترتب عليه من إيغار الصدور، وشحن القلوب، وإيقاد الفتن، وضياع الأمن، وضعف هيبة السلطان.
فقد روى ابن أبي شيبة أنه قيل لحذيفة بن اليمان ÷: ألا تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر؟ قال: إنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لَحَسَن، ولكن ليس من السنَّة أنْ ترفع سلاحك على إمامك)[130](.
كما قال الإمام أحمد -رحمه الله-: (ومَنْ خَرَجَ على إمام المسلمين، وقد كان الناس اجتمعوا عليه، وأقرُّوا له بالخلافة، بأيِّ وجه كان، بالرِّضَى أو بالغلبة، فقد شقَّ هذا الخارج عصا المسلمين، وخالفَ الآثار عن رسول الله ×، فإنْ مات الخارج عليه، مات ميتة جاهلية. ولا يحلُّ قتال السلطان، ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس، فمَنْ فَعَلَ ذلك فهو مبتدع على غَيْرِ السنَّة والطريق))[131](.
وقال الطحاوي -رحمه الله-: (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإنْ جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدًا من طاعتهم))[132](.
وقال البربهاري -رحمه الله-: (ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولم يَرَ الخروج على السلطان بالسيف، ودَعَا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره))[133](.
وقال القاضي أبو يعلى -رحمه الله-: (فصلٌ في وجوب الإنكار على السلطان إذا غَصَبَ، وعطَّل الحدود، وضَرَبَ الأبْشار، واستأثر بأموال الفيء والغنائم والأعشار، فإنه يجب وعظه، وتخويفه بالله تعالى، أما بالقتال وشَهْرِ السلاح عليه فلا يجوز ذلك))[134](.
وقال ابنُ القيّم في كتابه >إعلامُ الموقِّعين<: (إنَّ النَّبيَّ × شرع لأمَّته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره مِن المعروف ما يحبُّه اللهُ ورسولُه، فإذا كان إنكارُ المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنَّه لا يسوغ إنكارُه، وإن كان اللهُ يُبغضُه ويمقتُ أهلَه، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنَّه أساسُ كلِّ شرٍّ وفتنةٍ إلى آخر الدهر))[135](.
فهذه نماذج من نصوصهم في هذا الباب، ولو تتبَّعنا نصوصهم لطال بنا المقام.
وهكذا ترى العلماء ينصُّون في عقائدهم على ما يجب على الرعية للحاكم، وما لا يجوز لهم في معاملته، فيذكرون تحريم نزع اليد من طاعة، وتحريم الخروج بالسيف، ونحو ذلك، ولا نجد أحدًا منهم يذكر وجوب إسرار الإنكار في كل الأحوال.
وفيما رواه مسلم من قوله ×: >ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عَرَفَ بَرِئ، ومَن أنكر سَلِم، ولكنْ مَن رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا<، ما يؤكد هذا المعنى، فإنَّ الصحابة رضي الله عنهم، فهموا من الحديث وجوب الإنكار على ولاة الجور والفسق، فسألوا عن حكم الإنكار عليهم بالقتال، فردَّه عليهم × بقوله: >لا، ما صلوا<.
ولا يقول قائل، قد روى ابن أبي عاصم في >السنَّة<، وهو من كتب العقائد، حديث عياض بن غنم ÷ المرفوع: >من أراد أنْ ينصح لذي سلطان< الحديث، وذلك أنَّ الحديث خارج عن محل النزاع، إذ هو في النصيحة لا الإنكار، على أننا لو تنزّلنا وقلنا إنه يشمل الإنكار، لحُمل على المنكر القاصر، لا المتعدِّي، ولو تنزَّلنا أيضًا وقلنا: إنه يعمُّ المتعدِّي، لحُمل على المنكرات العامة على ما أشرنا إليه، دون تحريف الدين وتغيير الشرائع والسنن.
على أنَّ ثبوت هذا الحديث بالخصوص ليس محلَّ اتفاقٍ، بل قد اختلف فيه المحدِّثون، منهم من يُثبته، ومنهم من يُضعِّفه، لكنَّ الراجح ثبوته، وأنَّه حسنٌ لغيره بمتابعاته وشواهده، لكنَّ المقصد هو: أنَّ مثل هذا الحديث المختلف في ثبوته، لا يُمكن أن يُعتبرَ أصلًا من أصول السنَّة والجماعة، يُضلَّل به مَن خالف، فإنَّ أصول السنَّة والجماعة في أبواب الاعتقاد دلائِلُها أكثر من أن تُحصر في حديث أو حديثين صحيحين فضلًا عن المختلف فيها، بل تجد النصوص فيها تتضافر، وتتتابع فيها الآثار، فضلًا عن ثبوت الإجماع.
هذا مع التسليم جدلًا أنَّ الحديث يعمُّ الإنكار، وإلا فإنَّ الحديث إنما هو في النصيحة خاصّةً، وليس في الإنكار.
بل حتى النصيحة للحاكم، قد ذَكر بعض العلماء أنَّ الإسرار بها للحاكم، دون وَعْظِه أمام الناس والحاضرين، إنما جاء الأمر به على سبيل الترغيب والحثِّ، لا على سبيل الإلزام، لا سيّما إن اقتضت المصلحة خلافه.
قال ابن داود الحنبلي-رحمه الله-: (وإن وَعَظَ السلطان سرًّا، فيما بينه وبينه فهو الأحسن))[136](.
وقال ابن الجوزي -رحمه الله-: (الذي أراه في هذا الزمان الإنكار على الملوك سرًّا بالكلام اللطيف، لا بالقهر والتعنيف، لأنَّ المقصود إزالة المنكر الذي قُصد إزالته))[137](.
وظاهر هذا، أنَّ الإسرار بالنصيحة للحاكم أو الجهر بها في محضر الناس، مردُّه إلى المصلحة، وبالنظر إلى ما يُحقِّق المقصود من إزالة المنكر، وأنَّه يختلف باختلاف الأعصار والأزمان والأحوال.
وقد سُئل الشيخ العثيمين -رحمه الله- السؤال التالي: (فضيلة الشيخ، إذا سمَحَ وليُّ الأمر أن ينتقده الناس علنًا، ويُحاسبوه علنًا، وربّما يفتخر وليُّ الأمر نفسُه بذلك تطبيقًا للحرية الديمقراطية، هل يجوز لنا استعمال هذه الوسائل، ولو كانت غير شرعية، بحجَّة أنَّ وليَّ الأمر سَمَح به؟)
فأجاب -رحمه الله- بقوله: (الذي أرى أنْ لا يَفْعَلْ، لأنَّ سماح وليِّ الأمر بذلك مجرَّد مظهر أمام الدول الغربية الكافرة. لأنَّ هذا الطريق ليس معروفًا في سلف الأمّة أبدًا))[138](.
قلتُ: ومع كون صورة المسألة المعروضة في السؤال هي: انتقاد الحاكم علنًا، ومحاسبته علنًا، واتخاذ ذلك طريقةً ومنهجًا في التقويم والنقد، فقد كان جواب الشيخ -رحمه الله- بقوله: (الذي أرى أنْ لا يفعل)، وهو ظاهر في أنَّ جوابه إنما هو اجتهادٌ ورأيٌ واختيار، وليس حُكمًا جازمًا، أو أصلًا من أصول أهل السنَّة والجماعة المحكمة، مع أنَّ الأقرب والأظهر هو اندراج صورة المسألة في أصول أهل السنَّة والجماعة في باب الإمامة، لأنَّ اتخاذ نقد الحاكم علنًا وسيلة مشروعة للناس مطلقًا على نحو ما ذُكِر في السؤال يُخالف النصوص وعمل السلف في هذا الباب مخالفة ظاهرة، ومع ذلك كان جواب الشيخ على هذا النحو، فكيف هو الحال إذًا في مسألتنا مدار البحث، وهي فيما إذا حرَّف الحاكم الدين، وغيَّر الشرائع والسنن، بلسانه أو مقاله، فلا شكَّ أنَّ الإنكار عليه علنًا، مع حفظ مكانته وهيبته وسلطانه، صيانة للدين من التحريف، وحماية للشريعة، من غير أن يُتّخذ ذلك طريقة متَّبعة في النقد والتقويم على نحو ما جاء في السؤال، أولى بالاجتهاد والرأي والتقدير.
الإنكار على الحاكم علنًا، فيما وقع منه من تحريفٍ للدين، وتغييرٍ للشرائع والسنن، يُحرصُ فيه على أن لا يكون بأسلوبٍ يتضمَّن تهييجًا، أو إثارةً، أو تأليبًا، وعلى أن لا يَفتح باب فتنة على الناس، وذلك بأن يقترن الإنكار بالتذكير بحقِّ الحاكم بما يحفظ مكانته، ويُعظِّم سلطانه، ويحفظ هيبته عند الرعية، وأن يشتمل على الثناء عليه بما هو أهله، فهو أقرب لإيصال الحقِّ، ودرء الفتنة. وقد يقتضي الحال التنبيه على تحريم الخروج، ونزع اليد من طاعة.
وهذا ما فعله عبادة ÷، حيث أنكر ما خالف الشريعة على معاوية ÷، ثم غادر لئلا تقع فتنة، ويكثر القيل والقال.
فعبادة ÷ قد التزم بما رواه في ذلك، وعَمِل به، وهو حديثه: >بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لائم<.
فعمل ÷ بالأمرين:
الأول: القول بالحقِّ أينما كان، وألا يخاف في الله لومة لائم.
والثاني: الالتزام بالسمع والطاعة، وألا ينازع الأمر أهله.
ومثله ما نُقل عن الحسن البصري -رحمه الله- من ذمِّ الحجاج، ومع ذلك، لم يخرج عليه، بل أمر الناس بالصبر، ونهاهم عن الخروج عن الطاعة.
وقد ثبت عنه أنه قال: (إنَّ الحجَّاج عقوبة سلطه الله تعالى عليكم، فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف، ولكن استقبلوها بالدعاء والتضرع))[139](.
وإذا تعيَّن الردُّ والإنكار على نحو ما ذكرنا، يختار الرادُّ والمُنكر على الحاكم، ألطف العبارات، وأرفقها، وأحسنها، لئلا يَنْفِرَ الحاكم ويستكبر، ولئلا يتجرأ السفهاء على حاكمهم.
قال ابن داود الحنبلي -رحمه الله-: (قال جماعة من العلماء: ويحرم الإنكار على السلطان بغير ذلك من تخشين القول، كيا ظالم، أو يا من لا يخاف الله، وما يجري مجراه، إن كان يُحرِّكُ فتنة يتعدى شرُّها إلى غيره، ذكره القاضي أبو يعلى، وأبو الفرج ابن الجوزي، فإنه قال: الجائزُ مِن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلطان التعريفُ والوعظ، فأما تخشين القول، نحو: يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يُحرِّكُ فتنة يتعدى شرُّها إلى الغير لم يَجُز، وإن لم يَخَفْ إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. قال: والذي أراه: المنع من ذلك، لأنَّ المقصود إزالة المنكر، وحَمْلُ السلطان بالانبساط عليه على فعلِ المنكر، أكثرُ مِن المُنْكَر الذي قَصَدَ إزالته انتهى))[140](.
وموقف الإمام أحمد من فتنة القول بخلق القرآن، ومن الخليفة، مع هيجان الناس وغضبهم، مثالٌ ظاهرٌ في إمكانية الجمع بين حقِّ الله بإنكار المنكر، وحقِّ المسلمين بلزوم جماعتهم وتحذيرهم من الباطل، وحقِّ الإمام بالسمع والطاعة، وعدم نزع اليد من طاعة، على ما سبق بيانه وتوضيحه.
قد يوجد لبعض العلماء، لا سيما المعاصرين، بعض الإطلاقات التي يستدل بها بعض من يمنع من إنكار منكر الحاكم علنًا مطلقًا، وقد يكون بعضها أشبه بالصريح، وهي عند التحقيق لا تدلُّ على المطلوب، لعدة أمور:
الأمر الأول: أنَّ كثيرًا من هؤلاء العلماء قد ثبت عنهم تعليقُ إسرار الإنكار على الحاكم وإعلانه بالمصلحة، كما ثبت ذلك عن الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين -رحمهما الله-، وقد سبق نقل كلامهما في ذلك، مما يوجب حمل كلامهم الآخر على هذا التقدير.
الأمر الثاني: لا بد من النظر في أفعال العلماء، والاستعانة بها في فَهم كلامهم، ومعرفة مقاصدهم ومرادهم، فالشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- قد سبق الإشارة إلى ردَّه على القذافي وبو رقيبة صراحة، وهما من حكام المسلمين، وكان ردُّه عليهما على مقالة باطلة صدرت على لسانهم، تضمنت تحريفًا للدين، فيُحملُ كلام الشيخ في إسرار الإنكار -على التنزل بذلك- على غير هذه الصورة، بل على المنكرات الخاصة والعامة التي لا تتضمّن تحريف الدين، وتغيير الشرائع والسنن، والتي هي خارجة عن محل النزاع.
ومن ذلك أيضًا ما ثبت مِنْ فِعْلِ الشيخ عبد المحسن العباد البدر-حفظه الله-، وإعلانِه بالإنكار في عدة مقالات منشورة، مع نصِّه على وجوب إسرار النصيحة للحاكم في كتبه ومقالاته، على نحو ما أشرنا إليه ونقلناه.
ومن ذلك أيضًا كلام الألباني -رحمه الله- حيث قال: (إذا خالف الحاكم الشريعة علنًا، فالإنكار عليه علنًا لا مخالفة للشرع في ذلك))[141](.
وقد قال أيضًا معلِّقًا على قول أسامة ÷: (دون أن أفتتح أمرًا لا أحبُّ أن أكون أول من فتحه): (يعني: المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأنَّ في الإنكار جهارًا ما يُخشى عاقبتُه، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارًا، إذ نشأ عنه قتله))[142](.
قلت: وكلامه الأخير محمولٌ على المنكرات التي لا تتضمن تغييرًا للسنن والشرائع، وتحريفًا للدين، بل ما يكون مِن قبيل المعاصي ونحوها، جمعًا بين الموضعين.
يؤكده فتياه -رحمه الله- المشهورة في عدم جواز ما قامت به الحكومة السعودية من استجلاب القوات الأجنبية في حرب الخليج، عند الغزو العراقي للكويت، وتصريحه بذلك، وهو نوعٌ من الإنكار العلني على حكومة إسلامية، وقد جاء فيها: (لم تقتصر -أي: السعودية- على الاستعانة بالدّول العربية، وإنما استعانت بالدول الصليبية الكافرة… أما واقعنا اليوم، فأولا: المصلحة غير متحققة، وثانيًا: المفسدة متجسمة متحققة، وأكبر دليل ما بدأت النُّذُر تُنذر بشرٍّ مستطير، من جهة انتشار الفساد، وانكشاف النساء بالعورات في كثير من البلاد السعودية التي احتلها الأمريكان…) ثم أطال في الجواب)[143](.
الأمر الثالث: أنَّ كلام العلماء المُستدل به -إن تنزلنا وقولنا بصحة الاستدلال به على موضع النزاع- قد يُحمل على ما يناسب الواقع الذي قيل فيه، وأنَّ الإطلاق الذي يُدَّعى في كلام بعض العلماء، إنما خرج في ذلك الوقت من باب السياسة الشرعية لدرء مفسدة، وصدِّ فتنة، يؤكده أنَّ كثيرًا من الكلام المنقول عنهم والمستدلُّ به، قد قيل في حقبة الغزو العراقي للكويت وما بعده، وكلُّ من عاش تلك الحقبة، يعلم عِظَم الهجمة التي تعرَّض لها الملوك والرؤساء، تشويهًا، وسبًّا، وقدحًا، ونقدًا، فقد استغل بعض دعاة الفتنة وقتها استقدام القوات الأجنبية في حرب الخليج، فأخذوا يثيرون الفتن، ويُعلنون النكير في المحافل العامة، وفي أوساط الشباب، حتى وقع كثير منهم في الطعن في العلماء، فضلًا عن الأمراء، وصدرت وقتها عدة بيانات ونشرات تتضمن القدح والعيب، خرجت في قالب النصح والتذكير.
لا سيما أنَّ المسائل التي كان يدندن حولها هؤلاء الدعاة، لم تكن من قبيل المنكرات الظاهرة المحققة، بل من قبيل الاجتهادات، ومن المسائل المنوطة بولاة الأمور لا بعامة الناس، فكان من الحكمة إغلاق هذا الباب، لئلا يلج منه أهل الفتنة، ويستغلوه في نشر باطلهم، وتهييج العامة والغوغاء.
وكما يُنقل عن بعض العلماء قوله: (إذا كنا عند الرعية صِرْنا مع السلطان، وإذا كنَّا عند السلطان صِرْنا مع الرعية).
الأمر الرابع: أنَّ عامة ما يُنقل من كلام العلماء ويُستَدلُّ به، هو خارج عن محل النزاع، كقول الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: (ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذِكرُ ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل: فيُنكر الزنا، ويُنكر الخمر، ويُنكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب؛ لعموم الأدلة. ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكمًا ولا غير حاكم).
فكلامه إنما هو في التشهير بعيوب الولاة على المنابر وفي المحافل العامة، وفي المنكرات العامة التي لا تتضمن تصريحًا من الحاكم في تحريف الدين، وتغيير الشرائع.
فهو بهذا الاعتبار خارج عن محل النزاع.
ومن ذلك أيضًا: النقول التي تُنقل عن بعض المتقدمين والمتأخرين في إسرار النصيحة، كلُّها خارجة عن محل النزاع، إذ النصيحة لا تكون إلا سرًّا كما جاءت بذلك النصوص والآثار على ما بيّنا من الفرق بين النصيحة والإنكار.
ومن ذلك أيضًا ما يُنقل عن بعض أئمة الدعوة، كقولهم: (وأما ما قد يقع من ولاة الأمور، من المعاصي والمخالفات، التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها: مناصحتهم على الوجه الشرعي، برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح، من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد؛ وهذا غلط فاحش، وجهل ظاهر، لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه، من المفاسد العظام في الدين والدنيا))[144](.
فكلامهم في هذا الموضع إنما هو في التشنيع على الحاكم، وذمِّه وعيبه ونحو ذلك.
وهكذا إذا تتبع المنصف أكثر عباراتهم وجدها خارجة عن محل النزاع، كأن تكون في النصيحة، أو التشهير والعيب والقدح، أو في تعداد المساوئ، أو في مواضع الاجتهاد، أو في المنكرات الخاصة، أو العامة التي لا تتضمّن تحريف الدين وتغيير الشرائع والسنن.
الأمر الخامس: أنه على التنزل باعتبار بعض نصوص العلماء -لا سيما المعاصرين منهم- صريحة في موضع النزاع، فإنها على أقل تقدير تُقابَل بنصوص علماء آخرين صريحة أيضًا في جواز إعلان الإنكار عند المصلحة، وقد نقلنا بعض هذه النصوص فيما سبق.
وفي الختام أقول تلخيصًا لما سبق
إنَّ المنكر الصادر من السلطان أو في ولايته أنواع على سبيل الإجمال:
النوع الأول: أن يكون صادرًا في ولايته، لا منه مباشرة، كما يكون في مؤسسات الدولة وهيئاتها.
النوع الثاني: أن يكون صادرًا من الحاكم نفسه، مقتصرًا عليه، وهو من قبيل الذنوب والمعاصي، كشرب الخمر، والقمار ونحو ذلك.
النوع الثالث: أن يكون صادرًا من الحاكم نفسه، لكنّه عامٌ، كأن يأمر بمحرم، كما لو سنَّ قانونًا ربويًّا، أو أذِن بشرب الخمر وبيعه، أو نهى عن واجب، كما لو منع من إعلان الأذان مطلقًا، أو في بعض الصلوات كالفجر.
النوع الرابع: أن يكون صادرًا من الحاكم، ويتضمّن تحريف الدين، وتغيير الشرائع، كما لو أحلَّ حرامًا، أو حرّم حلالًا، أو دعا إلى بدعة وضلالة.
فأما النوع الأول والثالث فالأَوْلَى فيه النصيحة والتذكير والوعظ، ويكون ذلك فيما بين الناصح والحاكم، وأما المنكر فيُنكر على وجه عام، دون أن يُعيَّن الحاكم، كإنكار الشيخ ابن باز -رحمه الله- الربا مع مناصحة الحكام فيما بينه وبينهم، هذا هو الأصل، وقد ذهب بعض العلماء إلى مشروعية التصريح بالإنكار في غَيْبَةِ الحاكم في النوع الثالث إذا اقتضت المصلحة ذلك.
وأما النوع الثاني ففيه النصيحة والتذكير والوعظ، إذا لم يشهده الناصح، فإن شهده ورآه في حضرة الحاكم وجب فيه الإنكار حسب القدرة.
وأما النوع الرابع فيجوز فيه الإنكار على الحاكم علنًا، كما فعله الشيخ ابن باز -رحمه الله- مع القذافي وبو رقيبة، صيانةً للدين من التحريف والتبديل والتغيير، ونصحًا للعباد، مع التلطف في الإنكار، وحفظ هيبة ومكانة الحاكم، وإنزاله قدره ومنزلته.
وأقلُّ ما يُقال في النوعين الثالث والرابع، أنهما من مسائل الاجتهاد، لا من مسائل الإجماع والنصِّ.
هذا ما أحببت بيانه والمشاركة به إثراءً لهذا الموضوع، وإسهامًا في بحث المسألة.
فإن أصبتُ فمن الله وحده، وإن أخطأت فمنّي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، ورحم الله امرءً أهدى إليَّ عيوبي، وأوقفني على زلاتي وعثراتي.
والله أعلم، وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
([2]) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم (١٥٣٣٣)، وابن أبي عاصم في >السنَّة< ٢/٥٢١، وقال الألباني: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
([4]) البخاري برقم (١٣٣٦)، ومسلم برقم (٥٧)
([6]) مسند أحمد برقم (١٦٧٣٨)، وصححه الألباني في >السلسلة الصحيحة< برقم (٤٠٤)
([7]) >جامع العلوم والحكم< 1/218
([9]) >جامع العلوم والحكم< ١/٢٢٢
([10]) >جامع العلوم والحكم< ١/٢٢٥
([13]) >إعلام الموقّعين عن ربِّ العالمين< ٥/٢٤٣
([15]) >التيسير بشرح الجامع الصغير< ٢/٥٧
([16]) >المفهم لما أشكل من صحيح مسلم< ٤/٦٣
([17]) >شرح سنن أبي داود< شريط ٢٥٥
([18]) رواه ابن أبي شيبة برقم (٤٠٥٤٤) والطبراني في الكبير برقم (١٠٩٧٣) ، وفيه ضعف، وقد صححه في الجامع الصغير
([19]) >فتاوى اللجنة الدائمة ٢/٣١٥
([22]) >التوضيح لشرح الجامع الصحيح< ١٩/١٨١
([23]) >شرح رياض الصالحين< ٢/٤٣٥
([24]) رواه أبو يعلى في مسنده برقم (٧٣٨٢) والطبراني في الكبير برقم (٩٢٥)، وصححه الألباني كما في >السلسلة الصحيحة< برقم (١٧٩٠)
([25]) >التنوير شرح الجامع الصغير< ٦/٣٩٠
([26]) رواه أحمد في مسنده برقم (١١٠١٧)، وصححه الألباني كما في >السلسلة الصحيحة< برقم (١٦٨)
([27]) البخاري برقم (٢٣١٠) ومسلم برقم (٢٥٨٠)
([29]) >الإحكام في أصول الأحكام< ١/١٤٧
([32]) رواه البخاري برقم (٦٧٧٤) ومسلم برقم (١٧٠٩)
([33]) رواه البيهقي في >الكبرى< برقم (٣٤٢) ١/٢١٧
([39]) قال المحقق شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات.
([40]) قال المحقق شعيب الأرنؤوط: إسناد صحيح، وهو في >طبقات ابن سعد< ٤/١٨٤
([41]) >سير أعلام النبلاء< ٣/٢٣٠
([43]) >الطبقات الكبرى< ٤/١٥٩، وذكره الذهبي في >تاريخ الإسلام< ٢/١٠٧١، وفيه بلفظ: >نقنق ما شئت من نقنقة<
([44]) >صحيح البخاري< برقم (٤٠٨٤)
([45]) >صحيح البخاري< برقم (٤٨٢٧)
([46]) >المستدرك على الصحيحين< برقم (٨٤٨٣)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقال الذهبي في >التلخيص<: فيه انقطاع. وانظر >السلسلة الصحيحة< للألباني حديث (٣٢٤٠)
([47]) صحيح البخاري برقم (١٥٧٤)، وصحيح مسلم برقم (٦٩٥)
([48]) سنن أبي داود برقم (١٩٦٠)
([51]) >شرح الأربعين النووية< ح٣٤
([53]) منشور في موقع الشيخ في الشبكة العنكبوتية بتاريخ ٩/٧/١٤٣٣هـ
([54]) >الفرق بين النصيحة والتعيير< من >مجموع رسائل الحافظ ابن رجب< ٢/٤٠٣-٤٠٨
([56]) >الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر< ٩٩
([57]) >الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر< ٧٧
([69]) برقم (٩٠)، وقال الهيثمي في >مجمع الزوائد<: (فيه مجاعة بن الزبير العتكي، وثقه أحمد، وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات).
([71]) رواه البيهقي في الشعب ١٢/٣٠
([72]) أخرجه ابن زنجويه في كتاب >الأموال< ١/٧٧
([73]) رواه ابن أبي عاصم في >السنة< ٢/٤٥٥
([75]) >مجموع فتاوى ابن باز< ٨/٢١٠
([76]) >لقاء الباب المفتوح< ٦٢/١٣
([77]) >المفهم في شرح مسلم< ١/٢٣٢
([81]) أوَّل من دعا إلى القول بخلق القرآن من الخلفاء العباسيين: المأمون، وقد جرت مناظرة بين يديه بين عبد العزيز بن يحيى الكناني وبشر بن غياث المريسي، وهي التي دوَّن الكناني أحداثها في كتابه >الحيدة<، ومع ظهور حجَّة الكناني في تلك المناظرة وتأثر المأمون بها، لكن لقوة الشبهة في قلب المأمون، وإحاطة بشرٍ وأصحابه به، عاد المأمون إلى فتنة الناس وامتحانهم بالقول بخلق القرآن بعد ذلك بمدة، فأجاب عامَّة من عُرض عليه، إلا الإمام أحمد ومحمد بن نوح، إلا إنَّ المأمون توّفي قبل أن يُعرض عليه الإمام أحمد، وكان قد استدعاه وأمر بحمله إليه. ثم جاء المعتصم، واحتفَّ به ابن أبي دؤاد وأصحابه، فدعا إلى ما دعا إليه والده المأمون من الفتنة، وهو الخليفة الذي عُرض عليه الإمام أحمد -رحمه الله- ووقف بين يديه، فناظر وصبر.
([82]) >الآداب الشرعية< لابن مفلح ١/١٧٥
([85]) >الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر< ٧٣
([88]) >شرح الكرماني على البخاري< ٢/٦٩
([89]) >ذم الكلام وأهله< ٤/٢١٧
([90]) >البيان والتحصيل< ١٧/٥٧٥
([91]) انظر >شرح أصول اعتقاد أهل السنّة< للالكائي ٥/١٠٦٥ وما بعدها
([92]) >إكمال تهذيب الكمال< ٥/٢٩٦، >وفيات الأعيان< ٢/٣٧٤، >شذرات الذهب في أخبار من ذهب< ١/٣٨٣ وفيه بلفظ (اللهم أَعِن على فاسق ثقيف).
([94]) >البداية والنهاية< ٩/١٣٢
([95]) >إكمال المُعلم بفوائد مسلم< ٦/٢٤٧
([97]) >مجموع فتاوى ابن باز< ٧/٣٩٤
([98]) رابطة العالم الإسلامي، الردّ الشافي على مفتريات القذافي، مكة المكرمة، ١٤٠٢هـ.
([99]) >حكم الإسلام فيمن زعم ان القرآن متناقض< ص٤٥
([100]) >دروس للشيخ عبد العزيز بن باز< (٩/ ١٧)
([101]) >لقاء الباب المفتوح< (٦٢/ ١٠)
([102]) >لقاء الباب المفتوح< ٦٢/١٠
([103]) شريط صوتي منشور في اليوتيوب بعنوان >الألباني وجوب الإنكار على الحاكم علنا هو منهج السنة<
([104]) منشور في موقع الشيخ في الشبكة العنكبوتية بتاريخ ٩/٧/١٤٣٣هـ
([105]) >قطف الجنى الداني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني< ص١٧٢، >الرد على الرفاعي والبوطي< ص٢٢
([106]) شريط >وصايا للدعاة<، الجزء الثاني
([107]) جواب مصور بعنوان: >ضابط الإنكار العلني على ولاة الأمر وضابط قول النبي × كلمة حق عند سلطان جائر< موقع اليوتيوب
([108]) >الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر< ٥٩
([110]) >بدائع السلك في طبائع الملك< ٢/٥١٥
([111]) انظر >غياث الأمم< للجويني ٣٨٦، >مجموع الفتاوى< ٢٤/١٧٦
([112]) انظر >الأحكام السلطانية< للماوردي وأبي يعلى
([113]) التعليق على كتاب الجهاد والسير والإمارة من صحيح مسلم، شريط ١١، ومنشور بعنوان >المعارضة شرعية في الحكومات التي فيها أحزاب<
([116]) >قواعد الأحكام في مصالح الأنام< ١/١١١
([117]) >لقاء الباب المفتوح< ٢٦/١٣
([119]) >تفنيد شبهات المعترضين على فتوى الإنكار العلني بضوابطه على ولاة الأمور<
([121]) >دروس للشيخ عبد العزيز بن باز< (٩/ ١٧)
([123]) رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٢٧١٣)
([126]) >الأموال< لابن زنجويه ١/٧٧
([127]) رواه البخاري في >التاريخ الكبير< ٨/١٠٤
([128]) >الأموال< لابن زنجويه ١/٧٧
([129]) رواه أحمد في مسند برقم (٢٠٤٩٥) والبيهقي في >السنن الكبرى< برقم (١٦٧٣٧)
([131]) >شرح أصول الاعتقاد< للالكائي ٢٨١
([132]) >شرح الطحاوية< لابن أبي العز ص٣٧١
([134]) >الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر< ٥٩
([136]) >الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر< ٢٠٩
([137]) >الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر< ٢١٢
([138]) مقطع صوتي بعنوان >لا يجوز نقد الحاكم علنًا، وإن أذن بذلك< من موقع >النهج الواضح< في الشبكة العنكبوتية
([139]) >تاريخ ابن عساكر< ١٢/١٧٧
([140]) >الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر< ٢٠٩
([141]) شريط صوتي منشور في اليوتيوب