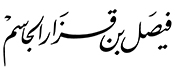الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،
فقد رغّب النبي – صلى الله عليه وسلم – في التغنّي بالقرآن وتحسين الصوت به في أحاديث كثيرة، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه -، قال: قال رسول اللَّه – صلى الله عليه وسلم -:((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ)) قال البخاري: وزاد غيره: ((يَجْهَرُ بِهِ)). وعنه – رضي الله عنه -، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ، مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ)) متفق عليه. وعن فضالة بن عبيد – رضي الله عنه -، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لَلَّهُ أَشَدُّ أَذَنًا إِلَى الرَّجُلِ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ، مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ)) رواه أحمد وغيره. وعن البراء بن عازب – رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ)) رواه أبو داود وغيره.
والتغني المأمور به هو تحسين الصوت بالقرآن والترجيع به في قول عامة أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالتغني هو الاستغناء بالقرآن والاستكفاء به كما ذهب إليه ابن عيينة، وقيل غير ذلك، والمشهور الأول.
قال الطبري: (والمعروف في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع). [شرح البخاري لابن بطال 10/261].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وتفسيره عند الأكثرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما هو تحسين الصوت به). [جامع المسائل لابن تيمية 3/304]
وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث لفظ «الترنم» من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – مرفوعاً: (( مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِرَجُلٍ حَسَنِ التَّرَنُّمِ بِالْقُرْآنِ)) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (2/482) وابن عدي في «الكامل» (6/261). والحديث حسنه الألباني في صفة الصلاة (ص127) ثم تراجع عنه في ضعيف الترغيب والترهيب تحت حديث رقم (875)، وفي الضعيفة رقم (6640).
وقد اختلف أهل العلم في قراءة القرآن بالألحان بناءاً على هذه الأحاديث وغيرها، ما بين مجيز ومانع، والمسألة مشهورة معروفة، بسط ابن القيم القول فيها في «زاد المعاد»، وقبله ابن بطال في شرح البخاري، وغيرهما، مع ذكر أدلة الفريقين.
وبيّن ابن القيم صورة المسألة المختلف فيها، وجمع بين أقوال العلماء وأوضح اتفاق السلف جميعاً على منع القراءة بألحان الموسيقى وأهل الغناء والفسق والمجون، والتي تُعرف اليوم بالمقامات الموسيقية، وبيّن خطأ من أدخل هذه الصورة في قول من أجاز القراءة بالألحان.
قال ابن القيم بعد أن بسط المسألة والأدلة: (وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين:
أحدهما: ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى الأشعري للنبي – صلى الله عليه وسلم – «لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً» والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع، وكلف لا متكلف، فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستعملونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع، وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها.
الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها، وأنكروا على من قرأ بها، وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعاً أنهم برآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرءوا بها ويسوغوها، ويعلم قطعاً أنهم كانوا يقرءون بالتحزين والتطريب، ويحسنون أصواتهم بالقرآن، ويقرءونه بشجى تارة، وبطرب تارة، وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له). [1/470]
كما نقل اتفاق السلف على منع القراءة بألحان الموسيقى وأهل المجون أبو عبيد القاسم بن سلام قرين الإمام أحمد وغيره من الأئمة كما نقله ابن رجب حيث قال:(قراءة القرآن بالألحان بأصوات الغناء وأوزانه وإيقاعاته على طريقة أصحاب الموسيقى، فرخص فيه بعض المتقدمين إذا قصد به الاستعانة على إيصال معاني القرآن إلى القلوب للتحزين والتشويق والتخويف والترقيق، وأنكر ذلك أكثر العلماء، ومنهم من حكاه إجماعاً، ولم يُثبت فيه نزاعاً؛ منهم أبو عبيد وغيره من الأئمة.
وفي الحقيقة هذه الألحان المبتدعة المطربة تهيّج الطباع، وتلهي عن تدبر ما يحصل له من الاستماع حتى يصير الالتذاذ بمجرد سماع النغمات الموزونة والأصوات المطربة، وذلك يمنع المقصود من تدبر معاني القرآن، وإنما وردت السنّة بتحسين الصوت بالقرآن لا بقراءة الألحان، وبينهما بون بعيد). [نزهة الأسماع ص70]
وقوله: (رخص فيه بعض المتقدمين) لا يدل على ثبوت ذلك عنهم نصاً، ولعله حُكي عنهم، أو فسره بعض من تأخر بذلك، وإلا فإنه لا يوجد نص صريح عن أحد من المتقدمين بجواز قراءة القرآن بألحان أهل الغناء والموسيقى، ويدل عليه ما حكاه أبو عبيد وغيره من الإجماع ونفي الخلاف، وقد سبق النقل عن ابن القيم ما يؤكد هذا المعنى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له جميل حول السماع الصوفي بألحان الغناء: (وهذا القرآن الذي هو كلام الله وقد ندب النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى تحسين الصوت به، وقال ((زينوا القرآن بأصواتكم))، وقال لأبي موسى ((لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك)) فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيراً. وكان عمر يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون، وقال النبي – صلى الله عليه وسلم – ((ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به))، وقال ((لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته))، ومع هذا فلا يسوغ أن يُقرأ القرآن بألحان الغناء، ولا أن يُقرن به من الألحان ما يُقرن بالغناء من الآلات وغيرها، لا عند من يقول بإباحة ذلك، ولا عند من يحرمه، بل المسلمون متفقون على الإنكار لأن يُقرن بتحسين الصوت بالقرآن الآلات المطربة بالفم كالمزامير، وباليد كالغرابيل.
فلو قال قائل: النبي – صلى الله عليه وسلم – قد قرأ القرآن، وقد استقرأه من ابن مسعود، وقد استمع لقراءة أبي موسى، وقال ((لقد أوتى مزماراً من مزامير داود)) فإذا قال قائل: إذا جاز ذلك بغير هذه الألحان، فلا يتغير الحكم بأن يُسمع بالألحان، كان هذا منكراً من القول وزوراً باتفاق الناس). [الاستقامة 1/241]
وقد نص ابن خلدون في مقدمته على أن الألحان الموسيقية خارجة عن محل النزاع في القراءة بالألحان قطعاً، وأنه لا خلاف في تحريم القراءة بها، وبيّن امتناع اجتماع القرآن مع الألحان الموسيقية.
فقال: (وقد أنكر مالك – رحمه الله تعالى -القراءة بالتلحين وأجازها الشافعي رضي الله – تعالى -عنه، وليس المراد تلحين الموسيقى الصناعي، فإنه لا ينبغي أن يُختلف في حظره، إذ صناعة الغناء مباينة للقرآن بكل وجه، لأن القراءة والأداء تحتاج إلى مقدار من الصوت لتعين أداء الحروف لا من حيث اتباع الحركات في موضعها ومقدار المد عند من يطلقه أو يقصره وأمثال ذلك، والتلحين أيضاً يتعين له مقدار من الصوت لا يتم إلا به من أجل التناسب الذي قلناه في حقيقة التلحين، واعتبار أحدهما قد يخل بالآخر إذا تعارضا، وتقديم الرواية متعين من تغيير الرواية المنقولة في القرآن، فلا يمكن اجتماع التلحين والأداء المعتبر في القرآن بوجه، وإنما مرادهم التلحين البسيط الذي يهتدي إليه صاحب المضمار بطبعه كما قدمناه فيردد أصواته ترديداً على نسب يدركها العالم بالغناء وغيره، ولا ينبغي ذلك بوجه كما قاله مالك، هذا هو محل الخلاف). [تاريخ ابن خلدون 1/425]
فإذا عُلم هذا؛ تبيّن خطأ من رخّص في تعلم المقامات الموسيقية بدون آلات وقراءة القرآن بها.
والذي أوجب هذا الخطأ هو حمل كلام العلماء على غير محمله، وفهمه على غير مرادهم، إذ فهم بعض الناس من لفظ التغني والغناء والترنم والطرب ما هو دارج في عرف العامة اليوم من غناء أهل الفسق وطربهم بالآلات الموسيقية ونحو ذلك، وهذا خطأ كبير أن تُحمل ألفاظ ونصوص الكتاب والسنة على ما شاع بين الناس من المعاني المتعارف عليها. بل يجب تفسير النصوص بما دلت عليه النصوص الأخرى وبما هو معروف من لغة العرب لا بما هو منصرف إليه من المعاني في عرف عامة الناس.
ومن ذلك ما فهمه بعض الناس من قول ابن حجر في «الفتح»: (ومن جملة تحسينه أي القرآن- أن يُراعى فيه قوانين النغم). ففهم من لفظ «النغم» الأنغام الموسيقية.
والحقيقة أن ألفاظ التغني والتطريب والنغم والترنم كلها تدور حول تحسين الصوت والجهر به.
قال في «تاج العروس» في معنى «الغناء»: ((والغِناءُ، ككِساءٍ؛ من الصَّوْتِ: ما طُرِّبَ به) قالَ حُمَيْدُ بنُ ثَوْر: وعَجِبْتُ به أَنَّى يكونُ غِناؤُها، وفي الصِّحاح: الغِناءُ، بالكسْرِ، من السماعِ. وفي النِّهايةِ: هو رَفْعُ الصَّوْتِ وموالاته. وفي المِصْباح: وقيِاسُه الضَّم لأنَّه صَوْتٌ).
وقال أيضاً في معنى «التطريب»: (والتَّطْرِيب في الصَّوْت: مَدُّهُ وتَحْسِينُه. وطَرَّبَ في قِراءَته: مَدَّ ورجَّعَ وطرَّبَ الطَّائِرُ في صَوْتِه كَذَلِكَ، وخَصَّ بَعْضُهُم بِهِ المُكَّاءَ. وفُلَانٌ: قَرأَ بِالتَّطْرِيب).
وقال في معنى «الترنم»: ((و) الرَّنَم (بالتَّحْرِيك: الصَّوتُ). وقد رَنِم بالكَسْر: إذا رَجَّع صَوْتَه كما في الصحاح، (والرَّنِيم والتَّرْنِيم: تَطْرِيبُه) كما في المُحْكَم، وقال الجوهريّ: والتَّرْنِيم: تَرْجِيعُ الصَّوت).
وقال في معنى «النغم»: (النَّغَمُ: مُحَرَّكَةً، وتُسَكَّنُ: الكَلاَمُ الخَفِيُّ، الوَاحِدةُ بِهَاءٍ)، قَالَ شَيْخُنَا: فَمُفْرَدُهُ تابَعٌ لِجَمْعِه في الضَّبْطِ، انتهى، وفُلاَنٌ حَسَنُ النَّغْمَةِ، أي: حَسَنُ الصَّوْتِ في القِرَاءَةَ، كَمَا في الصَّحَاحِ).
وعلى هذا فالتغني والتطريب والترنم والنغم كلها ألفاظ تدل على تحسين الصوت وترجيعه، ومنه سمي الغناء غناءاً.
وأقوال أهل العلم في تفسير هذه الأحاديث كلها تدور حول هذه المعاني.
قال ابن جرير: (معنى الحديث تحسين الصوت والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ سامع صوته، كما أن الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذي يطرب سامعه). [شرح ابن بطال 10/260]
وقال ابن حجر: (يحسن به صوته جاهراً به مترنماً على طريق التحزن…ولا شك أن النفوس تميل إلى القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم.لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب وإجراء الدمع). [فتح الباري 9/72]
فحَملُ هذه الألفاظ على الألحان الموسيقية والاستدلال بها على جواز ذلك خطأ ظاهر، كما ذكر ذلك ابن تيمية وابن القيم وغيرهما.
ومن هنا خُصّ داود – عليه السلام – بما وهبه الله – تعالى -من الأصوات الجميلة التي يطرب لها كل من سمعها حتى الطيور والبهائم. وقد سمى النبي – صلى الله عليه وسلم – ما أعطي داود – عليه السلام – مزامير، فقال لأبي موسى الأشعري: ((لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ)) متفق عليه.
ومعلوم أن المزامير جمع مزمار، وهي آلة تُصدر صوتاً جميلاً، فالمزمار صوت لا لحن كما ظنه بعض الناس، وإنما الألحان من صنيع الآدمي بالمزمار، وليست اللذة فيه إلا من حسن ما يُصدره من الصوت، ولذلك يُصنع على كيفية تخرج الصوت الجميل.
وقوله – صلى الله عليه وسلم – ((أوتيت)) يدل على أنه من الله – تعالى -هبة وخصيصة، لا أنه يحصل بالتعلم، وهذا يؤكد أن المراد بالمزامير الأصوات لا الألحان.
قال ابن الأثير في «النهاية»: (وفي حديث أبي موسى سَمِعه النبي – صلى الله عليه وسلم – يقرأ فقال: ((أُعْطِيتَ مزْمارا من مَزَامِير آلِ دَاودَ)). شبَّه حُسنَ صَوته وحلاوة نَغْمَته بصوت المِزْمارِ. وداودُ هو النبي – عليه السلام – وإليه المُنْتَهى في حُسْن الصَّوت بالقراءةِ). [2/778]
وقال ابن خلدون: (وأما قوله – صلى الله عليه وسلم – ((لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود)) فليس المراد به الترديد والتلحين، إنما معناه حسن الصوت وأداء القراءة والإبانة في مخارج الحروف والنطق بها). [تاريخ ابن خلدون 1/426]
ولو قُدّر أن المراد بالمزامير الألحان، لم يكن لداود – عليه السلام – خصيصة، إذ يمكن تعلم هذه الألحان، وهذا يقتضي أن يكون كل من تعلمها حاز مزامير داود – عليه السلام -، فتسبح معه الطير والجبال، وتخشع البهائم، وهذا لا شك في بطلانه، بل يلزم من هذا أن يكون جميع المطربين اليوم والملحنين الموسيقيين قد أوتوا مزامير داود!!
ومن الناس من فسر المزامير بالألحان أخذاً من قول ابن بطال في شرح البخاري: (وقال ابن عباس: إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحنًا، يلون فيهن، ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم).
وهذا الأثر لا يصح عن ابن عباس، بل هو منكر غير ثابت عنه، فقد رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (24/46) والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (رقم 1097)،، والنعالي في «فوائده» (مخطوط: صفحة (3) حديث رقم (6) نقلاً عن برنامج جوامع الكلم)، والخلدي في «الفوائد والزهد والرقائق والمراثي» (ص 2)، وذكره البرهانفوري في «كنز العمال» (8/665) وعزاه لابن زنجويه وابن عساكر وقال: (وفيه فضالة الفرج بن فضالة ضعيف).
كما أن اللفظ الصحيح كما هو في الرواية المُسندة عنه – رضي الله عنه -: «سبعين صوتاً» وليس فيه «لحناً». والذي يظهر أن ابن بطال إنما نقلها بالمعنى أو من حفظه، وأخذها عنه ابن القيم وابن حجر، لأنهما إنما نقلا عن ابن بطال، فقالا: (قال ابن بطال) ثم ذكرا لفظ «لحناً».
وهذا الأثر إن كان محفوظاً فإنما يدل على أن هذه السبعين التي أعطيها داود – عليه السلام – أصوات جميلة متنوعة لا ألحان مُتكلفة قابلة للتعليم.
قال وهب بن منبه: (إن الله – عز وجل – أعطى داود شيئاً لم يعطه غيره، من حسن الصوت من خلقه، إنه كان إذا قرأ الزبور تسمع الوحش إليه حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر، وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا عَلَى أصناف صوته، وكان شديد الاجتهاد، وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة فكأنما ينفخ في المزامير، وكان قد أعطي سبعين مزموراً في حلقه). رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (15299).
وهذا من وهب بن منبه توضيح وتفسير في أن الذي أعطيه داود – عليه السلام – إنما هو الصوت الحسن لا الألحان، ولذلك قال: « وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته»، وقال: « وكان قد أعطي سبعين مزموراً في حلقه».
وعند التأمل نجد أن غاية ما يستدل به من يجوّز القراءة بألحان الغناء والموسيقى أحاديث تدل على الترغيب في تحسين الصوت بالقراءة كأحاديث الأمر بالتغني والتحبير ونحو ذلك، ليس فيها ما هو نص أو حتى ظاهر في الرخصة في القراءة بألحان أهل الغناء والموسيقى، بينما نجد الأدلة التي تدل على المنع من هذه الألحان أظهر في الدلالة، فمنها ما رواه أحمد (3/494) وأبو عبيد في فضائل القرآن (1/235) عن عبس الغفاري – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ((بادروا بالأعمال خصالا ستا: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقوماً يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ما يقدمونه إلا ليغنيهم)). صححه الألباني في الصحيحة (979).
ويُقال أيضاً: لا ريب أن الأحاديث إن اختلف الناس في مدلولاتها، فإنه يتعين النظر في عمل الصحابة والتابعين، وإنا إذا نظرنا فيما جاء عن الصحابة والتابعين فإننا لا نجد عنهم الترخيص في ألحان أهل الغناء والموسيقى، بل قد جاء عنهم ما يدل على النهي عنه، فقد روى الدارمي (3545) وغيره عن الأعمش أنه قال: (قرأ رجل عند أنس بلحن من هذه الألحان فكره ذلك أنس). ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن (1/335) بزيادة رجل بين الأعمش وأنس.
ورواه محمد بن المظفر البزار في «غرائب مالك بن أنس» (ص14): عن مالك بن أنس، عن أبان، عن أنس بن مالك: أنه سمع رجلاً يقرأ بالألحان فرفع حريرة كانت على حاجبه، فأرانا، من كان يعرف هذا على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
ومما يؤكد هذا ما ثبت عن محمد بن سيرين أنه قال: (كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة). رواه الدارمي (3546)
ومعلوم أن المعنيين بقول ابن سيرين (كانوا) إنما هم الصحابة وكبار التابعين، وحكمهم على هذه الألحان بالبدعة أبلغ من النهي المجرد، لأنه يفيد أن المسألة ليست من قبيل مسائل الخلاف.
ولذلك كان بعض السلف ينهى عن التحديث ببعض الأحاديث الآمرة بالتغني بالقرآن وتحسين الصوت به خشية أن يأتي قوم يفهمون منها القراءة بألحان الموسيقى وأهل الغناء والمجون.
فقد قال أبو عبيد: حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال: (نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم). قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في هذه الألحان المبتدعة، فلهذا نهاه أن يحدث به. [فضائل القرآن لأبي عبيد 1/335]
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.