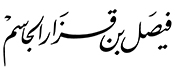الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فإن من أعظم نعم الله – تعالى -على العبد أن يهديه الصراط المستقيم، وهو الصراط الذي رسمه الله – تعالى -وشرعه وجعله موصلاً إليه دون غيره ودالاً عليه كما قال – تعالى -(هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ)، وقد امتن الله – تعالى -على من اصطفى من عباده بالهداية إليه كما قال – تعالى -في سياق مننه على موسى وهارون (وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)، وقال – تعالى -عن الأنبياء (وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ). ولأهمية هذا الأمر وعِظَمه فرض الله – تعالى -على العباد أن يسألوه إياه في كل يوم سبع عشرة مرة كما في قوله – تعالى -(اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيم).
وهذه الهداية إلى الصراط هي النعمة العظيمة والمنحة الجليلة كما قال – تعالى -(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ) أي أنعمت عليهم بالهداية إلى هذا الصراط، وهؤلاء المنعم عليهم هم المذكورون في قوله – تعالى -(وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ).
وهذا الصراط المستقيم والدين القويم يُكسب القلب والقول والعمل صِبغة خاصة تظهر على كل من التزمه وسلكه، فترى السالك لهذا الصراط اعتقاداته وأقواله وأفعاله على وفق مراد الله – تعالى -ومحابه، كما جاء في الحديث الصحيح «فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي». وهذه الصِّبغة هي المذكورة في قوله – تعالى -(صِبغة اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبغة)، وقد اتفقت كلمة المفسرين منهم ابن عباس – رضي الله عنه – وغيره من التابعين على أن المراد بالصِّبغة: دين الله – تعالى -، وتكون (صِبغة) منصوبة على الإغراء، أي: الزموا صِبغة الله التي هي دينه – تعالى -.
قال السعدي – رحمه الله – في تفسير الآية: (الزموا صِبغة الله، وهو دينه، وقوموا به قياماً تاماً، بجميع أعماله الظاهرة والباطنة، وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى يكون لكم صِبغة، وصفة من صفاتكم، فإذا كان صفة من صفاتكم، أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره، طوعاً واختياراً ومحبةً، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية، لحث الدين على مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ومعالي الأمور، فلهذا قال – على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية-: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبغة)، أي: لا أحسن صِبغة من صِبغته.
وإذا أردت أن تعرف نموذجاً يبين لك الفرق بين صِبغة الله وبين غيرها من الصِّبَغ، فقس الشيء بضده، فكيف ترى في عبد آمن بربه إيماناً صحيحاً، أثَّر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح، فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن، وفعل جميل، وخلق كامل، ونعت جليل، ويتخلى من كل وصف قبيح، ورذيلة وعيب، فوصفه: الصدق في قوله وفعله، والصبر والحلم، والعفة، والشجاعة، والإحسان القولي والفعلي، ومحبة الله وخشيته، وخوفه، ورجاؤه، فحاله الإخلاص للمعبود، والإحسان لعبيده، فقسه بعبدٍ كَفَر بربه، وشرد عنه، وأقبل على غيره من المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة، من الكفر، والشرك والكذب، والخيانة، والمكر، والخداع، وعدم العفة، والإساءة إلى الخلق، في أقواله، وأفعاله، فلا إخلاص للمعبود، ولا إحسان إلى عبيده.
فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أنه لا أحسن صِبغة من صِبغة الله، وفي ضمنه أنه لا أقبح صِبغة ممن انصبغ بغير دينه.
وفي قوله: (وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ) بيان لهذه الصِّبغة، وهي القيام بهذين الأصلين: الإخلاص والمتابعة، لأن «العبادة» اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال، والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا تكون كذلك، حتى يشرعها الله على لسان رسوله، والإخلاص: أن يقصد العبد وجه الله وحده، في تلك الأعمال، فتقديم المعمول، يؤذن بالحصر.
وقال: (وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ) فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار، ليدل على اتصافهم بذلك وكونه صار صِبغة لهم ملازماً) ا. هـ
فهذه الصِّبغة: هي القيام بالأصلين: الإخلاص والمتابعة، وهو التوحيد والسنَّة، فترى أثر هذه الصِّبغة على المصطبغ بها في أقواله وأفعاله واعتقاداته، فتعم هذه الصِّبغة جميع الدين، حتى تصير كهيئة اللون المتميز والذي يُرى ظاهراً في كل من اصطبغ به، فهي صِبغة ظاهرة لا خفية، بادية لا مستترة، تُعرف من أقوال المصطبغ بها وأفعاله، فتجد هيئته على السنّة، وكلامه على السنّة، وأقواله على السنّة، وأخلاقه على السنّة، وعباداته على السنّة، ودعوته على السنّة، وأمره بالمعروف على السنّة، ونهيه عن المنكر على السنّة، وبحثه وتقليبه للمسائل واستدلالاته على السنّة، كل ذلك مع الإخلاص لله – تعالى -، فقد جمع بين كمال الانقياد وكمال الإخلاص.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصحابة ومن سلك سبيلهم: (إذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه: نظر فيما قاله الله والرسول – صلى الله عليه وسلم -، فمنه يتعلم، وبه يتكلم، وفيه ينظر ويتفكر، وبه يستدل فهذا أصل أهل السنة) [مجموع الفتاوى 13/63]
وهذه الصِّبغة فيها معنى التميّز، فيتميز المصطبغ بها عمن خالف الصراط المستقيم بحسب مخالفته، بحيث لا تلتبس معرفة المصطبغ بها، ولا يُخلط ويُلحق بغيره من أهل الانحراف لتميّزه. وهذا التميز منه ما تضفيه الصِّبغة على صاحبها ولا بد، ومنه ما هو من لوازمها كمخالفة المشركين وأهل الضلال والبدع ومجانبتهم وترك مخالطتهم.
وظهور الحق وعلوه مرتبط بهذا التميز، ولهذا شُرعت مخالفة المشركين فيما ليس من خصائصهم، بل وفيما ليس من فعل الإنسان كما في الصحيح عن النبي – صلى الله عليه وسلم -:((إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم))، ومنه الأصل المتفق عليه عند أهل السنّة وهو هجر أهل البدع ومجانبتهم.
وهذه الصِّبغة تختلف قوة وضعفاً، وظهوراً وخفاءاً بحسب التزام الإنسان للصراط المستقيم، فكلما كان أقوم بالحق، وأعظم توحيداً واتباعاً كانت الصِّبغة أظهر وأبيَن. وقد يختلف ظهور هذه الصِّبغة قوة وضعفاً في الشخص الواحد بحسب قيامه بالحق والتزامه له. وكلما ازدادت هذه الصِّبغة ضعفاً في المسلمين والمنتسبين إلى السنّة ضعُف الحق، والتبس بغيره من الباطل.
ومظاهر ضعف صِبغة الله – تعالى -في المنتسبين إلى السنّة كثيرة متنوعة، أذكر منها شيئاً يسيراً على سبيل الإيجاز والاختصار:
فمن مظاهر ضعف هذه الصِّبغة في الهيئة الظاهرة: التساهل في التمسك بالسنّة، وصور ذلك متنوعة منها التساهل في إسبال الثياب، والأخذ من اللحية، وهي أمورٌ قد شاعت وانتشرت. ويدخل في ذلك ضعف الاعتناء بالسنن والنوافل، كسنن الصلاة والحج والصيام ونحو ذلك، فلا يحرص بعضهم على أن يصلي كما يصلي النبي – صلى الله عليه وسلم -، بل تراه في رفع اليدين ووضعهما وفي ركوعه وسجوده وفي كثير من أفعال الصلاة على خلاف السنّة، ومثله يُقال في الحج وفي غيره من العبادات، وكل هذا من ضعف صِبغة الله على عبده.
ومنها الترخّص والتساهل في الأقوال والآراء المخالفة لظاهر السنّة بحجة أن هناك من قال بها من العلماء، وهذا في حقيقة الأمر داخل فيما يُعرف بـ«الرأي» الذي اتفقت كلمة السلف على ذمه والإنكار على أهله، وهو ترك الدليل من الكتاب والسنّة وأفعال الصحابة لأقوال وآراء من ليس قوله حجة، فالعبرة بالدليل لا بوجود من رخّص وجوّز ولو كان من العلماء، وآثار السلف في إنكار هذا الأمر أشهر من أن تُذكر، منها قول ابن عباس – رضي الله عنه – لمن عارض السنّة بقول أعلم الأمة بعد نبيها أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما -: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر». فكيف بمن هو دون أبي بكر وعمر!
ومن مظاهر ضعف هذه الصِّبغة: ترك الاعتناء بآثار الصحابة وأقوالهم وأفعالهم، والاستعاضة عنها بآراء من ليست أقوالهم حجة، بل وبآراء من تلبسوا ببدع ومخالفات خرجوا بها عن حد السنّة، كمن اعتنى بأقوال الصوفية في تزكية النفوس، وأذاع مقولاتهم، وذكر أحوالهم حتى غلب ذكرهم في كلامه على كتاب الله وسنّة نبيه – صلى الله عليه وسلم – وهدي سلف الأمة، والذي هو السبيل الأقوم لإصلاح النفوس وتزكيتها، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – قد بُعث لتزكية النفوس، قال – تعالى -(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِم).
قال ابن القيم: (فإن تزكية النفوس مسلّم إلى الرسل، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها، وجعلها على أيديهم دعوة وتعليماً وبياناً وإرشاداً، لا خلقاً ولا إلهاماً، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم) [مدارج السالكين 2/315]
وقال ابن رجب: (ومما أُحدِث من العلوم: الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم: وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره….
فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة، وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام، والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولاً، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانياً، وفي ذلك كفاية لمن عقل، وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل). [فضل علم السلف ص34]
وتَركُ الاعتناء بآثار وأقوال الصحابة ظهر أيضاً في الفقه والاستدلال، فضعف الاحتجاج بأقوال الصحابة – رضي الله عنهم – فيما لم يرد فيه حديث، وهذا خلاف المعروف من طريقة السلف في الاستدلال، فإنهم كانوا يحتجون بأقوال الصحابة فيما لم يرِد فيه دليل من كتاب أو سنّة، ولا يقدِّمون عليه رأياً ولا قياساً، بل لا خلاف بينهم في ذلك، وقد استفاض ابن القيم في التدليل لهذه المسألة في «إعلام الموقعين» وذكر أكثر من أربعين دليلاً على حجية أقوال الصحابة، ونقل اتفاق السلف على ذلك. فضعفت على إثر ذلك صِبغة الله بقدر ما أُهمل من آثار الصحابة – رضي الله عنهم -، وصار همُّ بعضهم ضبط قواعد المذهب، ومعرفة الراجح فيه، ونحو ذلك، بل والسعي في البحث عمن يضبط قواعد المذهب من المذهبيين، بينما قلَّ اعتناؤهم بمعرفة معاني القرآن، وضبط أقوال وأفعال النبي – صلى الله عليه وسلم -، وأقوال وأفعال أصحابه.
قال معمر: (أخبرني صالح بن كيسان، قال: اجتمعتُ أنا والزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا: نكتب السنن، فكتبنا ما جاء عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: نكتب ما جاء عن أصحابه؛ فإنه سنّة، وقلت أنا: ليس بسنَّة، فلا نكتبه، فكتب ولم أكتب، فأنجح وضيعت). [جامع بيان العلم وفضله 1/155]
وقال الأوزاعي: (العلم ما جاء به أصحاب محمد – صلى الله عليه وسلم -، فما كان غير ذلك فليس بعلم). [فضل علم السلف ص32]
وقال أحمد بن حنبل: (الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، وعن أصحابه، ثم هو بعد في التابعين مخير). [صحيح الفقيه والمتفقه ص172]
فالاهتمام بآثار الصحابة وأقوالهم والاحتجاج بها من صِبغة الله – تعالى -.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيراً وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله، كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك؛ فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنَّة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم). [مجموع الفتاوى 13/24]
وقال الحافظ ابن رجب: (فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم، فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه، إلا أن يكون شرحاً لكلام يتعلق من كلامهم، وأما ما كان مخالفاً بكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه. وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة مالا يهتدى إليه من بعدهم ولا يلم به.
فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم،…. إلى أن قال: وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد). [فضل علم السلف ص30]
ومن مظاهر ضعف هذه الصِّبغة أيضاً في بعض المنتسبين إلى السنّة: ضعف دعوتهم إلى التوحيد والسنّة، وعدم الاهتمام ببيان التوحيد وإظهاره، ونشر السنّة وإذاعتها، في الدروس والمحاضرات والمواعظ وخطب الجمعة والبرامج الإذاعية والتلفزيونية وغيرها من وسائل الدعوة، إذ إن المصطبغ بصِبغة الله – تعالى -يظهر اهتمامه بهذين الأصلين في دعوته ظهوراً جلياً، لكونهما لبّ الدعوة وأسّها، وما بُعث الأنبياء إلا لبيانهما. فهذا الضعف يظهر في عدم الاهتمام بهما والاكتفاء بالمواضيع العامة التي يشترك في الاهتمام بها جميع الطوائف والنحل والفرق، مع مسيس الحاجة لبيان التوحيد والسنّة لكثرة المخالفين ودعاة الباطل في هذه الأزمنة. فبعض الدعاة من المنتسبين إلى السنّة إذا سمعته في دروسه ومحاضراته لا يظهر لك انتسابه إلى السنّة وتمسّكه بها من خلال كلامه، فتجده يتكلم كلاماً عاماً لا يظهر من خلاله النفس السلفي، ولا تبدو منه تلك الصِّبغة في استدلاله واستشهاده وتقريراته وتنبيهاته على مسائل التوحيد والسنّة في ثنايا كلامه وغير ذلك مما ينبغي أن يكون عليه المصطبغ بصِبغة الله – تعالى -، صِبغة التوحيد والاتباع، ويؤكد هذا أن كثيراً من هؤلاء الدعاة يُدعون إلى بعض منتديات ومراكز المخالفين للسنَّة أو في بعض قنواتهم، لكونهم لا يظهر من دعوتهم وطرحهم للمسائل الدعوة إلى السنّة، وهي التي يخالفها هؤلاء المخالفون، فلا يجد المستمع فرقاً بين المنتسب إلى السنّة وغيره من المخالفين في مثل هذه الأماكن والمنتديات، بينما لا يُدعى إلى هذه المنتديات وغيرها من عُرف بالطرح السلفي الواضح، ومن ظهرت عليه آثار هذه الصِّبغة الربانية.
ويظهر هذا أيضاً من خلال فضائيات بعض المنتسبين إلى السنّة، إذ لا ترى التميّز في الطرح، والاهتمام بالأصل، والحرص على إبراز واستضافة من عُرفوا بالسنّة والدعوة إليها والنشاط في تقريرها وإيضاحها والاكتفاء بهم، بل على العكس ترى في بعضها سعياً في مواكبة فضائيات وبرامج المخالفين للسنّة، وجرياً حثيثاً في التفوق عليهم في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع إن سلمت من المخالفة!
ومن مظاهر ضعف هذه الصِّبغة: عدم تميز بعض المنتسبين للسنّة عن غيرهم من المخالفين والمجانبين لطريق السنّة من أرباب الجماعات والحركات الإسلامية المعاصرة التي تنكبت طريق السنّة، وسلكت طريق الانحراف والبدعة، وهم بذلك يخلطون الحق بالباطل، ويزينون الباطل من حيث لا يشعرون، مع إضعافهم في الوقت نفسه للسنّة وتهوينهم لها بغشيان منتديات هؤلاء المنحرفين، وهم مع تذرّعهم بتحقيق مصلحة، فقد فوتوا ما هو أعظم منها مع ما وقعوا فيه من المفسدة العظيمة والمتمثلة بالسكوت عن عيب أهل البدع والتحذير منهم ومجانبتهم، وتزيين ما هم عليه أمام العامة بمشاركتهم ومخالطتهم على وجه لا يتميز المحق فيه من المُبطل.
قال سفيان الثوري: (من جالس صاحب بدعة لم يسلم من ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموا، وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه الله إياه). [البدع لابن وضاح ص89]
لا سيما أننا نعيش في بلاد تنتشر فيها السنّة، وقنوات وسبل الدعوة لدى أهل السنّة كثيرة، فليسوا هم بحمد الله قلة ولا مستضعفين عاجزين عن الدعوة إلا عبر قنوات المخالفين ومنتدياتهم.
ومن مظاهر ضعف هذه الصِّبغة: ضعف جانب السلوك والعبادة، وهو الأمر المقترن بمذهب وطريق السلف ولا بد، فالعبادة والسلوك لازم من لوازم سلوك الصراط المستقيم، فقد ذكر الله – تعالى -في آيات كثيرة ما اتصف به أهل الحق من التعبد لله – تعالى -بالقيام والصدقة والخشية والاستكانة والصبر والصفح والرحمة ونحو ذلك مما ذكره الله – تعالى -في كتابه، وأثنى على نبيه بقوله (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)، وقال – صلى الله عليه وسلم -: ((إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق))، وهذا التعبد والسلوك أثر من آثار العلم الصحيح.
قال الحسن البصري: (قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يُرى ذلك في تخشعه و هديه و لسانه و بصره و بره). [شعب الإيمان للبيهقي 2/291]
فالسلوك والتعبّد لله – تعالى -جزء من عقيدة ومنهج السلف، فالمصطبغ بصِبغة الله يظهر أثر هذا السلوك وتبدو هذه الصّبغة في أفعاله وتصرفاته، وفي أمره ونهيه، ولذا كان أهل السنّة والجماعة الذين التزموا صِبغة الله – تعالى -أعلم الناس بالحق، وأرحمهم للخلق. فما نراه في بعض المنتسبين للسنّة من الجفاء والغلظة والقسوة من غير مسوّغ شرعي حتى صار سمة لبعضهم ما هو إلا أثر من آثار ضعف صِبغة الله. كما صار قلة التعبّد أيضاً بادياً على بعضهم، وليتهم كانوا منشغلين بما هو أهم من ذلك كالبحث في العلم والقيام بمصالح المسلمين، وإنما في القيل والقال ونحو ذلك، فضعفت صِبغة الله – تعالى -في هؤلاء بقدر ما ضعف من اعتنائهم بالسلوك، وبقدر ما قلّ من تعبّدهم لله – تعالى -.
والله أعلم وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.