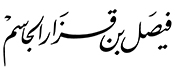الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد،،
فقد كان الهدف الرئيس من تأليف كتاب «الأشاعرة في ميزان أهل السنَّة» هو ردّ الباطل الذي روّج له الأخوان مؤلفا كتاب «أهل السنَّة الأشاعرة» بإدخال الأشاعرة في دائرة أهل السنَّة والجماعة، بل وجعلهم هم أهل السنَّة والجماعة على الحقيقة، ولم يكتفيا بذلك حتى جعلا كل من أثبت صفات الله تعالى التي نطق بها الكتاب وجاءت بها السنَّة الصحيحة وأجمع عليها السلف والأئمة على الحقيقة لا على المجاز مّشبّهاً ممثّلاً.
وكان المؤمّل من المؤلِّفَيْن أن يتأملا بإنصاف ما جاء في كتاب الردّ من الحشد والجمع لكلام أئمة السلف في إثبات حقيقة الصفات وإبطال دعواهما وهو الهدف الثاني من تأليف كتاب الردّ، إلا أنهما وللأسف الشديد كابرا في ردّ النصوص المستفيضة عن السلف في إثبات حقائق الصفات لله تعالى مع نفي التمثيل عنها، وأصرّا على دعواهما العريضة التي لا تعدو كونها دعوى مجردة خلية عن الدليل والبرهان، وذلك أني وقفت على مقال لهما ينتقدان فيه كتاب «الأشاعرة في ميزان أهل السنَّة» وعنونا له بـ «ثلاثة أمثلة قصار على تطفيف ميزان فيصل قزار»، كما أنهما قد أجريا حواراً حول الكتاب كررا فيه تلكم الدعاوى العريضة، وعلى عادتهما أخلياه عن الأدلة والبراهين.
ومن تأمل المقال والحوار يُدرك حجم العجز الذي وقعا فيه في إثبات دعواهما العريضة، وهذا ما سأوقف القارئ على بعضه في هذه المقدمة.
وقد كنت أخرت هذه الوقفات حتى يُخرج المؤلّفان ما في جعبتهما، إذ أنهما وعدا ومنذ سنين بالردّ على كتاب “الأشاعرة في ميزان أهل السنّة” إلا أننا لم نر شيئاً حتى الآن، فلم أر بدّاً من إخراج هذه الوقفات في هذا الوقت.
وقبل أن أشرع بنقد ما جاء في المقال والحوار، أحببت أن أشير إشارة سريعة إلى الفارق الكبير بين الكتابين؛ كتاب الردّ والكتاب المردود عليه الأصل، لأوقف القارئ على حقيقةٍ ما كان ينبغي أن تغيب عن أذهان المؤلِّفَيْن لو أنصفا، وهذه الإشارة تتعلق بالبناء الذي قام عليه الكتابان والأساس الذي استندا إليه، وهو ما جمعاه من الأدلة والبراهين في إثبات دعوى كل منهما، الرادّ والمردود عليه، إذ لا يخفى على أحد أن صحة الدعوى قائمة على الحجة والبرهان، وليس ثمة حجة وبرهان في باب أسماء الله تعالى وصفاته إلا الكتاب والسنَّة وما كان عليه سلف الأمة. فمن كانت نصوص الكتاب والسنَّة وأقوال السلف والأئمة تشهد له فهو المُحقّ.
وعليه أقول: إن كتاب «الأشاعرة في ميزان أهل السنَّة» قد ذَكرُت فيه من الأدلة ما لا يمكن دفع دلالتها إلا مكابرةً أو جحوداً، وذلك لاستفاضتها كثرةً بحيث يمتنع تأويلها جملةً فضلاً عن آحادها التي هي ما بين نصوص في المسألة وظواهر.
أما الآيات فلا تُحصى كثرةً، وأما الأحاديث فقد رويت فيه أكثر من ثمانين حديثاً صحيحاً احتجاجاً، فضلاً عما جاء منها في ثنايا كلام من نقلت نصوصهم من الأئمة.
وأما آثار السلف فقد أفضت في روايتها:
فرويت عن ثلاثة من الصحابة؛ عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم.
وعن أربعة عشر تابعياً: ربيعة بن عمرو، وعبيد بن عمير، وعلي بن الحسين زين العابدين، وعكرمة مولى ابن عباس، ومجاهد، وخالد بن معدان، وحكيم بن جابر، ومجاهد بن جبر، وابن أبي مليكة، وأبي العالية، والزهري، ومكحول، وسليمان التيمي.
وعن ستة عشر إماماً من أتباع التابعين، منهم: الإمام مالك، والأوزاعي، والليث، والثوري، وأبو حنيفة، والحمادان، وأبو يوسف القاضي، وغيرهم.
وعن ستة وعشرين من أئمة القرن الثالث، منهم: الشافعي، والإمام أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد القاسم بن سلام، والبخاري، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، والترمذي وغيرهم.
وعن ثلاثة وعشرين من أئمة القرن الرابع، منهم: الطبري، وابن خزيمة، وأبو بكر الخلال، ومحمد بن إسحاق السرّاج، وابن أبي زيد القيرواني، وابن بطة، وابن أبي زمنين، والخطابي، والآجري، وغيرهم.
وعن واحدٍ وعشرين إماماً من أئمة القرن الخامس، منهم: الصابوني، والحافظ أبو نعيم، واللالكائي، وابن عبد البر، وأبو عمرو الطلمنكي، وأبو حامد الإسفرائيني، والخطيب البغدادي، وشمس الأئمة السرخسي، وغيرهم.
وعن تسعة من أئمة القرن السادس، منهم: عبد القادر الجيلاني، والبغوي، وأبو البيان الدمشقي وغيرهم.
وعن سبعة عشر إماماً ممن كانت وفاتهم بعد القرن السادس، منهم: القرطبي، والذهبي، وابن كثير، والحافظ ابن رجب، وابن أبي العز الحنفي، وملا علي القاري، وغيرهم.
وكل هؤلاء نقلت عنهم ما بين نصوصٍ في إثبات دعواي، وظواهر يمتنع مع تضافرها وكثرتها ليّها وتأويلها، إذ أن الظواهر إذا اجتمعت على مدلول واحد امتنع تأويلها.
وكثير من هؤلاء قد نقلت عنه أكثر من نص، فاجتمع في الكتاب مئات النصوص عن الأئمة، كلها معزوّة إلى مصادرها الأصلية أو بواسطةِ مَنْ نَقَلها إن تعذّر ذلك.
بينما إذا نظرنا إلى كتاب المؤلِّفَيْن «أهل السنَّة الأشاعرة» فإنهما لم يذكرا في الاحتجاج إلا حديثاً واحداً فقط، حديث «عبدي مرضت فلم تعدني»، ومع ذلك فقد تسلطا عليه بالتأويل والتحريف بما يخالف ظاهره، ويخالف اللغة العربية.
وأما الصحابة والتابعون وأتباعهم فلم ينقلا عنهم حرفاً واحداً.
كما لم ينقلا عن القرن الثالث إلا عن البخاري والترمذي فقط، نقلاً لا يدل لا من قريب ولا بعيد على صحة دعواهما، بل دلت نصوصهما التي ذكرتها في كتابي على نقيض دعواهما، وهذان هما أقدم من نقل عنه المؤلفان.
وأما القرن الذي يليه فلم ينقلا إلا عن الطبري والطحاوي فقط، نقلاً لا يدل على دعواهما، بل إني أفضت في كتابي في النقل عن الطبري بما يدل على نقيض دعواهما، وأما أبو جعفر الطحاوي فعقيدته مشهورة متداولة.
وعامة من نقلا عنهم هم من تأخرت وفاتهم عن القرن الخامس، وجلّهم من علماء القرون المتأخرة.
والباب الوحيد الذي حاولا فيه النقل عن السلف هو باب إثبات التأويل، ولك أن تنظر إلى مروياتهم فيه:
فقد نقلا عن ابن عباس رضي الله عنه ثمانية آثار؛ ثلاثة منها لا أصل لها، وأثران ضعيفان قد ثبت عنه خلافهما، وثلاثة آثار لا تدل على مطلوبهما بحال لا نصاً ولا ظاهراً.
ونقلا عن كلٍّ من مجاهد والضحاك والشافعي أثراً واحداً لا يدل على مطلوبهما لا نصاً ولا ظاهراً، بل قد ثبت عنهم ما يدل على نقيض دعواهما.
ونقلا عن الإمام مالك أثرين لا أصل لهما، بل قد استفاض عنه ما يدل على نقيضهما.
ونقلا عن الإمام أحمد أثراً واحداً لا يدل على مطلوبهما، مع كثرة نصوصه الدالة على نقيض دعواهما.
ونقلا عن البخاري أثرين؛ أحدهما لا أصل له، والآخر لا يدل على مطلوبهما لا نصاً ولا ظاهراً، والثابت عنه نقيض دعواهما.
فهذا مجموع ما حشداه من الأدلة في إثبات دعواهما.
وانظر إلى تلبيسهما عندما قالا في الحوار: (فقد نقلنا أقوال طائفة كبيرة من علماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين).
أقول: أما المتأخرون من الأشاعرة فنعم، وأما المتقدّمون فهيهات؟.
فوازن أخي القارئ بين الدعوتين، وقارن بإنصاف بين البناءين، واحكم واقض بين الخصمين حُكمَ رجلٍ يعلم أنه سيقف بين يدي الله تعالى يوم العرض الأكبر فيُسأل عن حكمه؟.
فإن أبى المؤلفان إلا المكابرة فليوقفانا على كل نصٍ ذكرته في كتابي بعينه موجهين له على المعنى الذي ذهبا إليه ومُبطلين استدلالي به، وأما انتقاء نصٍّ أو نصّين من بين مئات النصوص وانتقاد الاستدلال بها فإنه لا يُبطل المدلول، إذ من المعلوم أن انتفاء الدليل المعين لا يقتضي انتفاء المدلول، فهب أن هذه النصوص المفردة المنتقاة لم تدل على المطلوب، تبقى باقي النصوص الكثيرة دالة عليه، حتى يُبطَل كلّ دليل بعينه.
وهذا أوان الشروع في انتقاد ما جاء في المقال والحوار اللذين سبق الإشارة إليهما، وذلك عبر هذه الوقفات:
الوقفة الأولى: استنكرا المؤلفان عليّ نقلي لكلام أبي الحسن الأشعري في تفسير قوله تعالى (وكلم الله موسى تكليما) [النساء:164]، وقوله: «والتكليم المشافهة»، وهو تفسير وائل بن داود من التابعين، ونقلي عن الجوهري قوله: «المشافهة المخاطبة من فيك إلى فيه». واستدلالي بذلك في إثبات حقيقة التكليم لله تعالى، وأنه بحرف وصوت مسموع.
ولم يذكرا حجة شرعية على بطلان ما ذكرته واستدللت به سوى التهويلات والتشنيعات كعادتهما، مثل قولهما: (العبارات المستشنعة)، (مما يقشعر منه البدن)، (هذه المخازي) ونحو هذه الألفاظ.
كما أنهما ألزامني بما ليس بلازم، فقالا: (فيلزم أن يكون لله تعالى فم كي تصح المشافهة والتكليم!!). وقد أضافا إلى ما ذكرته ما يشبهه مما لم أذكره في كتابي مستنكرين له، وهو ما رواه عبد الله بن أحمد في «السنَّة» عن محمد بن عيسى الطباع أنه قال: (سمعت ابن إدريس سُئل عن قوم يقولون: القرآن مخلوق، فاستشنع ذلك، وقال: سبحان الله شيء منه مخلوق، وأشار بيده إلى إلى فيه).
والجواب عليهما من وجوه:
الوجه الأول: أن تفسير السلف للتكليم بالمشافهة المراد به التكليم بلا واسطة، الذي ضده المكاتبة كما هو معلوم في كلام أهل اللغة والعلماء، حيث تراهم يُفرقون في تلقي العلم وغيره بين المشافهة والمكاتبة، فيقولون: أخذه مشافهة، أو مكاتبة. وعلى هذا فتفسير الأئمة تكليم الله لموسى بأنه مشافهة، مرادهم به أن الله تعالى كلّم موسى بلا واسطة، فسمع موسى كلام الله تعالى.
قال ابن أبي زمنين في «أصول السنَّة»: (ومن قول أهل السنَّة: أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم) ا.هـ. [(ص117)]
أي: بلا واسطة.
الثاني: إلزامي بإثبات الفم لله تعالى من إقراري لكلام الجوهري في تفسير المشافهة ليس بلازم إذا علمنا بأن المراد بالمشافهة هو التكليم بلا واسطة، ومثله ما جاء عن ابن إدريس من الإشارة إلى فمه فإنه أراد به إثبات كلام الله تعالى وأنه غير مخلوق لأنه خرج منه، وليس منه شيء مخلوق، وليس المراد منه إثبات فمٍ لله تعالى، إذ أن الصفات لا تثبت إلا توقيفاً، وإنما المراد بذلك تحقيق الصفة التي هي في الإنسان من الفم ونحوه، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه وأذنه وهو يتلو قوله تعالى (إن الله كان سميعاً بصيراً) [النساء:58]. وكما هزَّ النبي صلى الله عليه وسلم يده وهو على المنبر وهو يذكر هزَّ الله تعالى للسماوات يوم القيامة إذا قبضهن في يده.
وقد أجابا أنفسهما عن هذا لما ذكرا حديث إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه وأذنه، حيث قالا في الحوار: (ومن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إثبات العين في الحديث يلزمه إثبات صفة الأذن، وهذا لم يقل به سني). وقالا أيضاً: (النبي صلى الله عليه وسلم أراد في الحديث إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى، هذا ما نعتقده، ولم يُرد إثبات صفة العين –كما يدّعي الخصم- ولو كان المراد كذلك كما يدّعي للزم أن يُثبت لله تعالى أذناً كما أثبت عيناً، وهذا لا يقول به الخصم).
فجوابهما هنا هو جوابنا عن لفظ المشافهة، وعن إشارة ابن إدريس إلى فمه.
أما ادعاء أني أثبت العين لله تعالى من هذا الحديث على الخصوص فمحض افتراء، فهلا أشارا إلى الموضع الذي استدللت فيه بهذا الحديث على إثبات العين لله تعالى.
نعم صفة العين ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنَّة والإجماع، لكن لا يدل هذا الحديث على إثبات هذه الصفة بالخصوص، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الإشارة إلى العين والأذن -كما ذكرت في الكتاب- هو تحقيق صفة السمع والبصر التي هي في الإنسان من العين والأذن.
الوقفة الثانية: طَعَن المؤلفان جزافاً وبلا بينة ولا برهان بكتب السنَّة، ككتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد، وكتاب «السنَّة» لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب «النقض» للدارمي، وحجتهما في ذلك أن (فيها أمور يقشعر منها البدن)، وفيها (مخازي) وفيها (عبارات مستشنعة)، (طافحة بأقوال يندى لها الجبين، وتقشعر منها الأبدان، فلا عبرة فيها ولا كرامة)، ولم يذكرا دليلاً علمياً سوى اقشعرار أبدانهما!، واستشناعهما!
وما أشبه هذين بما رواه عبد الرزاق عن طاووس قال: سمعت رجلاً يُحدّث ابن عباس رضي الله عنه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا –وهو حديث وَضْعِ الله تعالى قَدَمَه في النار فتقول: قط قط-، فقام رجل فانتفض، فقال ابن عباس: «ما فَرَقُ هؤلاء؟ يجدون رقّةً عند محكمه، ويهلكون عند متشابهه». [رواه عبد الرزاق في مصنفه (11/423) وابن أبي شيبة (15/312)]
واقشعرار أبدانهما حقٌّ، لكن كما قال تعالى (وإذا ذُكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون) [الزمر:45]
وعجبٌ أمرهما؛ تقشعر أبدانهما مما جاء في السنَّة وعلى ألسنة أئمة السنَّة من الصحابة والتابعين والأئمة، ولا تقشعر من كلام المتأخرين الحيارى في تلمّس حيل المجازات لصرف كلام الله تعالى عن حقيقته.
وقد كفانا الشيخ دغش العجمي إثبات صحة نسبة كتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد بالأدلة والبراهين في مقدمته للكتاب، والدكتور محمد بن سعيد القحطاني في إثبات صحة كتاب «السنَّة» لعبد الله في مقدمة تحقيقه له، فلتُراجع.
الوقفة الثالثة: تعقب المؤلفان الشيخ مشهور بن حسن تقديمه لكتابي لكوني قد نقلت فيه عن أبي حنيفة من كتابه الفقه الأكبر، وهو الكتاب الذي ضعّف الشيخ مشهور نسبته لأبي حنيفة.
والجواب أن يُقال لهذين: إنني لم أنقل عن أبي حنيفة من كتابه الفقه الأكبر أو الأوسط، أو الوصية إلا ما وافق الحق الثابت بالكتاب والسنَّة والإجماع، مع عدم الجزم بثبوت هذه الكتب عن أبي حنيفة لما في أسانيدها من المقال، وهذا على سبيل الاستشهاد والاعتضاد لا على سبيل الاعتماد، لكون أصول هذه المسائل قد ثبتت بالأدلة، وإنما تُذكر هذه الأقوال لكونها من الشواهد على الحق الثابت، كما يذكر العلماء المراسيل والمنقطعات والإسرائيليات في تأييد ما قد تحقق ثبوته، وأما أن تُتخذ هذه المراسيل والمنقطعات والإسرائيليات ومثلها ما نُقل عن الأئمة أصلاً يُبنى عليه فهذا هو المُستنكر، لأنها إنما تُذكر على سبيل الاعتضاد لا الاعتماد، فكيف إذا كانت هذه المراسيل والمنقطعات والأقوال المأثورات تخالف الحق الثابت بالأدلة، فإنها لا تُذكر حينئذٍ إلا على سبيل بيان ضعفها أو عدم ثبوتها.
فعدم التمييز بين ما يصلح للاعتماد وما يصلح للاعتضاد يوقع في هذا التخبط.
وهو الجواب أيضاً عما استنكراه عليّ أيضاً من نقلي عن أبي حنيفة تفسير الاستواء بالاستقرار اعتماداً على طبعة الكوثري المصحّفة، فطارا بهذا المثال فرحين به، فإني لم أنقله إلا على سبيل الاستشهاد والاعتضاد لا الاعتماد، إذ أن ثبوت الوصية عن أبي حنيفة فيه نظر كما لا يخفى على من اطلع على أسانيدها.
وهو جوابي أيضاً عما نقلته عنه من كتابه «الفقه الأكبر» في مواضع. فلا إلزام لي بما جاء فيه مما يُخالف الحقّ، ويخالف المعروف عن أبي حنيفة وصاحبيه من العقيدة الموافقة لما جاء عن السلف، عدا إخراجه العمل عن مسمى الإيمان، فقول المؤلِّفَيْن في مقالهما: (على أن لنا أن نحتج بما جاء في الفقه الأكبر برواية حماد على أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، ولا حدّ له)، ينم عن جهل بقواعد الاستدلال، فإن هذا الكلام مخالف للكتاب والسنَّة والإجماع، فلا يحل نقله ولا الاحتجاج به، إذ أن غير الثابت لا يُمكن أن يُجعل أصلاً يُعتمد عليه، فكيف إذا كان باطلاً في نفسه مخالفاً للكتاب والسنَّة والإجماع!. وما جاء عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر والأوسط والوصية لا يخلو من أمرين:
الأول: أن لا يكون ثابتاً عنه لضعف أسانيد هذه الرسائل، ومخالفة بعض ما فيها للثابت عنه.
الثاني: أن يكون ثابتاً عنه.
وعلى كلا الحالين فلا استدراك عليّ في النقل منها؛
إذ أنها إن لم تكن ثابتة عنه رحمه الله، فإني لم أنقل منها اعتماداً وإنما نقلت منها اعتضاداً، وباب الاعتضاد أوسع من باب الاعتماد كما سبق.
وإن كانت ثابتة عنه، فإني لم أنقل منها إلا ما وافق الحق، وتركت ما خالفه، كما ينقل العلماء عن بعض أهل البدع ما وافقوا فيه الحق، ويتركون ما خالفه.
على أني أجزم أن بعض ما فيها مدسوس عليه رحمه الله.
الوقفة الرابعة: استنكر المؤلفان عليّ ذكري لحديث جابر رضي الله عنه في وصف موسى عليه السلام وتقريبه لكلام ربنا تعالى بأشد ما يكون من الصواعق، واكتفائي بعد تخريج الحديث من مصادره بقولي: (وفيه الفضل بن يزيد الرقاشي، قال عنه ابن كثير: ضعيف بمرة).
فقالا: (فليتأمل المنصف منهج هذا الرجل البعيد عن الأمانة العلمية، انظر كيف عزا الخبر إلى تسعة مصادر بُغية التأكيد على حجيته، ولكي لا يُقال: تعمّد تجاهل حال الراوي الذي عليه مدار سقوط الخبر، قال: «قال عنه ابن كثير: ضعيف بمرة» هكذا !!. واكتفى هنا بقول ابن كثير، والسبب أنه يهمه ثبوت الخبر، لكي يُثبت الدعوى المسبقة في الذهن، وهي وصف الله تعالى بما جاء في هذا الخبر الواهي، بيد أنه في الجانب الآخر هناك، كردّه لرواية حبيب عن مالك فأنت تراه يبالغ في نقل الأقوال في جرحه …). ثم أخذا يسردان كلام الحفاظ في تضعيف الراوي.
وهذا الكلام غريب عجيب إذ أن الحكم على الراوي وتلخيص حاله بأنه «ضعيف بمرة» مغنٍ عن الاستطراد في ذكر كلام المجرّحين كما فعلا هما في المقال، لأن وصف الراوي بأنه «ضعيفٌ بمرة» يعني الضعف الشديد بحيث لا يُعتبر به ولا بحديثه، فهي ترداف قول النقاد في الراوي «متروك»، و«ضعيف جداً»، و«تالف»، و«واهٍ» ونحو ذلك من عبارات الجرح الشديد.
وأعجب منه ظنهما أن غرضي من الاكتفاء بهذه العبارة هو تقوية الحديث، فقالا: (هذا بعض ما قيل في الرجل، ولكن الكاتب لم يتعرض لذكر أي شيء من هذا ولو من بعيد، واقتصر على قول ابن كثير، لأن المقام مقام استشهاد بالنص المطلوب وهو بحاجة إليه!!).
لكن العذر لهما أن بضاعتهما في الحديث مزجاة، وأنّى للأشاعرة الخُلَّص العناية بالحديث رواية ودراية، والبحث والتنقيب في أحوال الطرق والروايات والرواة، إذ أنّ مُستند العقيدة في أسماء الله وصفاته عندهم هو العقل لا النقل، وإنما يُذكر النقل شاهداً للعقل لا أصلاً، وهذا ما أكداه حيث أخليا كتابهما عن الأدلة النقلية والآثار السلفية، وما نقلاه منها اكتفيا بالعزو فيه إلى غير مصادره الأصلية، وبلا تحقق من ثبوته ولا تمحيص، كما أوضحته في الفصل المتعلق بالجواب عما احتجا به في إثبات ورود التأويل عن السلف.
الوقفة الخامسة: استنكر المؤلفان عليّ استشهادي برواية حديث الصواعق آنف الذكر وقبول الإمام أحمد له على إثبات الصوت لله تعالى، فقالا: (ولنا أن نسأل: هل يحق للإمام أحمد أن يُثبت حكماً فقهياً –فضلاً عن أن يكون صفة لله تعالى- لا دليل عليه؟. وعند التحقيق في كلامه هذا نخرج بقاعدة لو سمعها الإمام أحمد ذاته لمات خوفاً من الله تعالى وهي: أن صفات الله تعالى تثبت بقول الله تعالى، أو بقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بقول أحمد !!).
سبحان الله، ما هذا التغافل والتجنّي، فإن من يقرأ كلامهما هذا يظن أن دليلي على إثبات الصوت لله تعالى هو قول أحمد فقط، كيف وقد سقت الأدلة من الكتاب والسنَّة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة في إثبات الصوت لله تعالى، وما قول أحمد إلا عود من حزمة.
ثم إن هذا الكلام متناقض أيضاً، كيف يُثبتان هذا الورع العظيم عن الإمام أحمد، ثم يظنان أنه مع ذلك قد يتكلم في إثبات صفة لله تعالى غير ثابتة، ولم يأت بها دليل! فحقيقة ما وصفا به الإمام أحمد هو تقويةٌ لما ذكرته وتأييدٌ له، فيكون لي لا عليّ.
والإمام أحمد يُلقّب بإمام أهل السنَّة بلا منازعة، ولا يزال أهل السنَّة في وقته وبعد وقته ينتسبون إليه، ويرجعون إلى أقواله لمّا صارا علماً على السنَّة والاتباع، ومن هؤلاء أبو الحسن الأشعري في مقدمة كتابه الإبانة حيث قال: (قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز و جل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل – نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته – قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق، ودفع به الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم، وجليل معظم، وكبير مفهم) ا.ه [الإبانة (ص21)]
وقال الطبري: (وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى، ولا تابعي قضى، إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى، أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل) ا.ه [صريح السنَّة (ص25)]
وعجيب أمر هذين، كيف لا يُثبتان عقيدة نص عليها الإمام أحمد إمام أهل السنَّة ودلت عليها نصوص الكتاب والسنَّة وآثار السلف، وفي الوقت نفسه يُثبتان عقيدة بكلام الجويني والإيجي والغزالي والآمدي ونحوهم من المتأخرين الحيارى، قد دلت نصوص الكتاب والسنَّة والإجماع على بطلانها. فلا للكتاب والسنَّة اتبعا ولا بالصحابة والأئمة اقتديا، ولا لإمامهما الذي ينتسبان إليه اقتفيا، إذ أن نصوص أبي الحسن الأشعري صريحة في إبطال عقائدهما.
الوقفة السادسة: استنكر المؤلفان عليَّ ردّي لما رواه حبيب كاتب الإمام مالك عنه مما يخالف المحفوظ عنه وعن أئمة السلف، ونقلي لكلام أئمة الجرح والتعديل في تكذيبه، حتى قال أبو داود: «كان من أكذب الناس»، وفي الوقت نفسه أروي بعض أقوال أبي حنيفة من طريق نوح الجامع وهو مُتّهم بالكذب أيضاً، وعدّا هذا تناقضاً. فقالا: (فهو في الوقت الذي ينتفخ فيه بالتظاهر بالعلم والإحاطة بالرجال فينبري ينقل لنا في حبيب كاتب مالك ومحمد بن علي الجبلي وجامع بن سوادة أقوال أئمة الجرح والتعديل فيهم، يغفل عن رجال أثبت عن طريقهم أقوالاً للسلف وعلماء الأمة، مثل نوح الجامع وأبي طالب العشاري وابن كادش).
وأقول: لما لم يكونا من أهل الفنّ، ولا تمييز عندهما بين الرواة وبين المرويات، ولا خبرة لهما بالشواهد والمتابعات، وما ثبت أصله وما لم يثبت، وما احتفت به القرائن وما لم تحتف، أخذا يتهكمان بمثل هذا الكلام.
ففرق كبير بين رواية حبيب عن مالك، وبين رواية نوح الجامع عن أبي حنيفة، فإن ما نقلته عن أبي حنيفة من رواية نوح الجامع إنما كان في إبطال أقوال أهل الكلام وبيان بطلان طريقتهم، ولم يكن في إثبات ما يخالف الكتاب والسنَّة، أو يخالف الثابت عن أبي حنيفة، فقال نوح الجامع: (قلت لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة)، فهل في هذا النقل ما يقدح في العقيدة أو يخالف الثابت عن السلف والأئمة. فأين هذا الأثر مما رواه حبيب عن الإمام مالك من أنه تأوَّل نزول الله تعالى بتنزّل أمره؟
ثم يُقال لهذين: أين نوح الجامع من حبيب كاتب مالك؟، شتان بين الرجلين في روايتهما ومرويهما، فالفروق بينهما كبيرة، أذكر بعضها على عجالة:
1- نوح الجامع فقيه واسع الاطلاع ولذا سُمي بالجامع كما ذكر ذلك العباس بن مصعب المروزي، وله اختصاص بأبي حنيفة، ولذلك يروي جمع من الحفاظ أقوال أبي حنيفة من روايته، فقد نقل عنه البيهقي عن أبي حنيفة في «الأسماء والصفات» وفي «الاعتقاد»، كما نقل عنه الذهبي أيضاً في كتابه «العرش» في موضعين، وغيرهما. بينما حبيبٌ لا يُعرف بفقه ولا بعلم.
2- نوح الجامع إنما نُقم عليه بعض حديثه، بينما مُدح في ذبه عن السنَّة وشدته على الجهمية. قال الإمام أحمد: (كان أبو عصمة شديداً على الجهمية والردِّ عليهم، ومنه تعلم نعيم بن حماد الردّ على الجهمية). [العلل ومعرفة الرجال (3/437)]، وليس لحبيب شيء من هذا.
3- لم يُؤثر عن نوح كذبٌ على أبي حنيفة، بينما كان حبيب يكذب على الإمام مالك ويُدخل في حديثه، كما ذكر ذلك النقاد. [انظر ترجمته في التهذيب]
4- نوح الجامع مُدح في سعة اطلاعه، بينما لم يُمدح حبيب قط.
5- ما نقله نوح عن أبي حنيفة لا يتعلق بمسألة من مسائل الصفات، بينما الذي نقله حبيب عن مالك يتعلّق بصلب العقيدة ويخالف الكتاب والسنَّة ويخالف الثابت عن الإمام مالك.
6- نوح الجامع اتُّهم بالكذب في الحديث دون أقوال الرجال، وفي فضائل سور القرآن بالخصوص، وليس اتهامه بالكذب محل اتفاق، فإن عامة علماء الجرح والتعديل ضعفوه من غير اتهام له بالكذب، منهم: ابن المبارك والإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، بينما اتهام حبيب بالكذب أشبه ما يكون بالاتفاق سواءٌ في الحديث أو عن الإمام مالك.
وإن أردت أن تعرف الفرق بين الرجلين فوازن بين حكم ابن عدي عليهما، وهو المعروف بسبره لأحاديث الرواة:
قال ابن عدي عن نوح الجامع بعدما روى له عدة أحاديث: (ولأبى عصمة غير ما ذكرت، وعامته لا يتابع عليه، …، وهو مع ضعفه يُكتب حديثه) ا.ه [الكامل (7/43)]
بينما قال عن حبيب: (أحاديثه كلها موضوعة، عن مالك وغيره، – ثم ذكر له عدة أحاديث، ثم قال: و هذه الأحاديث مع غيرها مما روى حبيب عن هشام بن سعد كلها موضوعة، و عامة حديث حبيب موضوع المتن مقلوب الإسناد، ولا يحتشم حبيب في وضع الحديث على الثقات، وأمره بيّن في الكذب، وإنما ذكرت طرفاً منه ليُستدل به على ما سواه) ا.ه. [المرجع السابق (2/414)]
الوقفة السابعة: قال المؤلفان في نفي المسيس عن الله تعالى: (من اعتقد بأن الله يجوز أن يَمس أو يُمس فقد جهل ربه، وجعل الله تعالى جسماً يجوز عليه ما يجوز على الأجسام).
فلننظر مَنْ هؤلاء الموصوفون بالجهل بالله في كلام المؤلِّفَيْن ممن أثبتوا المسيس لله تعالى؟.
فمن التابعين: عبيد بن عمير، وحكيم بن جابر، وخالد بن معدان، وعكرمة مولى ابن عباس، كل هؤلاء جاهلون بربهم حيث وصفوا الله تعالى بالمسيس.
بل يكون كل من روى عنهم هذه الروايات من غير نكير جاهلاً بربه، فيكون ابن أبي شيبة، وهناد بن السري، والدارمي، وابن سعد، وعبد الله بن أحمد، والخلال، والآجري، واللالكائي، والذهبي، وغيرهم كثير، كلهم جهلة بربهم لأنهم رووا روايات المسيس عن التابعين مقرين لها.
بل يكون أئمة الأشاعرة أنفسهم جاهلين بربهم لأن كثيراً منهم أثبت المسيس لله تعالى.
قال الرازي في «نهاية العقول»: (قوله: هذا الدليل يقتضي صحة تعلق إدراك اللمس بالله، قلنا: إن أصحابنا التزموا ذلك، ولا طريق إلا ذلك) ا.ه. [نهاية العقول ورقة 173أ، وقد نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في تلبيس الجهمية (8/37)]
وقال في موضع آخر: (ثم لئن سلمنا أن هذا الكلام يدل على كون الباري تعالى سميعاً بصيراً، لكنه يقتضي اتصافه تعالى بإدراك الشم والذوق واللمس، وللأصحاب فيه اضطراب، وقياس قولهم يوجب القول بإثباته على ما هو مذهب القاضي –أي الباقلاني- وإمام الحرمين) ا.ه. [ المرجع السابق / ورقة 157أ، ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في تلبيس الجهمية (8/37)]
وقال أيضاً: (الفصل الخامس عشر: في أنه تعالى هل هو موصوفٌ بإدراك الشم والذوق واللمس؟ أثبت القاضي والإمام هذه الإدراكات الثلاثة لله تعالى) ا.ه. [المرجع السابق/ ورقة 166ب، ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في تلبيس الجهمية (8/37)]
فلا ندري من هو الجاهل بربه، أهو المُثبت لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنَّة وأقوال السلف والأئمة، أم الحيارى المقدّمون لعقولهم على الوحيين وما جاء عن السلف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلا جرم جاءت الأحاديث الصحيحة بثبوت المماسة، كما دل على ذلك القرآن، وقاله أئمة السلف، وهو نظير الرؤية) ا.ه. [بيان تلبيس الجهمية (4/343)]
الوقفة الثامنة: لما أُورِد على المؤلِّفَيْن ما ذكرته من أنهما عجزا أن ينقلا حرفاً واحداً عن السلف في أنّ المراد بالصفات أو بعضها المجاز لا الحقيقة، أجابا جواباً ظهر به عجزهما وجهلهما ومكابرتهما للبدهيات والمسلمات، حيث قالا: (ومطالبتنا بمثل هذا النقل عنهم تحكّم وتعسّفٌ وحيدة عن الحق، وكما أنه لم يُنقل عنهم رضي الله عنهم أنها مجاز، لم يُنقل عنهم أنها حقيقة، وإلا فليأت صاحب الكتاب بنقلٍ عن الصحابة أو التابعين أو تابعيهم بما يفيد على حقيقتها وظاهرها اللغوي).
فاعجب أيها القارئ من هذه المكابرة بعد الإقرار بالعجز، وبيان ذلك من وجوه:
الأول: إن مدَّعي الحقيقة باقٍ على الأصل -وهو أن الأصل في الكلام الحقيقة- فلا يحتاج إلى دليل ونص، وأما من يدَّعي خلاف الأصل فهو الذي يُطالب بالدليل والبينة، وهذا من المسلمات والبدهيات، ومع ذلك فقد كابرا فيه.
لكن انظر أيها القارئ كيف عكسا الأمر فجعلا المجاز هو الأصل، والحقيقة خلاف الأصل فقالا: (إن من يَسيرُ على الأصل لا يُطالب بالدليل، من جار عن القصد وترك الأصل طولب بالدليل، والأصل في كلام العرب وأسلوب التخاطب والتفاهم العربي أن منه حقيقة ومجازاً، والمجاز فيه كثير، والقرآن والسنَّة داخلان ضمن الكلام العربي، فهما زاخران بالمجاز والتشبيهات).
وحكاية هذا الكلام كاف في إبطاله.
إذ صار الأصل في أسماء الله وصفاته عندهما هو المجاز لأنهما لا يثبتان من صفات الله تعالى على الحقيقة إلا سبع صفات فقط، فأصبحت الحقيقة عندهما خلاف الأصل؟!!
هذا من أبطل الباطل في كلام الناس وصفاتهم، فكيف بصفات الله تعالى الذي لم تُحط به العقول ولا تُدركه الأوهام والظنون.
ولو جاز لكل أحد أن يحمل أيّ كلام على ما شاء من حقيقة أو مجاز من غير قرينة لما ثبت شيء من العبارات، ولتعذّرت أساليب التفاهم والتخاطب.
قال ابن عبد البر: (ومن حقِّ الكلام أن يُحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أُنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، وإنما يُوجّه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مُدّعٍ ما ثبت شيء من العبارات، وجلَّ الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين، والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه) ا.ه. [لتمهيد (7/131)]
وقال إمامهما أبو الحسن الأشعري: (حكم كلام الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا بحجة) ا.ه. [الإبانة للأشعري (ص140)]
الثاني: أني قد نقلت نصوصاً كثيرة جداً عن السلف في التنصيص على أن الأصل في الصفات الحمل على الحقيقة والظاهر، وتحريم حملها على المجاز.
فلا أدري هل قرءا كتاب الردّ أم لا؟ إذ هما بين أمرين: إما أنهما لم يقرءا كتاب الردّ وهذه مصيبة، إذ كيف ينكران ما جاء في كتاب لم يقرءاه ويطلعا عليه. وإما أنهما قرءاه فيكونان قد وقعا في الكذب والبهتان، إذ أني نقلت عن جمع من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم من الأئمة قرناً بعد قرن في إثبات أن الصفات على الحقيقة نصاً أو ظاهراً، وذكرت من نقل الإجماع على ذلك كابن عبد البر وغيره.
قال ابن عبد البر: (أهل السنَّة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنَّة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز) ا.ه.
وقال الكلاباذي: (أجمعوا على أن لله صفات على الحقيقة هو موصوف بها: من العلم، والقدرة، والقوة، والعز، والحلم، والحكمة، والكبرياء، والجبروت، والقدم، والحياة، والإرادة، والمشيئة، والكلام. …. وأن له سمعاً وبصراً، ووجهاً، ويداً على الحقيقة ..) ا.ه.
وجاء في الاعتقاد القادري الذي اجتمع عليه العلماء في عهد الخليفة القادر بالله وأُخذت توقيعات العلماء عليه: (لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه، وكل صفة وصف بها نفسه، أو وصفه بها نبيه، فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز) ا.ه.
وقال الخطابي: (فان مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها) ا.ه. ومثله ما جاء عن الخطيب البغدادي.
هذه بعض النصوص المبثوثة في ثنايا الكتاب في حكاية الإجماع على أن صفات الله تعالى محمولة على الحقيقة لا على المجاز، وأما آحاد النصوص فتجدها في مواضعها من الكتاب.
الوقفة التاسعة: أورد المؤلفان في مقالهما أمثلة على إثبات المجاز في القرآن مستدلين بها على جواز المجاز في صفات الله تعالى.
وهذا لعمر الله ضربٌ من التشبيه، وهو الأمر الذي يفزعان منه حتى بلغ بهما إلى التعطيل، فإن مقتضى كلامهما أن كل ما جاز في صفات المخلوق المرئي الذي تُدرك حقيقة صفاته من المجازات، جاز في حق الله تعالى الذي ليس كمثله شيء، ولا تحيط به الظنون والأوهام!!
ومع هذا فإن ما استدلا به من الآيات هي حقائق لا مجازات، وإليك بيانها:
– قالا: (كقوله تعالى (واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) [الإسراء:24] وقوله تعالى (واشتعل الرأس شيبا) [مريم:4]، فهذه ونحوها ليست على حقيقتها، فليس ثمة جناح ولا اشتعال حقيقيان).
والحقيقة أن هذا الكلام ناشئ من الجهل باللغة العربية، فإن الجناح المذكور في الآية هو الجانب، لأن الجنوح هو الميل، ومنه سُمّي جناح الطائر جناحاً لأنه مائل إلى شقه، لا أن الأصل في الجناح هو جناح الطائر كما زعما.
قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: ((جَنَحَ) الجيم والنون والحاء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على المَيْلِ والعُدْوان. ويقال جنح إلى كذا، أي مالَ إليه. وسمِّي الجَناحانِ جَناحَيْنِ لميلهما في الشِّقَّين) ا.ه. [1/431]
ومثله الاشتعال، فإن الأصل فيه هو الانتشار والتفرّق في الشيء، ومنه سُمّي انتشار النار اشتعالاً، ولا تعرف العرب قط اشتعال الرأس إلا انتشار الشيب.
قال ابن فارس: ((شَعَل) الشين والعين واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على انتشارٍ وتفرُّق في الشيء الواحد من جوانبه. يقال أشعلْتُ النّار في الحطب، واشتعلت النّارُ. واشتعل الشّيب. قال الله تباركَ وتعالى: {وَاشْتَعَلَ الرَّأسُ شَيْباً}) ا.ه. [3/147]
– واستدلا بقوله تعالى (فأتى الله بنيانهم من القواعد) [النحل:26].
فظنا أن ظاهر الآية يُراد به إتيان الله بنفسه ثم ادعوا فيه المجاز، وليس الأمر كذلك، فإن الإتيان هنا هو الهلاك وإتيان العذاب من الله، كما يُقال (أُتِي فلان) إذا هلك، ومثله قوله تعالى (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) [الحشر:2].
قال الزبيدي في تاج العروس: (وأُتِيَ على يد فلان: إذا هَلَك له مال …. وقوله تعالى: {فأَتَى اللَّهُ بُنْيانَهم مِن القَواعِدِ}، أَي قلع بنيانهم من قواعده وأساسه فهدمه عليهم حتى أَهلكهم. وقال السَّمين نقلاً عن ابن الأَنباري في تفسير هذه الآية: فأتى اللَّهُ مَكْرَهُم مِن أَجْله، أَي عاد ضرر المكر عليهم، وهل هذا مجازٌ أَو حقيقةٌ؛ والمراد به نمرود، أَو صَرْحه خلافٌ، قال: ويُعبَّرُ بالإتيان عن الهلاك، كقوله تعالى: {فأَتاهُمُ اللَّهُ من حيثُ لم يَحْتَسِبُوا} . ويقالُ : أَتى فلان من مَأْمَنِه : أَي جاءَهُ الهلاك مِن جهَةِ أَمْنه) ا.ه. [مادة أتى]
ففرقٌ بين قوله تعالى (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام) [البقرة:210]، وقوله (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك) [الأنعام:158]. وبين قوله تعالى (فأتى الله بنيانهم من القواعد) [النحل:26]، وقوله (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) [الحشر:2].
ففي الآيتين الأوليين ذَكَر الله إتيانه مطلقاً غير مقيّد، بينما في الآيتين الأخيرتين قيّد إتيانه؛ ففي الأولى (من القواعد) وفي الثانية (من حيث لم يحتسبوا).
ثم يُقال أيضاً: هب أن هذه الآية يدل ظاهرها على إتيان الله تعالى، فقد دلت القرائن على أن المراد بها غير الظاهر، وهو الاتفاق من الموافق والمخالف على أن الله تعالى لا يأتي قبل يوم القيامة.
قال الدارمي: (فلما لم يشك المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا علموا يقيناً أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو أمره وعذابه، فقوله:(فأتى الله بنيانهم من القواعد) يعنى مكره من قِبَل قواعد بنيانهم، (فخر عليهم السقف من فوقهم)، فتفسير هذا الإتيان خرور السقف من فوقهم، وقوله: (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) مَكَر بهم فقذف في قلوبهم الرعب، (يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) وهم بنو قريظة، فتفسير الإتيان مقرون بهما خرور السقف والرعب، وتفسير إتيان الله يوم القيامة منصوص في الكتاب مفسر) ا.ه. [الرد على المريسي (1/341)]
الوقفة العاشرة: لقد طعن المؤلفان وللأسف في بعض الأئمة المشهود لهم بالعلم والفضل، والسبب أنهم أنكروا على الأشاعرة وبدّعوهم، فقالا: (لعل هذا القائل يريدنا أن نستدل بكلام البربهاري والسجزي والهروي صاحب ذم الكلام وابن تيمية وابن القيم!!).
وهذا كلام ساقط، فإن هؤلاء المذكورين من أئمة العلم وأساطينه، والطعن فيهم جزافاً أمرٌ خطير.
فمن ذا الذي طعن في عقائد هؤلاء وحطّ من قدرهم ممن لم يُنقم عليه بعقيدة مخالفة كالأشاعرة؟
فهلا أشارا إلى إمام غير مطعون في عقيدته، ومتفق على إمامته في أبواب العقائد على الخصوص طعن في البربهاري أو السجزي أو أبي إسماعيل الهروي الأنصاري، فهذه كتب ابن عبد البر والذهبي وابن كثير وغيرهم من الأئمة المشهود لهم، ما طَعنَ أحدٌ منهم في عقائد هؤلاء، وإنما يطعن فيهم من خالف عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته وانتحل البدع والمحدثات.
وإذا كان هؤلاء مطعوناً فيهم منقوماً عليهم لكونهم أثبتوا حقائق الصفات لله تعالى، فالسلف كلهم على هذه العقيدة التي عجز المؤلفان أن ينقلا حرفاً واحداً يدل على خلافها، في مقابل مئات النصوص الدالة على ضد ما ذكرا.
وإما إذا كان الطعن فيهم بسبب حطّهم على الأشاعرة، فقد أفضت في نقل نصوص الأئمة في تبديع الكلابية والأشاعرة في الباب الخامس من هذا الكتاب، منهم: الإمام أحمد، وأبو حاتم الرازي، وأبو العباس بن سريج الشافعي، وابن خزيمة، ومحمد بن إسحاق السرّاج، وابن عبد البر وغيرهم كثير من الأئمة المتقدمين والمتأخرين من أئمة المذاهب. وجمعٌ لا يُحصون كثرة من طبقة الإمام أحمد ذكرهم أبو القاسم الأصبهاني بأسمائهم.
فهل نُسقط هؤلاء أيضاً ونُلحقهم بمن سمّيا ؟!!
الوقفة الحادية عشرة: لقد أكّد المؤلفان ما بيّنته في كتابي من اتفاق الأشاعرة والمعتزلة على أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، فقد صرّحا بذلك حيث قالا: (وإذا كان المراد به –أي القرآن- ما يُعبّر به ويدلّ على المعنى القائم بذات الله تعالى، كالحرف والصوت والرسوم والرقوم والجلد والمداد، فهذا لا خلاف في كونه مخلوقاً. على أنه لا يجوز إطلاق القول: بأن القرآن مخلوق. أولاً: لبشاعة اللفظ الدالة على الجرأة على الله تعالى. وثانياً: لخشية الإيهام والالتباس الذي قد يقع في ذهن من لم يُحط خُبراً بحقيقة المسألة).
وقولهم هذا هو عين قول المعتزلة في القرآن الموجود بين أيدينا؛ المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور، والمقروء في المساجد والمحاريب.
وهذا القول في حقيقته تكذيب لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما أجمع عليه السلف من أن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله تعالى حروفه ومعانيه.
والآيات الدالة على بطلان قولهما كثيرة جداً، فمنها قوله تعالى: (وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ) [الأنعام:19]، (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله) [يونس:73]، (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) [الإسراء:9] في آيات كثيرة أشار الله تعالى إلى القرآن باسم الإشارة.
و(هذا) اسم إشارة إلى القرآن الموجود بين أيدي الصحابة المحفوظ في صدروهم المسموع بآذانهم، لا إشارة إلى ما في نفس الله تعالى مما لا يُسمع وليس بحرف ولا صوت.
وقد تحدى الله المشركين بعجزهم عن الإتيان بمثله لأنه كلام الله الذي ليس كمثله شيء. فقال تعالى: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) [الإسراء:88]. والإشارة هنا إلى القرآن الموجود بين أيدينا.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُمس القرآن إلا على طهارة لأنه كلام الله فقال «لا يمس القرآن إلا طاهر». كما نهى أن يُسافر به إلى أرض العدو خشية أن تناله أيدي الكفار، كل ذلك لكونه كلام الله تعالى ليس عبارة عنه ولا حكاية.
وقد أجمع السلف على أن القرآن الذي بين أيدينا كلام الله غير مخلوق، وعلى إكفار من قال بخلقه، وليس مرادهم بالقرآن كما يزعم المؤلِّفان ما في نفس الله تعالى قطعاً.
قال الطبري في بيان عقيدة السلف في القرآن: (إنه كلام الله غير مخلوق، كيف كُتب، وحيث تُلي، وفي أي موضع قُرئ، في السماء وُجد، وفي الأرض حيث حُفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوباً، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوماً، في حجر نُقش، أو في ورق خُط، أو في القلب حُفظ، وبلسان لُفظ، فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآناً في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائناً به فهو بالله كافر حلال الدم بريء من الله، والله منه بريء بقول الله عز وجل (بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) [البروج:23]، وقوله الحق عز وجل: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) [التوبة:6] فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد مسموع وهو قرآن واحد؛ من محمد مسموع، وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشباب متلو) ا.ه. [صريح السنة ص17]
ومن لم يُفرّق بين كلام الله تعالى المكتوب في المصاحف، وبين الحبر والمداد والورق فهو أضل من حمار أهله!.
ثم إن هذا القول متناقض، فكيف يزعمان أن كلام الله تعالى هو ما قام بنفسه، وهو معنىً لا يُسمع، وليس بحرف ولا صوت، ثم مع هذا يُسميانه قرآناً، وهل القرآن إلا مصدرٌ من قرأ نحو كُفران ورُجحان، فالقرآن مصدرٌ كالقراءة، ولا يكون قرآناً إلا مقروءاً، ولا يكون مقروءاً إلا مكتوباً مركباً من الحروف.
والقراءة في أصلها الجمع والضم للحروف، وهو أصل كلمة “قرأ”.
قال الراغب الأصفهاني: (والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، …، ويدل على ذلك أنه لا يُقال للحرف الواحد إذا تفوه به قراءة). [مفردات القرآن ص402]
وعلى هذا فلا يصح أن يوصف المعنى بالقراءة، وإنما يُقال “فهمت المعنى”، ولا يُقال “قرأت المعنى”.
وهذا ظاهرٌ في بيان تناقض الأشاعرة، وإنما الذي قادهم إلى ذلك إرادة الجمع بين معتقدهم في كلام الله وأنه ليس بحرف ولا صوت، وبين ما جاء من إطباق السلف في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فولّدوا هذا القول المتناقض فسمّوا كلام الله قرآناً مع زعمهم بأنه معنىً، ليس بحرفٍ ولا صوت، ولا يُسمع، ولا يُقرأ، ولا يُكتب، وإنما يُعبّر عنه.
هذه بعض الوقفات السريعة على بعض ما جاء في مقال المؤلِّفَيْن والحوار الذي أجرياه من غير استيعاب لأخطائهما.
وستخرج قريباً الطبعة الثانية من كتاب «الأشاعرة في ميزان أهل السنّة» والتي تميزت عن سابقتها بتصويب الأخطاء المطبعية وغيرها، كما تم إعادة صياغة بعض العبارات لتكون أدلّ على المراد، ولم يتم إضافة شيء يُذكر سوى نقولاتٍ يسيرة عن بعض السلف، وزيادة بعض أوجه الردّ على بعض شبهات المؤلِّفَيْن.
والله نسأل أن يُريَنا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويُريَنا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبساً علينا فَنَضِل.